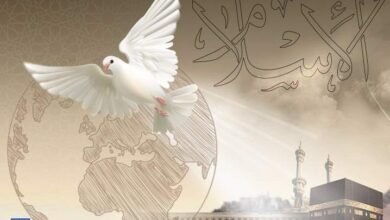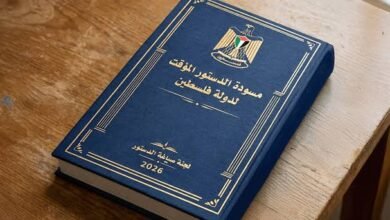كانت القرية مدرستي الأولى، هناك تعلّمت أن الحلم يكبر رغم ضيق المكان، وأن ضوء السراج الخافت يكفي ليضيء طريقًا طويلًا من الطموح.
كل حكاية تبدأ من مكان ما، وحكايتي بدأت مع صديقي عبد الملك عبدالله قاسم القاضي. كان شابًا هادئًا، طيب الخلق، ذكيًّا، يشبه كتابًا ممتعًا؛ كلما جلست إليه ازددت شغفًا بصفحات حياته، فلا تملّ صحبته أبدًا.
بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، أنتقلنا معًا إلى مدرسة صلاح الدين في الحُصين لنكمل المرحلة الثانوية، وكنا نذاكر في بيت لم يكتمل بناؤه عند مدخل قريته “رُبع”، القريبة من قريتي “كِندة” في مخلاف شرعب شمال تعز.
هناك، بين الجدران الناقصة والسماء المفتوحة، كانت أحلامنا تكبر. نتخيل أنه بعد الثانوية سنسافر إلى المدينة للعمل والالتحاق بالجامعة، وندرس الأدب الإنجليزي، نحلم بغدٍ مختلف، مليء بالفرص والطموحات.
من بعد الظهر وحتى قبيل المغرب، لم نكن نفعل شيئًا سوى المذاكرة والنقاش والحلم بالمستقبل. ثم أودّعه وأعود إلى قريتي، وما إن أصل حتى أتوجه إلى بيت جدتي مَحصنة رحمة الله الواسعة تغشاها، هي من كفلتني منذ وفاة أمي وأنا طفل لم يتجاوز الثانية. هناك أجد الدفء، وأجد العشاء الذي كان غالبًا حقين مع “كدر” خبز بلدي.
كانت جدتي مَحصنة، أنظف نساء القرية، وأبرعهن في إعداد الكدر. وبعد العشاء، نجلس في “الدارة” فناء بيوتنا القديمة نستمع إلى قصص الجدات، وحين يتسلل إليّ النعاس، أدخل غرفتي الصغيرة الملاصقة لبيتنا، وأنام حتى صلاة الفجر.
وبعد الصلاة، أذاكر دروسي على ضوء السراج، الذي كان عبارة عن علبة “سم البريك” فارغة أملؤها بالصليط، وأفتل قطعة قماش على شكل فتيلة، ثم أدخلها في الفتحة وأشعلها.
كان السراج يبعث ضوءًا ضعيفًا بالكاد يُظهر السطور أمامي، لكنه في المقابل ينفث دخانًا كثيفًا يملأ الغرفة، يخنق أنفاسي ويؤلم عينيّ. ومع ذلك، كنت أتحمله وأواصل القراءة حتى طلوع النهار.
في تلك الفترة، جاء المرض ليغير مسار حياتنا. أصيب والدي بمرض السرطان، ونُقل إلى مدينة تعز للعلاج، لكن حالته ساءت، ولم يعد منها إلا جثة هامدة.
ما زلتُ أتذكّر صباح السبت كأنّه الآن.
خرجتُ من البيت مبكرًا لأداء الامتحان النهائي للصفّ الأوّل الثانوي، وقلبي يعتصر خوفًا على أبي.
كنتُ قد زرته قبلها بيومين، فوجدته منهارًا، ينظر إليّ والدموع تنهمر من عينيه، وكأنّه كان يشعر أنّها النظرات الأخيرة.
ودّعته وأنا أبكي، وقلبي يقطر دمًا عليه.
وحين وصلتُ إلى مدخل القرية، قرب المقبرة، كانت سيارة الصالون قد توقّفت هناك، والناس تجمّعوا حولها.
تقدّمتُ بخطواتٍ مترددة، حتى سمعت أحدهم يقول:
سعيد عبده مات.. الله يرحمه.
لم أتمالك نفسي، انفجرت بالبكاء، ولم أستطع حتى أن ألقي نظرة أخيرة على وجه أبي. تماسكت قليلًا، ثم واصلت طريقي نحو المدرسة. ركبت سيارة “شاص” متجهة إلى سوق الحُصين، سألني أحد الركاب:
من الذي مات؟
كنت أبكي بصمت ولا أقوى على الكلام.
وصلت السوق وجلست بجانب أحد المحلات أذرف دموعي. لمحني أستاذي المصري “أشرف” كان متدينًا و طيب القلب. اقترب مني بلطف وسألني:
ما بك؟
أجبته وأنا أرتجف:
أبي مات.
أمسك بيدي وأخذني معه إلى سكنه القريب من المدرسة، وحاول أن يهدئ من روعي. جلس إلى جانبي، ومسك على يدي و قال:
“لازم تتماسك وتثبت؛ هذه سُنَّة الحياة، كلنا سنرحل. رحم الله أباك.
قدّم لي الفطور، أكلت معه، ثم أخذني إلى المدرسة. بينما كان الناس في القرية مشغولين بالدفن، كانوا يتساءلون: أين محمد؟ ظنّوا أني هربت، أرسلوا بعض شباب القرية يبحثون عني حتى وجدوني في قاعة الامتحان.
رحم الله أبي رحمةً واسعة؛ لقد ترك فراغًا كبيرًا في حياتنا. كان حنونًا، ولم أتذكر يومًا أنه ضربني أو نهرني، بل كان دائمًا يشجعني ويحثّني على الدراسة.
أتذكّر أني، وأنا طفل، كنت أحدّق في وجهه وأتأمل تفاصيله، وأهمس في داخلي: إذا مات أبي، كيف سأعيش من دونه؟ ثم أبكي بصمتٍ دون أن يشعر بي.
أمّا أمي، رحمها الله، فقد رحلت مبكرًا وأنا طفلٌ لم أتجاوز الثانية من عمري.
لم أتذكّرها، ولم أعرفها إلا من خلال تلك الصورة التي رسمتها في خيالي لملامح وجهها.
وإلى اليوم، وأنا أعبر منتصف الأربعين، ما زالت تلك الصورة الجميلة لأمي تسكن مخيّلتي كما هي، لم تتغيّر.
في تلك السنة الكئيبة، حصلتُ على الترتيب السادس بين الأوائل.
كنتُ طالبًا مجتهدًا، شغوفًا بالقراءة والاطّلاع، واسع الخيال.
وحين كان الأستاذ يشرح درس التاريخ، كنتُ أتخيّل الأحداث وأرسم في ذهني ملامح الشخصيات، كأنّي أشاهدها على شاشة تلفاز. ساعدني ذلك الخيال كثيرًا على الفهم والاستيعاب.
كنت أحب مادة اللغة الإنجليزية بشغف، ولم أكتفِ بالكتب المدرسية فقط.
كنت أستمع إلى البرنامج التعليمي في إذاعة “بي بي سي”، وأتابع برنامجًا إذاعيًا يقدمه المذيع أحمد عمر بن سلمان على إذاعة عدن، بصوته المميز الذي يجذب الانتباه.
وأحيانًا كنت أستعير بعض القصص من صديقي وائل محمد علي، لأقرأها وأغذي خيالي وأزيد من حصيلتي اللغوية.
كانت عمتي نعائم، حفظها الله ورعاها، تقيم في المملكة العربية السعودية، وكانت ترسل لي في شهر رمضان مبلغًا رمزيًا لشراء ملابس العيد.
في كثير من المرات، كنت أتوجه إلى مدينة تعز، وتحديدًا شارع جمال بالقرب من مكتب التربية والتعليم، حيث توجد مكتبة تبيع كتبًا وقصصًا وروايات باللغة الإنجليزية.
كنت أقتني بعض هذه الكتب وأعود إلى غرفتي الصغيرة، لأجلس هناك وأقرأ لساعات طويلة، مستمتعًا بكل صفحة دون أن أشعر بالملل.
أتذكر أني في إحدى المرات قطعت مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات تحت شمس الظهيرة الحارقة، فقط لألتقي بالدكتور علي سرحان المخلافي في قريته “الشجرة”.
طلبت منه أن يكتب لي موضوعًا عن أهمية اللغة الإنجليزية، وكنت أراقبه وهو يتحدث ويكتب، وأتخيل يومًا ما أن أكون مثله.
بعد ذلك، كنت ألتقيه بين الحين والآخر في سوق الحصين، ملتقى قرأ المخلاف. كنت أتحدث معه بالإنجليزية، وأشعر في كل مرة بالمتعة والفخر.
في إحدى المرات صادفته عند الظهيرة، سلمت عليه، وكان مستعجل. تحدثت معه بالإنجليزية، فرد عليّ وهو يمشي، فتبعتُه. انزعج مني وقال بصوت مرتفع:
Don’t be so meticulous.
سألته: ماذا تعني؟
قال لي: لا تركز في التفاصيل الدقيقة.
قلت له: اكتبها لي على يدي.
ضحك، وكتبها، ثم مضى وهو يضحك.
مع اقتراب موعد امتحانات إكمال المرحلة الثانوية العامة، التي كانت تُعقد آنذاك في مدينة تعز، تواصلنا مع عبدالله فائد، الذي كان حينها في سنته الأخيرة بالجامعة، وطلبنا منه أن يستأجر لنا غرفة نقيم فيها خلال فترة الامتحانات. أخبرنا بأنه سيترك الغرفة التي يسكن فيها لنا.
أسبوعان في مدينة تعز بحاجة إلى مصاريف، وكنت حائرا في كيفية تدبير هذا المبلغ. حينها أخبرت جدتي زهرة رحمها الله بما أمر به، دبّرت لي ألفي ريال لتساعدني على تسيير أموري خلال تلك الفترة.
قبل بدء الامتحانات بيومين، دخلنا مدينة تعز، واستقبلنا عبدالله فائد في فرزة شرعب السلام، وأخذنا معه إلى السكن الذي كان يقيم فيه في عمارة علي مدرة بالمدينة القديمة، قرب “الباب الكبير”.
دخلنا الغرفة في الطابق الثالث؛ كانت صغيرة بمساحة أربعة في ثلاثة أمتار، مظلمة بلا نوافذ، ولا يوجد فيها حمام.
كنا خمسة داخل الغرفة. أخذت معي دافور من القرية كنا نطبخ عليه الطعام، وبعد الأكل كنا نجمع الصحون مع الدافور في شوالة “كيس”، ونربطها في حبل ونعلقها على مسمار مثبت على خشبة في سقف الغرفة.
أذكر أن صديقي عبد المعين عثمان أحمد كان يخرج صباح الجمعة إلى السوق ليشتري قناوص دجاج وأرزًا، ثم يعود قبل الظهر لنجهز الغداء.
نصلي الجمعة ثم نشتري القات ونعود نتغدى ونخزن “نمضع القات” ونواصل المذاكرة.
وعندما نحتاج إلى الحمام، كنا نذهب إلى جامع المظفر القديم، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وكانت الحمامات فيه بلا أبواب.
في أحد الليالي، قبل أذان الفجر، خرجت إلى حمامات جامع المظفر. كانت الأضواء خافتة وباهتة. مددت رجلي لأدخل، دعست على مجنون كان نائمًا في الحمام. خفت، ورجعت مسرعًا إلى السكن.
وأنا أمشي في الحارة، شعرت بشخص يمشي خلفي بسرعة. ازداد خوفي وبدأت أجري، وهو يتبعني. دخلت العمارة، ودخل بعدي أيضًا. فتحت الغرفة وارتميت داخلها، فدخل بعدي وهو يضحك. كان زميلي الذي يسكن معنا.
كنت أذاكر مع أصدقائي حتى الخامسة والنصف عصراً، ثم أخرج إلى سوق الشنيني في المدينة القديمة، ألتقي السياح الأجانب وأتحدث معهم باللغة الإنجليزية، وكنت أستمتع كثيرًا.
عند وقت صلاة المغرب، أصلي ثم أرجع إلى السكن. وفي الصباح كنا نقطع مسافة طويلة مشيًا على الأقدام حتى نصل إلى مركز الامتحانات.
قبل يوم من انتهاء الامتحانات، وتحديدًا قبل صلاة المغرب، كنت في السوق والأجواء ممطرة بشكل خفيف. فجأة، سمعت صوت يناديني. التفت لأجد أصدقائي جاءوا من القرية، وقالوا إنهم يبحثون عني منذ ساعتين.
جلسنا بجانب أحد المحلات، وقالوا لي إنهم أمسكوا بعسيق “ثعلب” في القرية، وهو الآن مربوط على السرير في لوكندا النيل بشارع التحرير.
استغربت وقلت لهم: ما المطلوب مني؟
قالوا: انتشر خبر في القرى عندنا في المخلاف أن العسيق علاج لمرض الاتز، ونريدك أن تبيعه للسياح.سألتهم: هل هذا الخبر أكيد؟
أجابوا: نعم.
ذهبت معهم تحت زخات المطر الخفيف نبحث عن سياح أجانب في السوق. كنت أتكلم معهم وأوضح لهم أن العسيق علاج لمرض الاتز، لكنهم كانوا يستغربون ويضحكون ويرفضون الشراء.
لأكثر من ساعة ونحن نفتش عن السياح وسط زحمة السوق، ونواجه نفس الرد. تعبت وقلت لهم: “غدًا آخر يوم للامتحان.” اعتذرت منهم وعدت إلى السكن.
بعد إتمام الامتحان، عدنا وقت صلاة الظهر فرحين. كان لا يزال متبقي ثمان مئة ريال من الألفين. ذهبنا إلى السوق، ووجدنا محل يبيع ملابس وجزمات بأسعار رخيصة، اشتريت لي بنطلون وجزمة.
ثم عدت إلى السكن، ارتديت البنطال والجزمة، وكان لدي كوت بيج لبسته، ثم ذهبت مع صديقي محمود سعيد البحري إلى الحديقة، والتقطنا صورا للذكريات.
مضت الأيام وانقضت السنوات وتفرقنا، لكن ما بقي في داخلي هو صدى تلك الأيام التي علمتني أن الفقر ليس عائقًا، وأن الحلم والإصرار قادران على منح الحياة معنى.