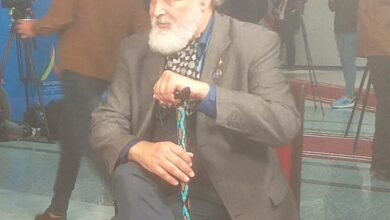رحلات مغربية على منحى رفاعة الطهطاوي
سنقف هنا على عيّنة أخرى من أدب الرحلة بعد أن سبق وقدمنا صورة عن رحلة رفاعة الطهطاوية، بوصفها رحلة نموذجية شكّلت أحياناً مرشداً ومرجعاً لتوصيفات رحلوية لاحقة. وهي بالفعل في العصر الحديث تحتلّ مكانة الرحلة التي قام بها أمثال الشريف الإدريسي أو ابن بطوطة في العصر الوسيط. إنها عمل كلاسيكي بامتياز. هناك إلى جانب ذلك، رحلة قام بها سياسيون وسفراء وأحياناً علماء / سفراء في إطار مهام رسمية. وهو ما ميّز نموذج الرحلة المغربية الحديثة. بعضهم لم يفته أن يقرأ «تلخيص الإبريز في تلخيص باريز». بعضهم رأى أوروبا قبل رفاعة الطهطاوي. فيما رآها آخرون بعده. إن الوقوف على أنماط أخرى من المواقف والتوصيف ضروري هنا. إنه على الأقل يعكس طبيعة الجدل القائم يومها حول مستوى التعاطي مع صدمة التحديث. واستيعاب مستويات التموقف من سياسات أوروبا، وأخلاقها ومن المسألة الثقافية والدينية وباقي مظاهر العمران. هذه الرحلة، تتعلّق برحّالة مغاربة قلّما وجدت عناية حقيقية من قبل الباحث المشرقي الذي يكاد يجهل عنها كل شيء. وهو يضارع عدم عنايته الكافية برسالة الإصلاح وخطاب النهضة في هذه الربوع. ومع ذلك لا يسعنا إلاّ القول: إنهم في جانب من ذلك هم معذورون، ما دام المغاربة أنفسهم لم يعتنوا بتراثهم الوسيط والحديث العناية المطلوبة، رغم المحاولات المعاصرة التي لم تستوعب الجزء الأقل من هذا الإرث الثمين. وهم في جانب من ذلك معذورون أيضاً، لأن المغرب شكّل تجربة فريدة ما كان لها أن تتقاطع مع مجمل السياسة في المشرق نظراً لاستقلال التجربة المغربية عن المشرقية منذ العصر الوسيط. وليس هناك من المشارقة من اعتنى بالأدوار المغربية في العهد العثماني إلا ما نذر. وهذه العناية نفسها ظلّت تعاني من الضعف حتى في المغرب نفسه قبل أن يبدأ شكل -ولو محدود- من الاهتمام بأدب الرحلة وإخراج متونها من سجن المخطوط والحجري إلى عالم الطبع والنشر. قام ببعض هذه الأدوار آحاد ممن ولعوا بالتأريخ السياسي للمغرب الحديث. ويبدو لي أن المهمة لا زالت تقتضي جهداً إضافيًّا حيث لم ينكسر القلم في هذا المضمار بعد. ثم هناك قدر الجغرافيا، حيث ما يقع في الشرق يتعلق بالمركز، وليس للمغارب من ذلك كلّه إلا هذا الهامش الذي تقف عنده. سواء أتعلق الأمر بالشرق أو بالغرب. فهي الهامش من الجهتين قلّ أن ينظر إليها بعين التفرد والاستقلالية والتّمركز. وقدر المغارب أن تكون على هامش هذا الحدث مهما بلغ سلطان تجربتها. وليس لها إن اقتضى الحال وفي أوج قوتها إلاّ التفرد والاستقلال بتجربتها. وهذا ما حدث للمغرب الجوّاني وحده بصورة تدعو إلى فائق الاهتمام. ومن هنا قصدت أن أتوقف عند عينات من هذه الرحلة في سياق التركيز المطلوب على تجربة يكاد لا يعلم بها -بعد لفيف من المستشرقين المتخصصين في تاريخ المغرب الحديث- إلاّ المتخصصون المغاربة. وهم مع ذلك، في هذا الهمّ، قلّة قليلة. وفيها سندرك أن الاهتمام بخطاب النهضة في السنوات الأخيرة في المشرق العربي بات يستهلك نفسه بإسراف. وهو لا زال يعيد عرض المعروض من دون حتى تأويل جديد ولا إضافات معتبرة. وكأن هذا الخطاب اقتصر على خطاب السيد جمال الدين وحوارييه من أمثال محمد عبده والكواكبي وخير الدين التونسي وما شابه من رجالات الإصلاح الكبار. وبتنا لا نقف على مصلح جديد لم تضبطه عدسة التحقيق غير هذا النفر. وفي ذلك تكريس للحصر العلمي والعجز عن إغناء التراث الإصلاحي بنفض الغبار عن مصلحين لم تبلغهم يد العناية وظلوا مجاهيل في نظر مؤرخي حركة الإصلاح الحديثة في العالم العربي والإسلامي. وللأمانة، فإن هذا ليس مُصاب المغارب فحسب، بل هو مُصاب العرب ما عدا مصر والشام. ففي العراق هناك من رواد الإصلاح والنهضة من لا يعلم بهم وبآثارهم عموم العرب وإن برعوا في هذا الخطاب. وكذا في سائر البلاد العربية هناك رواد إصلاح من المحيط إلى الخليج لم يجدوا لهم مكاناً مناسباً في هذا التأريخ الاختزالي لرواد النهضة والإصلاح العربي الكلاسيكي. ومن خلال هذه العيِّنات التي سنقدمها يظهر أن الولع برسالة الإصلاح ظل همًّا مشتركاً عند سائر رجالات المرحلة. وأن المغرب كان أولى بأن تتشكل لديه تجربة خاصة في هذا المجال ما زالت لم تنفض عن تراثها الغبار. إننا نجدنا في مثال الرحلة المغربية أمام نموذج لرحّالة سفاري وسياسي وهو في الغالب شيخ فقيه ابن القرويين، لا يقل رسوخاً في العلم الشرعي عن الشيخ الأزهري. وبعضهم مشهود له بالعلم والفقاهة التي تجاوزت حدود المغرب. فصاحب «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» مما ذاع صيته في الأزهر وغيره من الجامعات الدينية. ما يعني أنه في الرحلة هو أبعد في الفقاهة والخبروية الدينية من رفاعة الطهطاوي نفسه. كما هو في الموقعية السياسية يفوق الطهطاوي ساعة عزم هذا الأخير على الرحلة وهو شابّ في مقتبل العمر. لكن نظرة السياسي هنا قد تكون مختلفة. ودرجة الإحساس بالعزة ومجد الأمة تظل متفاوتة. وهذا يعكس بالتالي طبيعة الموقف والمنظور والتجربة والشرط الموضوعي للدولة التي كان يمثلها هذا الرحّالة أو ذاك. وأحياناً كان الرحالة الأكثر إعجاباً بمظاهر تلك النهضة يذكّر بين الفينة والأخرى بقيمة الهوية ومجد الأمة الضّائع حتى حينما يتعلق الأمر بالطهطاوي والحجوي الثعالبي، من باب التذكير بأنهم لم يقطعوا مع جذور الأمة. وربما كان ذلك من باب الرقابة الذّاتية. لأن الإحساس بالهوية لا يزال كبيراً في الأمة. ولا يملك الرحّالة ألَّا يُقدِّم شهادة بهذا الاهتمام تجاه أمر يتعلق بالهوية والتراث والثقافة المحلية يفوق ويرجح أيّ اهتمام آخر متى غدا التخلّي عن الهوية شرطاً لامتلاك مفاتيح التقدم.
الحداثة بعيون الرّحالة المغربي
ما يميز الرحّالة المغربي عن نظيره أو سلفه الطهطاوي، أن الأول كان محكوماً بجملة من الالتزامات تجاه السلطان والدولة، في حين مثل هذا لم يحصل كله مع الطهطاوي. ومن هنا بات واضحاً أن تشوّق الطهطاوي للحداثة فاق تشوّق هؤلاء الرحّالة المغاربة لها باستثناء الحجوي الثعالبي وإلى حد ما الصفار. إن الرحالة المغربي يعرف ما يطلبه، ألا وهو القوة: أي التحديث. كما أن الطهطاوي عرف المطلوب، ألا وهو النهضة: أي الحداثة. بين التحديث والحداثة سفر فكري آخر في رحاب المطارحات الفكرية التي أعقبت تلك الحقبة وتجلّت بصورة كبيرة في المنتج الأيديولوجي العربي المعاصر. فطلّاب التحديث يسلكون مسلك الانتقاء والتمييز بين نهضة الفكر ومنجز البنى التحتية. وطلّاب الحداثة لا يميّزون بين ذلك البتة. بل يرون أن ثمة علاقة قائمة بين الفكر والواقع.. بين الثقافة والممارسة.. بين الفلسفة والعمران. إن الإغراق في هذا وذاك هو من العويصات التي أرّقت العقل العربي وتاهت به في المتاهات. نعم ثمة ما يجب قوله بهذا الخصوص؛ فالرّحالة المغاربة بمن فيهم أولئك الذين ميّزوا بين الحداثة والتحديث كانوا يدركون أهمية التقدم الذي تشهده الثقافة والسلوك والأخلاق الأوروبية. لكنهم كانوا ينظرون بحذر ولا يسمحون لشيطان الإغراء والانبهار أن يذهب بهم المذاهب وأن يتيه بهم بين السبل. هكذا بدا واضحاً أن المميز للرحلة المغربية قبل رحلة محمد بن عبدالله الصفار ومن عاصره أو جاء بعده -أي المميز لها حتى قبل رحلة الطهطاوي نفسه- أنها أكثر ميلاً إلى سؤال الهوية منها إلى سؤال الترقي. فلو استثنينا رحلة الصفار وكذا الحجوي الثعالبي، سوف نجدنا أمام نمط من الوصف يتمركز حول سؤال الهوية الثقافية والدينية فيه من الاستقباح والاستهجان لعوائد الفرنجة وتقاليدها ما يخفي الاندهاش الجانبي ببعض مظاهر العمران الأوروبي. لا يعني ذلك أن عنصر الإعجاب بمظاهر النهضة الأوروبية لا يوجد في هذا النمط من الأدب الرّحلاتي. لكنه حضور غير مصحوب بالدّهشة، إن لم نقل مغلوب للنظرة الاستعلائية التي تجد تعويضها الكامل في اعتقاد الرحالة بالأفضلية الرمزية لدينه وتاريخه وثقافته. ولكننا وجدنا هذه الخاصية تتراجع مع الصفار كما تكاد تختفي تماماً مع الحجوي الذي شكّلت تجربته غاية الموقف الإيجابي من التحديث والعصرنة تميّز به عن نظرائه في المغرب واقترب به من تجربة الطهطاوي إلى حدّ ما. لكن يبدو أن هاجس الاهتمام بمظاهر الترقي بدا يتكامل شيئاً فشيئاً في تجارب الرحلة المغربية، ما يؤكد أن هذا الاختلاف في طبيعة الموقف يعود إلى طبيعة وظيفة الرحالة وتكوينه وأهدافه. نستطيع التمييز هنا بين أشكال من الرحلات الغالب على أكثرها أنها كانت سفارية، لأصحابها ولاء خاص للسلطان وهم يؤدون وظيفة سلطانية في الديار الأوروبية غالباً ما كانت بعثات دبلوماسية هدفها المشاركة في احتفالات وطنية أو حمل رسائل سلطانية أو التفاوض حول فكاك الأسرى. بعض من هذه الرحلة كما ذكرنا حدث قبل رحلة الطهطاوي، في حين أن بعضها الآخر حدث بعده. وفي كلتيهما نجد تحوّلاً كبيراً تجاه سؤال النهضة. بل نجد تأثيراً متميزاً لرحلة الطهطاوي. وهنا أمكن القول: إن رحلة الطهطاوي باتت تشكّل لحظة تاريخية قطيعية يمكننا بعدها تقسيم الرحلة إلى نمطين: ما قبل رفاعة الطهطاوي وما بعده. قد تكون بعض من هذه الرحلات التي سنتعرض لبعضها، قد حدثت متأخرة عن تجربة رفاعة الطهطاوي. لكنها جاءت مناسبة للظرفية التي فرضت على المغرب الالتفات إلى الضفة الأخرى وما كانت تشكّله من خطر حضاري على المغرب. لاسيما وأن هذا الخطر كان سبباً في احتراز المغاربة من أوروبا، حيث باتوا أخبر بقدراتها قبل أن يفاجؤوا هم أيضاً بنهضتها العسكرية التي كانت أوّل ما أذهل رحّالة سفاري مثل الصفّار. وهنا فقط ندرك أيضاً لماذا كانت هزيمة المشرق الإسلامي مبكرة حينما نقيسها بهزيمة المغرب كآخر القلاع التي سقطت بيد الأوروبيين. فحتى حينما غزا نابوليون مصر كان يحتفظ باحترام خاص للسلطان المغربي. نستطيع القول: لقد سقط الباب العالي قبل أن يسقط السلطان المغربي الذي كان لا يزال يخوض بعد سنوات من سقوط الخلافة العثمانية ما عرف في المغرب بالجهاد البحري، وما عرف عند الأوروبيين يومها بالقرصنة. كان لا بد أيضاً من استحضار معطى آخر ألا وهو أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي ظلت خارج الهيمنة التركية العثمانية في عزّ قوتها ومجدها، وبالتالي وصفت في بعض الرسائل الأجنبية بالإمبراطورية. هذا إنما يؤكد أن المغرب كان له نصيب قديم من هذه الرحلات في نطاق التبادل الدبلوماسي. لكنها لم تكن تلتفت إلى ما التفت إليه الرحّالة المغربي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث ميلاد ما سماه علال الفاسي ببداية الانبعاث المراكشي. وحتى ندرك الأسباب الموضوعية لتميز خطاب الرحّالة المغربي، وجب التذكير أيضاً بأن الوحدة السياسة للكيان المغربي والقرب من الديار الأوروبية، جعل النمط الغالب على الرحلة هو الرحلة السفارية. وهي لذلك تميّزت بنوع من التعالي والتحدّي والاعتزاز الهوياتي. مهما حاول أصحابها التقيد بالموضوعية في الوصف كانت تأخذهم حالات من التحيز. وذلك لأنهم لم يستطيعوا التخلص من إحساسهم بأنهم الأمة العظيمة الغالبة والقاهرة والمهابة من قبل الفرنجة على امتداد قرون من الزمان. فهم -باستثناء بعضهم فقط كالصفار وإلى حد كبير الحجوي- يذمون كثيراً ويستحسنون من معالم قوة الديار الأوروبية ما يرون أمتهم أولى به من الفرنجة أنفسهم. وقد كان من الطبيعي أن يتأخر هذا النمط من الخطاب الرّحلوي المتمحور حول سؤال النهضة، حيث إن المغرب حتى حدود القرن التاسع عشر، لم يكن على يقظة واهتمام بالخطر الذي كان يتهدده من جهة الشمال، الآخذ يومئذ في تطور حثيث ونهضة عسكرية ومدنية لا تضاهى. فالعلاقات الطويلة مع فرنسا وباقي الديار الأوروبية كانت تعرف حالة من الاستقرار النسبي حتى مع وجود واقع حركة القرصنة التي شكّلت ثابتاّ من ثوابت سياسة السلطان المغربي، لأنه كان يدعمها. بل لم تعد القرصنة أمراً حرًّا فوضويًّا بل كان عملاً منظماً تسهر عليه الدولة في إطار ما عرف يومها -كما ذكرنا- بالجهاد البحري. وكانوا يقومون بالقرصنة لدعم خزينة الدولة وإثبات قوتهم عبر هذا العمل الروتين الذي كانوا يقومون به شهرين في كل عام. يؤكد ذلك قول المهدي الغزال: “ومن بركة مولانا الإمام وفضله وعظمته وعدله إلقاء الجزع من سفنه في قلوب المشركين، وبقاء الجزع من قراصينه الجهادية في أحشاء أعداء الله الكافرين، يحذّر منها بعضهم بعضاً، ويتنكبونها في البحر وطرقه طولاً وعرضاً. على أن سفن سيدنا الجهادية مقصور جهادها على شهرين في السنة… وصار العدو الكافر يترك البحر في الشهرين المعلومين ويسافر بقية السنة لينال في ذهابه وإيابه مأمنه” .
ويؤكد بروديل «في المتوسطي والعالم المتوسطي»، أن القرصنة كانت ظاهرة كونية، ليست ملكاً لطرف آخر في البحر المتوسط [3] .
وعلى الرغم من أن نشاط القرصنة كان عامًّا متعارفاً، أدارته دول ومارسته بوصفه جزءاً من نشاطها العسكري البحري الروتيني، إلاّ أن فرنسا بدأت تستغلّ هذا النشاط لتتحرّش بالمغرب. وقد تحدثوا عن جملة الكتابات التي كانت تحرّض فرنسا ضد المغرب باسم ملاحقة القراصنة -من سلا- من حيث كانت مجرد ذريعة لتنفيذ مخطط بعيد المدى في رهاناته الاستراتيجية والحضارية. من بين تلك الكتابات التحريضية ذكروا كتاب فولني (Volney Ruines Les) نشر في باريس سنة 1791م: «إن العالم الإسلامي هو مثال واضح ورمز للاستبداد» [4]. وفي السياق نفسه يذهب جوزيف كوراني في (Gouvernement. Recherches sur la science du) إلى القول: «ينبغي على الأمم الأوروبية أن تمنع البرابرة (بلدان إفريقيا الشمالية) أن تتحكم في البحار وتقوم بهجماتها علىصقلية وسردينيا وفي سواحل إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وفي بعض الأحيان في سواحل فرنسا..، وعليها (أوروبا) أن تخير هؤلاء القراصنة على الاشتغال بزراعة أراضيهم كما من واجبها القضاء على حكوماتهم الاستبدادية» [5].
استمرت علاقة المغرب بفرنسا حتى بعد إقدام هذه الأخيرة على احتلال كل من إسبانيا والقاهرة. ولم يكن الخطر الفرنسي بالنسبة إلى المغرب وارداً حتى تلك اللحظة. لقد تأخر التفات المغرب إلى الخطر الفرنسي. وجدير بالإشارة الوقوف على بعض الحقائق التي من شأنها بيان الفارق في الميل والذوق واللهجة بين النمطين المذكورين من الرحلة. لماذا الرحالة المغربي حتى في لحظة الاندهاش والصدمة لم يكن مأخوذا حتى الأخير في دهشته من التفوق الحضاري لفرنسا؟ إن للمغرب حكاية أخرى في موقفه من التحولات السياسية التي شهدتها فرنسا وكان لها أثر في باقي التحولات التي عرفتها الديار الأوروبية فيما تلا ذلك. وأعني تحديداً الموقف السلبي للمغرب من الثورة الفرنسية. علينا أن ندرك أن موقف المغرب من الثورة الفرنسية لم يكن إيجابيًّا منذ البداية لأسباب تتعلق بالموقف السلطاني منها ومن رجالاتها. وليس مرد ذلك إلى أن هواه كان مع فرنسا أقول الثورة، أو للعلاقة الخاصة التي استمرت بين البلدين، ونظراً للموقف الإنجليزي أيضاً الذي ما فتئ ينقل معلومات مشوشة إلى المخزن عن أحوال الثورة الفرنسية فحسب، بل مرجع ذلك إلى عدم استيعاب هذه النظم التقليدية بما فيها الأوروبية حينئذ للبديل الذي طالبت به الثورة الفرنسية ونظراً للخطر الذي مثلته إزاء باقي النظم الأخرى بشعاراتها وفوضاها العارمة. وقد انخرط المغرب بقوة يومها في هذه الحملة، نظراً لعلاقته المميزة مع الإنجليز. حتى أنها كانت العلاقة الوحيدة بين المغرب ودولة أوروبية تميّزت بالكثير من الاحترام للجانب المغربي، بخلاف خطابه الصارم والشديد والمستعلي ضد باقي أقطار أوروبا. عبّر الموقف الرسمي بكل وضوح عن موقفه الصارم من حدث إعدام الملك لويس السادس عشر (يناير 1793م). فقد كتب السلطان المغربي رسالة جاء فيها: «لقد بلغني، أن كل سلاطين أوروبا جمعوا قوتهم واستعدوا لإعادة عرش فرنسا إلى يد ابن الملك الذي اغتيل بكل بشاعة.. وأُعلن أمام الملأ أنني أساندهم وأرغب أن ينفذوا ما عزموا عليه من أجل سعادة البشرية.. وبذلك فإني مستعد للتعاون معهم في هذه المسألة، كما أنني أمنع الدخول إلى أراضينا على كل هؤلاء الفوضويين والأوباش الذين لا يعترفون بعاهلهم الشرعي» [6].
إذن كانت الثورة الفرنسية في نظر المغرب ثورة أوباش وفوضويين، ومثل ذلك كان الموقف التركي العثماني من هذه الثورة. فلا ننسى الرسالة التي بعثها الخليفة العثماني سليم الثالث إلى السلطان أبي الربيع (1799م) يصف فيها الثوار الفرنسيين بأنهم: «الطائفة الخائنون والشرذمة الملعونون ذوو مكر وفساد وأهل بغي وعناد، لا يؤمنون بوحدانية الله ولا يعترفون برسالة محمد بن عبد الله، منكرون ليوم البعث والنشور والويل والثبور» [7].
كذلك إن المؤرخين المغاربة تجاهلوا أحداث الثورة، ومن تحدّث عنها وهم قلّة عبّروا عن رأي السلطة نفسها، كما فعل محمد الجنوي حينما تحدّث عن ثورة الطريقة الدرقاوية، مقارناً بينها وبين الثورة الفرنسية؛ قال: «قام درقاوة في قطرنا، والفرنسيس في قطرهم، وينشأ عنهم جميعاً فساد هذا العالم» [8].
يذكر أيضاً أن مصدر الصورة الهجينة للثورة الفرنسية هي من إيحاء بريطانيا. كانت هناك محاولات بريطانية لنقل صورة مشوهة عن الثورة الفرنسية إلى المخزن وتحريضه وتخويفه بأن فرنسا قادمة على احتلال مدينة سبتة. وكانوا يحاولون إقناع السلطان المغربي بالتحالف مع الدولة العثمانية ضد فرنسا. غير أن موقفاً مغربيًّا جديداً سيطرأ لمجرد أن تتحرك فرنسا باتجاه السلطان المغربي لتغيير صورتها لديه. وقد نجح في ذلك نابوليون ببراعة سياسية تبخرت معها كل المحاولات البريطانية. أعادت دبلوماسية نابليون الثقة إلى العلاقة بين المغرب وفرنسا فيتغيّر الموقف المغربي رأساً. تكرّست هذه الثقة عبر مجموعة من المواقف من بينها أن نابليون حينما استولى على مالطة وفي أثناء اتجاهه إلى مصر، طمأن السلطان المغربي عبر قنصله كييط حيث قال: «سيكون لهذا الحدث وقع خاص عند مولاي سليمان كبرهان على صداقتنا المتينة معه، لأن فرنسا سترسل له الأسرى المغاربة الموجودين في الجزيرة ومن ضمنهم امرأة من سلالة الأسرة الشريفة» [9]. بل ويتم طمأنة الجهاز القنصلي الفرنسي للمغرب بعد استيلائه على مصر، بتأمين مرور الحجاج المغاربة القاصدين مكة عن طريق الإسكندرية أو القاهرة. وقوله: «إنه يستطيع دائماً إرسال المغاربة إلى مصر سواء للتجارة أو لتأدية فريضة الحج إلى قلة» [10].
وهذا يؤكد أن المغرب حتى ذلك الوقت لم يكن يستشعر خطر فرنسا، أي حتى بعد احتلالها لمصر. غير أنه أدرك هذا الخطر حينما واجهه عمليًّا في الميدان على إثر صدمة كانت هي كبرى صدمات المغرب تجاه التفوق الفرنسي وبالتالي الأوروبي، الذي لفت المغرب إلى حجم الفجوة بينه وبين قوة فرنسا وأوروبا. وكان ذلك بسبب ما حصل في معركة «إيسلي» 1844 الشهيرة، التي شكّلت منعطفاً كبيراً، أعقبته بعد ذلك تجربة الرحلة في نمطها الثاني المصحوبة بالحسرة على الفارق الحضاري بين العالمين. يصف بروكلمان هذا الحدث قائلاً: «وفي 14 آب دارت رحي المعركة في وادي إيسلي، أحد روافد نهر تافنا، بين الفرنسيين والجيش المراكشي وكانت عدته 65 ألف رجل تحت قيادة ابن السلطان، ولم يكن تحت تصرفه أكثر من ستة آلاف مقاتل، ومع ذلك فقد استطاع أن يهزم هذه الجيوش الضعيفة السلاح، الفاقدة النظام» .
كان خطاب الرحلة بمثابة التعبير الميداني عن عمق هذه الفجوة الحضارية الآخذة في الاتساع. وكان المركب النفسي التاريخي هو الهزيمة العسكرية المنكرة. لذا، كان تركيز الرحلة دائماً على الجانب المتعلق بالتنظيم والإدارة والهيكلة… وقلما كان الاهتمام بالوقوف عند الظاهرة الاجتماعية والفلسفية للنهضة الأوروبية. وسوف أضرب أمثلة على هذه الرحلات «المغربية»، لكي نقف على الهواجس الحضارية التي تحكّمت بها وسبب اختلاف المزاج السياسي والفقهي للرّحالة المغربي في تعاطيه مع تفاصيل الرحلة لا سيما الباريسية منها.
خصائص الرحلة المغربية
يزعم سعيد بنسعيد العلوي مؤرخاً للرحلة المغربية أن لدينا في الخزانة المغربية محققاً ومخطوطاً عشرة نماذج، لعلها هي الأهم من كل الرسائل والكتب التي أُلِّفت في هذا المجال، إن لم تكن هي جميع ما لدينا. وهذا القول على أهميته لا يحجب الظّن بوجود ما يفوقها ما دام الاستقراء التام لم يقع ولم يُدّعَ من قبل ولا من بعد. وإن كان اهتمام الباحث بهذا المفصل الثري من التراث المغربي الحديث نموذجاً مميزاً ومفيداً. فمن خلال إدراج عناوين الرحلة المغربية إلى الديار الأوروبية، نكتشف أنها كانت من نمط الرحلات السفارية:
الإكسير في فكاك الأسير لمحمد بن عثمان المكناسي (1779 – 1780) زمن الرحلة).
البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسارى من يد العدو الكافر لمحمد بن عثمان المكناسي نفسه (1781 – 1782).
رحلة الصفار (محمد بن عبد الله) (1845 – 1846).
الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية لمحمد الطاهر الفاسي (1860).
– تحفة الملك العزيز بمملكة باريز لإدريس العمراوي (1908).
-التحفة السنيّة للحضرة الحسنيّة بالمملكة الإسبنيولية لأحمد الكردودي (1884).
-إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار لإدريس الجعايدي (1876).
-رحلة الغسال للحسن الغسال (1902).
– حديقة التعريس في بعض وصف ضخامة باريس لعبد الله الفاسي (1909).
-الرحلة الأوروبية لمحمد الحجوي (1919).
تتوزع الرحلة المغربية إلى آفاق مختلفة منها ما هو شرقي ومنها ما هو غربي. فبينما كانت الرحلة إلى أوروبا سفارية كانت الرحلة إلى المشرق علمية. والغالب على الرحلة المشرقية هو الرحلة الحجازية التي كانت تتم لغاية طلب العلم ونيل الإجازات والحج. وهذه الرحلة المشرقية لا تهمنا هنا. لأن الغاية تتعلق بخطاب رحلة تتمحور حول النهضة والتقدم. فهو خطاب سياسي وفلسفي ونهضوي أكثر مما هو إنشاء أدبي ينجز في العادة للتسلية والإمتاع. في الرحلات من النمط الثاني، تحتل «باريس» عند الرّحالة مكانة مميزة. يصفها الرحالة المغربي وصفاً يقرب من وصف الطهطاوي، وأحياناً يتوسع في بعض المعالم أكثر من الطهطاوي. لكننا مع ذلك لا نكاد نقف عند الطهطاوي على مثالب هذه المدينة وقوفنا على مثالبها عند الرحالة المغربي. وليس بعيداً أن بعضهم التقط عيّنة من نقد الطهطاوي لبعض مظاهر المدنية الفرنجية وتوسع فيه أبعد مما فعل هذا الأخير الذي بلغ به الإعجاب بنهضة الفرنجة ما جعله يسرف في التمجيد كما يسرف في هجاء المحلّي إلى درجة الوقوع من حيث لا يشعر في خطاب عنصري كما مرّ معنا. لكن مع بعض الرحالة المغاربة نقف على الوجهين مع. وحتى في عزّ الإعجاب يظل خطاب الهوية حاضراً حضوراً مكثّفاً. أذكّر بأن الأسباب الموضوعية لذلك تتجلى في أنّ صدمة الحداثة في الديار المصرية سابقة منذ الغزو النابليوني لمصر. وليس المطلوب حينئذ من الرحالة السفاري المغربي أن ينطلق من موقع الإحساس بهذا الغلب الحداثي حيث لا يزال المغرب بلداً يحسب له حساب في الدوائر الأوروبية حتى أن نابليون نفسه كان يهدّئ اللهجة مع المغرب في اللحظة نفسها التي غزا فيها مصر. ولا يرجع الأمر بالتأكيد إلى عوامل أخرى ما دام الرحّالة المغربي كان أكبر مقاماً من الناحية العلمية والفقهية وكذا الخبروية من الطهطاوي نفسه كما ذكرنا حينما همّ بالرحلة الباريسية. وقد ضربنا أمثلة من أمثال الحجوي الثعالبي وهو عالم مجتهد فضلاً عن وظائفه في الدولة إذ تولّى مناصب عديدة في الدولة منها وظيفة نيابة الصدارة العظمى في وزارة العلوم والمعارف فضلاً عن رسائله الاستشارية وخطابه التنظيري الذي عالج كل معضلات الدولة والإدارة والاجتماع والفكر والوعي، أي ليس السبب في هذا التميّز هو الخبرة والمكانة العلمية والوظيفة السياسية أو الإدارية التي هي من رجحان الرحالة المغربي، بل السبب العارض على اختلاف التجربتين التاريخيتين وما كان يمليهما الوضع على اختيارات المغاربة الذين لم تتمكّن منهم صدمة الحداثة تمكّنها من الديار المصرية. وهذا سنذكره في الأمثلة التالية من خلال بعض من هذه النماذج الرّحلوية. ومن الجدير القول: إن ثقل المهمات الرسمية والوظائف السفارية كانت في حدّ ذاتها مانعة للرحّالة المغاربة من أن يكونوا أكثر احتكاكاً وتجرّداً من الطهطاوي. لقد سافر الطهطاوي إلى الديار الباريسية وهو عالم ومثقف صاحب وظيفة دينية تقتصر على مرافقة البعثة الطلابية، لكن الرحالة المغربي حينما يسافر إلى الديار الفرنسية يلزم نفسه بالكثير من قواعد البروتوكول وهو يجر وراءه هيبة الدولة والسلطان، فلا يتواضع لأي سلطة في تلك الديار حتى لو تعلّق الأمر بسلطة الحداثة نفسها.
الرحلة السفارية وانهيار هيبة المغرب
لا يخفى أن الوضع في بلاد المغرب كان حتى معركة إيسلي 1844م، إلى حدّ ما طبيعيًّا. فالمغرب لا يزال يحتفظ بهيبته وطريقته في التعامل من الأقطار الأوروبية ظلت طريقة موسومة بالتعالي، والاستهتار، وربما كان هذا خطأ لم يكن يستحضر صيرورة الاستقواء الأوروبي لكن المعركة كانت منعطفاً كبيراً، نتج عنه إحساس دراماتيكي بالهزيمة. كانت 1848م هي السنة التي سيبدأ فيه المغرب استئناف حركة سفارية على خلفية مجموعة من التنازلات مكّنت فرنسا من السيطرة والتغلغل في المغرب بصورة ملفتة للنظر. وكانت إسبانيا أيضاً قد استغلت هذه الهزيمة لتستولي على الجزر الجعفرية. ما يؤكد أن هذه الهزيمة شكّلت اللحظة المفصلية لذهاب هيبة المغرب، وهو ما عبّر عنه الناصري صاحب «الاسقصا» بالقول: «ووقعة تطاوين هذه هي التي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب، واستطال النصاري بها، وانكسر المسلمون انكساراً لم يعهد لهم مثله، وكثرت الحمايات، ونشأ عن ذلك ضرر كبير، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة».[12]

معركة إيسلي التي جمعت وجها لوجه في حرب كلاسيكية نظامية بين جيش الدولة المغربية وجيش الدولة الفرنسية
وللوقوف على عينات من تلك الرحلة، ومعرفة أذواق أصحابها وهواجسهم السياسية والثقافية والدينية، ما علينا إلاّ الإنصات لبعضهم من خلال النماذج التالية:
محمد ابن عثمان المكناسي

لعب هذا السفير المغربي دوراً أساسيًّا عبر رحلتين، إحداهما لإسبانيا والأخرى لمالطا ونابولي، بهدف مهمة محدّدة، ألا وهي التفاوض حول الأسرى. لذا لا غرابة أن نجد عنوان الرحلتين معاً يخصّان مهمة واحدة الأولى: الإكسير في فك الأسير. والثانية: البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسارى من يد العدو الكافر. كان الفارق الزمني بين الرحلتين عاماً واحداً. رجع من الأولى في 1780م وانطلق إلى الثانية في 1781م. وكانت مدة مكثه في الأولى والثانية سنة كاملة. يدل هذا على أن ابن عثمان نجح في مهمته الأولى حتى أصبح محل ثقة السلطان، وكدبلوماسي ماهر في تدبير ملف الأسرى. ولم يكن الملف المذكور محصوراً في حدود التفاوض على الأسرى المغاربة نظراً لاستقلالية المغرب حينئذ عن باقي الإمبراطورية العثمانية. بل كانت هذه المهمة تتعدى إلى التفاوض حول عموم الأسرى المسلمين في شتى البقاع الإسلامية لا سيما أولئك الذين أهملتهم السياسة التفاوضية التركية التي عادة ما كانت تستبدل الأسرى الأتراك بأسرى العدو ولا تشغل نفسها بالتفاوض من أجل الأسرى من غير الأتراك. لعب المغرب يومها دوراً أساسيًّا في عملية فك الأسرى، حتى أن بعضاً من هؤلاء الأسرى بعث رسائل إلى المغرب، وانطلق المغرب للتفاوض حولهم لاسيما وأنه انزعج من موقف الحاكم التركي في الجزائر الذي كان يفدي فقط الأسرى الأتراك ويترك باقي المسلمين. مع أن «بيده من أسرى النصارى ما يفدي بهم هؤلاء ويظل لديه مزيد» بتعبير المكناسي[13].
إن رحلة ابن عثمان، موسومة بالفخر والاعتزاز بقوة المغرب والإسلام وأيضاً الاندهاش بالآخر في حدود مدنيته إلى حد الإعجاب، وكذلك النفور من بعض طباعه إلى حد الهجاء. جاء عرضه للرحلة واضحاً وصريحاً حتى أنه لم يكن ليخفي موقفه من مباهجها أو مثالبها. ليس في وصف ابن عثمان انبهار فقط وليس فيه هجاء فقط. لكن يبدو فيه الكثير من عوامل الاعتزاز بالذات. فالذّات هنا هي المدار في كل ما يصفه رفضاً أو قبولاً. فالمقبول هو ما يفيد المغرب والمرفوض هو ما يضره من هذه المدنية. ليست أوروبا هي المعيار، بل المعيار هنا مجرد ومتعالٍ يقع في صلب تراثنا وديننا وتاريخنا. وعلى أساس هذا المعيار يتم القبول والرفض لمعالم المدنية الأوروبية. يتجلى الانبهار بالعمارة والتنظيم وما شابه إلى حد الإعجاب وأحياناً الدهشة التي يعبر عنها: «وأما ما بها من الخيرات، فحدث عن البحر ولا حرج: فالفواكه موجودة فيها في غير إبَّانها، حتى تجتمع فاكهة السنتين معاً»[14].
ليس الأمر اعتباطيًّا ولا محاولة لتركيز الانبهار على عوامل طبيعية لا يد للمهارة الإنسانية فيها، بل الأمر يتعلق بتطور فن الزراعة. لأن «لهذا الجنس خبرة كبيرة بالفلاحة وتربية الأشجار». إن مسألة الإعجاب بالمظاهر الأوروبية، تحدّث عنه باقي الرحالة المغاربة بشكل مدهش جدًّا. وهذا الإعجاب المعبر عنه يتكرر في محطات مختلفة إذ يقول:
«وشاهدنا من العجب في تلك الدار ما لا يمكن وصفه من أنواع التصاوير والبناءات والحيوانات التي تخيّل للناظر كأنها قائمة بالذات، ومن آلات الطرب والرقص ما لا يكيّف».
في وصفه دار الطاغية «خزانة كبيرة موضوع فيها الغرائب» في وصف غرس وحدائق إشبيلية القريبة من القصر «ففيها من العجائب ما يقصر عن وصفه اللسان» في وصف نابولي: «الحاصل، هذه المدينة من عجائب الدنيا، لا تنقضي عجائبها ولو أقام الإنسان سنين فيما لا يُحصي عجائبها ولا يستوفيها»…[15].
يتبع