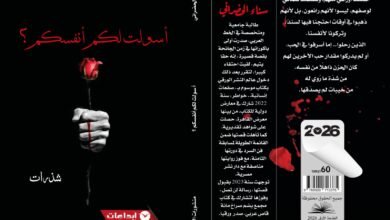هل هناك ما يؤكد على نجاعة التعريف الكلاسيكي للمنطق باعتباره آلية لصون الفكر من الخطأ؟ هل يكفي المنطق لتحصين الفكر من الخطأ؟ ما معنى أخطاء الفكر ومصدرها؟
ليس الخطأ المقصود هنا تلك الأخطاء التي هي بالفعل ضرورية لتطور الفكر نفسه، فالفكر يقوم على تصحيح أخطائه، بل قد يكون الفكر هو عملية تصحيح أخطاء الفكر نفسه.
لقد اتّضح لي أن تحقيقات دفيد هيوم في الذهن البشري على أهميتها التأسيسية الكبرى، ركزت على العادة والتكرار، ولكنها لم تتجه نحو كيفية تشكّل الخطأ نفسه استنادا إلى الأورغانون، ومن يمنح العادة سلطة التعليل؟ ذلك الخطأ نفسه الذي يُعنى به المنطق، أعني المغالطة.
فالمغالطة كانت ولا زالت مثل باكتيريا تتطوّر وتكتسب لها مناعة، لا يفيد معها بقاء المنطق جامدا على مقولاته الكلاسيكية، فالمغالطة اليوم قادرة على تجريد المنطق من فعاليته، بل إن المنطق نفسه بات مخترقا، بل آلية تستعملها المغالطة في تعزيز نفوذها في الفكر.
ليس أمامنا سوى خُلف منطقي إن نحن أردنا مقارعة المغالطة حينما تصبح لها دربة في استعمال المنطق نفسه، دربة تتسم بالمكر المطلق. وإذن ماذا بعد؟
يظل الحدس بوصفه سابقا على البرهان، الحدس بما يوفره من قدرة هائلة على التشكيك تارة واليقين تارة أخرى، هذا الحدس منبعه الأساسي هو الحكمة. وسيكون من الصعوبة بمكان القول أن هناك انقلابا في طبيعة الحاجة والدّور، حيث تصبح حاجة المنطق إلى الفلسفة أكثر إلحاحا من حاجة الفلسفة إلى المنطق.
أتحدّث عن القوة التساؤلية والحدسية للفلسفة كممارسة يقظة، وكاتصال حدسي بالوجود. إن حدس الوجود، المفهوم الذي قصدت منه قبل سنوات تجاوز المقدمات البرهانية على ما لا يتوقف انكشافه على البرهان، بأنّها أكثر وفاء لحكمة الوجود.
إن حدس الوجود هو مدخل الحكمة الخالدة التي وحدها تعصم الفكر من التّيه. لن ينفع المنطق في هذه المهمة إن تخلينا عن حدس الوجود. وفي هذا الحدس تتفاوت إرادة الإنصات واليقظة.
وعليه، فإنّ المغالطة في ذروة شططها استطاعت أن تخترق المنطق وتطوّعه لخدمتها، فلم يعد منطقا عاصما، بل منطقا مجردا يحتاج إلى الحكمة. ففي تساؤلات الحكمة وإصرارها على أولوية حدس الوجود، يكون المنطق وسيلة تحتاج إلى إطار يحميها من الاختراق الماكر للمغالطة التي تستمد قوتها من المنطق نفسها، كالفيروس الذي يستمد مادته الحيوية من الخلية نفسها التي تصبح ضحيته.
لن يعصم المنطقُ الفكرَ من الخطأ في زمن التّفاهة وفرط المغالطة، من دون حكمة. والحكمة هي وضع الشيء في مكانه المناسب، والمنطق لن يفيد ما دامت المغالطة تستنزل مقولاته في غير موضوعاتها المناسبة.
إن اعتبار العلم ضربا من الإضافة منح فرصة للمغالطة أن تخترق المنطق، بينما حين يصبح العلم من مقولة معلومه، وحين تصبح المعرفة هي عين الوجود، يمكن للفكر أن يصون نفسه بنفسه، باعتبار أنّ المنطق هو في الأصل صناعة للفكر. فالفكر الذي اكتشف المنطق لقادر على أن يعصم نفسه من الخطأ متى أدرك أنّ مهمّته موصولة بالحدس الأعظم: حدس الوجود.
جرّب أن تنصت لحدس الوجود، فستكتشف أنّ المنطق متى وقع في يد عقل ماكر، فإنّه سيضع موازينه في غير موضوعاتها، وسيصبح في خدمة المكر والمغالطة، في انقلاب مبيت للمنطق على الفكر وعلى الوجود.
حين تتغلّب المغالطة وتبدو أكثر دُربة في استغلال المنطق، لن يبقى أمام المتلقي سوى حدسه الوجودي، فهو الذي يمنحه الشعور بالخطأ المبيّت والمكر الخفي، يشعر حينئذ الفكر بأنّه ضحية خطئ ما، وإن كان يجهل مصدره وطبيعته، لكن حدس الوجود يدعوه للرّوية قبل أن يستعيد السيطرة على مسار التفكير الصحيح. حتى المنطق نفسه يحتاج إلى الحدس في عملية التنزيل والاختبار للفكر.
الحدس استشعار للخطأ في الفكر، والمنطق أداة إدانة
وقد يتساءل البعض عن ماهية هذا الحدس العاصم من الخطأ، وعلى أي قاعدة من قواعد المنطق يمكن تأطير عملية اختبار الفكر وتشخيص الخطأ، وهل وظيفة الحدس مزدوجة، أي: الافتراض والتقويم؟ والحال أننا نستشعر قوة الحدس في لحظة تولّد الفرضية نفسها، في تجربة تنزيله، حيث إن اختبار الفرضية بالتجريب لا ينفي اليقين العميق والابتدائي الذي يحيط به الحدس الفرضية. وهو يقين ضبابي، لكنه مصحوب بالروية، أي أنه يقين مؤجَّل.
فهل يا ترى كان الفكر قبل اكتشاف الأورغانون عديمًا؟ وهل استطاع الفكر، بعد الأورغانون، أن يعصم نفسه من الخطأ مطلقًا؟ وقد علمنا أن المغالطة اكتسبت بعد اكتشاف الأورغانون مناعة كبرى، حتى بات الخطأ البسيط في الفكر خطيئة معقّدة.
فتاريخ أخطاء الفكر ينبئنا بأن الحدس لعب أدوارًا في تصحيح الفكر، أكثر مما فعل الأورغانون، الذي تحوّل، في الممارسة الفكرية الزائفة، إلى حجة للسلطة لقمع كل محاولة للاختبار. لولا الحدس لساخت الأرض بأهلها، ولخرب العمران البشري.
تحيط المغالطة نفسها بمزاعم تحيل إلى الانضباط الزائف بالمقولة، في حين فقد المنطق مناعته ضد الانتحال.
إن الحدس، الذي يَكسب طراوته من التعلّق بالوجود حضورًا وفيضًا، يمنح المفكّر مناعة ونباهة، على الأقل، تكسب الفكر روية عند الخطأ، فتتشكل فرضية الأخطاء، حتى يتمكن من القبض على شيطان المغالطة، الذي غالبًا ما يستغل سرعة المرور بأوتوستراد المغالطة، لتحقيق الاستنتاج الخاطئ عبر اختزال مقدمات البرهان، وإخفاء بعضها بأساليب سحر الخفّة.
وغاية الأمر أننا نمنح الحدس سلطة وضمانة على البرهان نفسه. فكما أننا اعتبرناه مانح الفرضية، وصاهر الانتقال من مقدمة إلى أخرى في سير البرهان، وكذا في تمكين الاستنتاج من النقلة الاستقرائية، فإننا نمنح الحدس ضمانة لتصحيح الفكر، وضمان تحقق المنطق في البرهان.
إن ضبط المغالطة هو نفسه رهين بالحدس؛ هذا الأخير يفترض الخطأ، ثم يتتبع آثاره في الفكر، فيكون المنطق هو رصاصة الرحمة، التي يفوض الحدس أمرها إلى البرهان.
في التخاطب اليومي، يلعب الحدس دورًا أساسيًا في تقويم الأفكار.
علينا، بعد ذلك، أن ندرك وظيفة الحدس؛ ذلك الذي يطالبنا بالإنصات والروية.
الحدس يفتح الطريق أمام افتراض التخطئة، ولعل ذلك ما يعزز نظرية الدحض إبستيمولوجيًا، ورأي المخطِّئة كلاميًا.