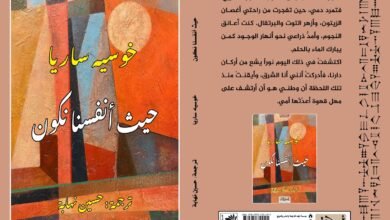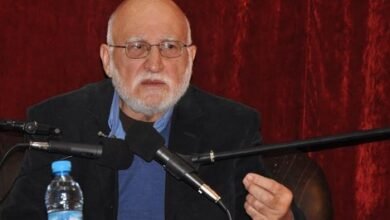بعدما جرب المزيفون العرقيون خطة تمزيغ المغاربة، باعتماد البيولوجيا و الأركيولوجيا، و فشلوا في ذلك فشلا ذريعا بعدما كشفنا زيفهم عبر التحليل العلمي الدقيق، يعملون الآن على تجريب خطة تمزيغ المغاربة سوسيو-ثقافيا عبر ادعاء أن الثقافة/العقلية المغربية أمازيغية !!
هؤلاء يعانون من الأمية الأكاديمية، و لذلك يهرفون بما لا يعرفون حينما يسعون إلى اختزال الثقافة المغربية المؤسسة على المتون التراثية العالمة، في علاقة بالثقافة العربية الإسلامية العليا Haute culture التي تصنف ابستملوجيا ضمن البراديغم Paradigme، في أشكال و تعابير (ثقافية) عابرة تنتمي إلى مجال الفولكلور Folklore الذي يصنف أنثربولوجيا ضمن الثقافة الشعبية الدنيا basse culture.
حل هذه المسألة يحتاج مقاربة أنثربو-ابستملوجية من منظور دراسة البنية و التكوين ضمن السياق السوسيو-ثقافي .. و لّي كيعاني من الأمية الأكاديمية يمشي يعتكف و يقرا، أما الهدرا (هدر الوقت) ديال اليوتيوب و التكطوك ما تشري خضرا !!
حينما نثير النقاش حول الخصوصية المعرفية التي تميز كل أمة/ حضارة عن غيرها و تحدد نظامها المعرفي الخاص، الذي تنتمي من خلاله إلى العالم، فإننا نعي جيدا أن هذه الخصوصية المعرفية تتأسس من منظور التراث العالِم القابل للتجسيد كنظام معرفي، و ليس من منظور الفولكلور الشعبي الذي يمثل اللحظات الهامشية و العابرة في تاريخ الأمم.
عندما صاغ “طوماس كوهن” مفهوم البراديغم Thomas Cuheh / Paradigme كان يمتلك هذا الوعي الابستملوجي.
لذلك، فقد اعتبر أن البراديغم منتوج تاريخ من الإنجازات العلمية/الحضارية، التي تمثلها رموز علمية/ فكرية قادرة على تجسيد رؤية العالم la vision du monde، كما يفصل ذلك “لوسيان جولدمان” L. Goldmann، مما يؤدي إلى إحداث طفرات معرفية تساهم في بناء المفاهيم/التصورات من داخل النظام المعرفي.
لكن، الفولكلور، كثقافة شعبية شفوية، مختلف تماما فهو صياغة للحظات العابرة في تاريخ الأمم و لا يمثل الخصوصية المعرفية الثابتة.
لذالك، فهو أبعد عن صياغة النظام المعرفي و تحديد طبيعة رؤية العالم عند الجماعة الحضارية/الاجتماعية بالمعنى الجولدماني (L.Goldmann).
هذا التصور النظري، رغم طابعه العلمي المجرد فهو يتحكم في الممارسة و يوجهها، فلا يمكن تحقيق مشروع التفكير/التصور/ الممارسة، من داخل النظام المعرفي، إلا إذا تحقق هذا النظام، أولا، كبنية تراثية مستقلة تمتلك رؤيتها الخاصة للعالم، و هذا يتجاوز التجسيد الفولكلوري الذي يمثل اللحظات الهامشية العابرة.
الأمم التي تمكنت من تحقيق هذه الخصوصية المعرفية/رؤية العالم، تمتلك تراثا حضاريا أصيلا مُدوَّنا، تنطلق منه باعتباره الأساس المتين الذي يُقام عليه البناء، فهو المسؤول عن تحديد طبيعة شخصيتها الجماعية، و هو المتحكم في صياغة نظامها المعرفي.
ليس مستغربا، إذن، اختصاص الابستملوجيا بمبحث التراث، و اختصاص الأنثربولوجيا بمبحث الفولكلور !
فالتراث يمتلك من الثوابت و الأصول ما يجعله مبحثا ابستملوجيا، لكن الفولكلور يفتقد لهذه الثوابت و الأصول المعرفية مما يجعله مبحثا أنثربولوجيا، أو سيميولوجيا حتى، لكن دون ارتقائه إلى مستوى النظام المعرفي القابل للتحليل الابستملوجي.