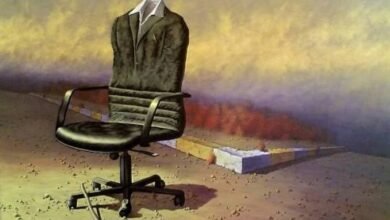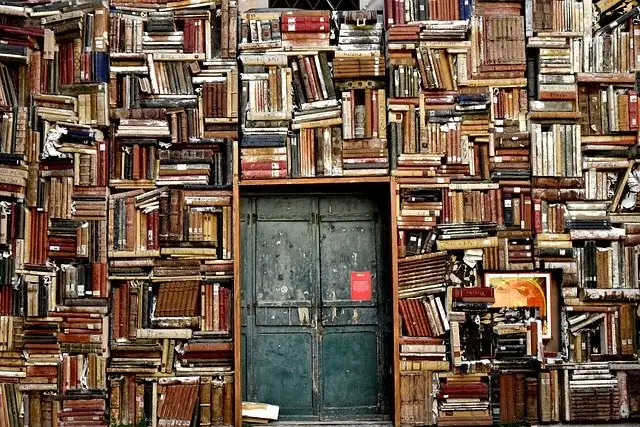
كان أحرى بتاريخ الأفكار أن يتعاطى مع هذا المسار الطويل من تقلّبات الفكر والعقل كتاريخ محاولة، ولكنها ليست مسارا غائيا نحو نهاية تحسم في مجمل تساؤلاتنا بل قصاراها تعيدنا إلى ما لم تحذونا الرغبة وإرادة المعرفة إلى سبره في أوانه، لا نفعل في أوقات كثيرة سوى أن نعيد الاعتبار لما تجاهلناه، إنها تهيّؤنا فقط لمزيد من التّواضع أمام الحقيقة.
سنكون مخطئين إن تحدّثنا في تاريخ الأفكار عن اللاّمفكّر فيه كوثيقة وربما سيقودنا مفهوم القطيعة إلى الإبتعاد أكثر عن محنة المعرفة باعتبارها متشعبة وربما لأنّ التقنية والمساحات الجديدة للوعي تستطيع مدّنا بإمكانيات لإعادة استيعاب الكثير من تلك المحاولات التي داسها غلب الأفكار الجديدة.
لم تخفف الإبستيمولوجيا ونقد العلوم من غلواء التفضيل، ولا زال البرهان يسعى لتفسير ما لم يكن يوما قابلا للتفسير، هذا مع أنّ البرهان الذي هرب من المعرفة المسبقة والمباشرة للكلّي لم يفعل سوى أنّ فجر إشكالية لا نهائية الجزئي، ليس البرهان بديلا ولا طريقا وحيد للمعرفة، الشيء الذي يُعاند العلم لمزيد من تجاهله. البرهان ليس سوى طريق آخر للمعرفة ، بل في محاولتنا السابقة عن الحدس هو شكل من الإدراك لا يستغني عن الحدس في المبتدأ والخبر.
في التراث الإسلامي -عربيا وفارسيا- تصدّى بعض النقاد والنُّقّاض للمنطق وكتبوا أشياء تستهدف الإطاحة بكبرياء البرهان الأرسطي، والحقيقة أنّ هناك أمثلة عديدة، فابن عربي تناول في موارد مختلفة إشارات من ذلك القبيل وإن حاول أن يتحيّز به الجابري في اتجاه المعقول البياني باعتبار أنّ عرفان ابن عربي بيانيّ، وذلك لشدّ عصب الفرقة الأندلسية من ابن مضاء النحوي إلى ابن عربي الصوفي إلى ابن خلدون المؤرخ داخل النسق الرشدي. وهذا مرفوض وغير مقنع لأنّ الغزالي المُدان جابريّا هو أكثر بيانية في تصوفه من ابن عربي.
وهناك من تناول نقض المنطق بتفريد عمل مخصوص كما فعل السهروردي وابن تيمية، وهما عملان يستحقّان النظر إليهما بمزيد من التحقيق، فالأصل في النقض على منطق اليونانيين هو محاولة السهروردي الذي طعن فيه ابن تيمية طعونا كثيرة لكنه في الوقت نفسه قام بسرقة أدبية كبيرة حين ردد كل ملاحظات السهروردي دون الإحالة عليه واستباحة لتراثه، لعل ذلك يدخل في فقه ابن تيمية وهو اغتنام خصومه وعدم الاعتراف لهم بأي مأثرة.
أسلوب مرد عليه ابن تيمية واكتسب شهرته من خلال مسروقاته التي وقفنا على أمثلة لها في نقضه على المنطقيين كما وقفنا على بعضها فيما زعموا تفرّده به في الفتوى، وهذا ليس مقام تحليل ذلك، إنّما يهمّني فقط أن أقول بأنّ ابن تيمية سعى لاستعارة نقض السهروردي على المنطق دفاعا عن النزعة الظاهرية، بينما كان الهدف من نقض السهروردي للمنطق هو الدفاع عن الحقيقة الباطنية. غايتان مختلفتان لكن الموقف واحد، كيف يصبح نقض المنطق طريقا لدعم الظاهر والباطن معا؟
يمثل الظاهر في نظر ابن تيمية نقيضا للباطن لكن هذا ليس صحيحا في نظر الباطنية، لا ابن عربي ولا الغزالي ولا السهروردي نظروا للباطن على أنه نقيض لظاهر، بل اعتبروه مرتبة في المعرفة. ولقد كان المنطق الأرسطي ظاهريا بما فيه الكفاية ويصلح أن يذود عن أهل الظاهر ولكن ابن تيمية خاصمه جريا على نهج العرفاء الذين نقم منهم ظانّا أنّ البرهان يهدد الدين، لكن الدين حين يصبح ظاهريا فهو شكل برهاني تجري عليه كل آفات المحاولات التي لن تستطيع الإفلات من الثّنوية والانفصال. لم يلتفت ابن تيمية ولا مادحيه ولا حتى خصومه إلى هذه المسألة حيث انطلت عليهم ردحا من الزمن ولا زالت.
لقد كرر ابن تيمية ما قاله السهروردي حرفيا لا سيما في نقضه للتعريفات، علما أنّ الظاهرية هي في نهاية المطاف غير معنية بهذا النقد، فحين نستبعد أن تكون الخاصة مميزة للماهية ورافعة عنها الاشتراك في الجنس العام، فهذا سيقودنا إلى إدراك الكلّي حدسا وهو شأن للباطني وليس للظاهري.
إنّ فضيحة ابن تيمية في نقضه على المنطقيين تكمن في مرتبة القصدية لأنّه ينتهك كل أسس الظاهرية نفسها، وحيث أنّه انتزع نقض السهروردي من قصديته واستبدله بغاية مفارقة. أقول مفارقة لأنّ ابن تيمية أخفى كل ذلك، أي كان باطنيّا في عملية الاستبدال تلك، أي مستعينا بموقف باطني دفاعا عن الظاهرية:نقيضة.
وعليه ليس في محاولة ابن تيمية في الرد على المنطقيين جديد بل هو موقف تلفيقي وتناقضي ومزيف وهو لم يأت لتوسيع مدارك الدليل كما ذهب طه عبد الرحمن فهذا من شأن العرفاء ويمكن أن ينسب لابن عربي وليس لابن تيمية، بل غرض ابن تيمية من هذا النقض المنحول هو تخريب الصناعة المنطقية وإعلانها نقيضا للفطرة بالمعنى الظاهري حيث لا يخصصها عن الجهل الأوّل، وهو ما فطن إليه الغزّالي مسبقا دفاعا عن الصناعة في المعيار، وكذلك لا تعني تلك اجتراحا للإسمية في موقف ارتجاعي من أبي يعرب المرزوقي.
لأنّ ظاهرية ابن تيمية توسلت بمواقف باطنية لدعم الظاهرية كما في نقض المنطق، ولا هي إسمية ترى الكلي كمعنى باهت للجزئي لأنّنا سنكتشف في باب التعريفات أنّ ابن تيمية ينحو منحى الإدراك المسبق للكلي على الجزئي، وللإنسان على الناطق وهو تمثّل منه لعبارة السهروردي لكنها تصحّ عند السهروردي ولا تصح عند ابن تيمية إذا أدركنا أنّ السهروردي يمنح للعلم الحضوري مساحة كبرى بينما ابن تيمية ظاهريّ يرفض الشهود. هذا جانب من تهافت نقض ابن تيمية للمنطقيين وهو بحث نرجؤه إلى مقام آخر.
إنّ خلاصة ما نصبوا إليه هنا أنّ الظاهر والباطن مرتبتان في المعرفة، وأنّ احتواء مراتب المعرفة باعتبارها مراتب لا نقائض هو من شأن الموقف المستند إلى حدس الوجود. لقد اختار تاريخ العلم لنفسه السقوط في حافة تفضيل البرهان على الحدس بينما هما ليس نقيضان بل مراتب متفاوتة ومتكاملة.
كيف نستطيع إدراك وحدة العقل والعاقل والمعقول إن لم نستند إلى حدس الوجود حيث هناك فقط نستطيع ردم الهوة التناقضية بين الظاهر والباطن، بين البرهان والحدس، وحينئذ سيصبح تاريخ الفكر هو تاريخ إرادات معرفية ومحاولات علمية وانتصارات نماذجية. لا زلنا عاجزين عن تعريف أي شيء إلاّ على سبيل التقريب والعرض العام بما في ذلك العقل..