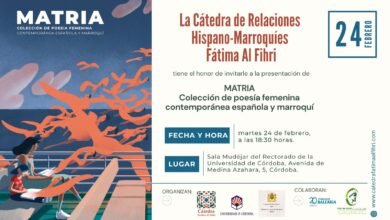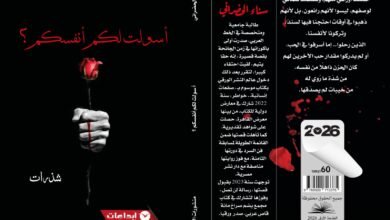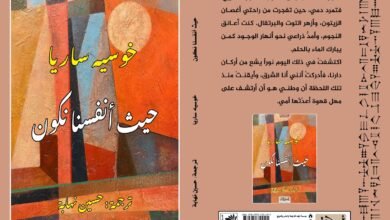أي معنى للمعرفة في الواقع وأي أثر لها في أحوال الأمم، إن هي ظلّت رواية مجردة تفتقد للشجاعة الكافية لولوج المهمة التّاريخية للعقل العملي؟ هنا تفترق مهمّة المثقف الحقيقي عن نظيره المستقيل، حيث تصبح المهمة المخاتلة هي تهريب العقل العملي في تشغيب العقل النظري.
لم يعد مُذّاك الوعي التاريخي مجرد دعوى بلا قيد، بل تعين تقييد الوعي التاريخي بمهام العقل العملي. وتلك هي المهمة التي تنهض بها محاولة المفكر المغربي الدكتور محمد المصباحي، استئنافا لسؤال التنوير، الممكن دائما، بل هي مهمة المثقف الحقيقي في لحظة موسومة بتدجين العقل العملي، لحظة غالبا ما يرتدي فيها عبيد المنزل معطف الفيودال، انتحال دور المثقف في عصر النصب السيبراني؛ مثقف الفوتوشوب.
بينما الفجوة بين الأمم اليوم على صعيد العقل النظري تقلّصت في إدارتنا لوجودنا ومصيرنا، حيث بذلك على الأقل نستطيع ضمان وجودنا واستمرارنا في شروط غير متكافئة، لكن سؤال التنوير يظل مهمّة تتطلّع إلى تفعيل مهام العقل العملي.
سؤال التنوير هنا ينطلق من خبرة فلسفية للباحث، من امتلاء مفاهيمي، والأهم من ذلك أنّه بمثابة لحظة فكرية جادة في زمان ثقافي يعيش الكساد، وحيث اختُطِف الزمن الثقافي العربي، وهيمن الزّيف وعربد، حتى اختلطت الوجبة بكراع كلب.
من هنا واجب التفاعل مع النصوص النابعة من قلق وامتلاء معرفي مزمن، لجيل سادة التفكير المغربي، تخفيفا من روتيني الثقافي وذهان ما عبر عنه باسكال بونيفاس بالمثقفين المزيفين.
في كتابه “من أجل تجديد التنوير الإسلامي”، يبادر د. المصباحي بشجاعة لتجاوز الموقف من السؤال الأيديولوجي، التشغيب على الوظيفة الايديولوجية، حيث في نهاية المطاف، نحن أمام سؤال العقل العملي: ماذا يجب أن نعمل؟ وأنّى يُصار إلى العمل من دون جهاز أيديولوجي؟ جزء من آثار الموقف العدمي من الأيديولوجيا هو تبرّم غير بريء أو جهل مركب بوظيفتها، إن لم نقل سوء تقدير لمهمة العقل العملي. معضلتنا مع الأيديولوجيا، تكمن في انزياحها، وهي في هذا غالبا ما تختفي خلف مغالطات مسنودة من مخاتلات العقل النظري. ففي هذا الالتباس يتهرب العقل المستقيل من مسؤوليته.
ما يلفت النظر هنا، أنّ سؤال المصباحي، يقع في تلك الما-بعدية التي تتحيها الخبرة والمسار التاريخي الذي ترتسم فيه انتصارات العقل وإخفاقاته. فهي ليست تنويرا حاسما في أسئلته، بل هو نمط مفتوح على التجاوز، تنوير مرن، يلاحظ كل مستويات العقل. ومثل هذا الوضع طبيعي، ففي تجربتنا التأسيسية في المغرب، كان لا بدّ أن تهيمن النزعة الوضعانية أو الأيديولوجيا في تمثّلها الأصولي للأنوار، وهذا طبيعي تبرره الشروط التاريخية نفسها للخطاب.
كنا أمام قطيعة أصولية لا هوادة فيها أو انتقائية متنكّرة لكل اشتباكات عناصر الواقع وتعقيداته، لكن محاولة د. المصباحي تقع خارج هذا الرهان، هي بنت زمانها الواعي بالباب المسدود. ففي تجربة المصباحي تندك الفجوة التقليدية بين الحداثة وما بعدها، بين الرشدية والأكبرية، منذ البداية اختار الإنصات لمستويات التعقّل.
شخصيا إميل إلى هذا التركيب، فالأنوار مدينة للمخاض السكولاستيكي، الذي يمتد إلى القرن الثالث عشر الميلادي، أي أبعد حتى من القرن السادس عشر عند التحقيق. ازدهرت الأسئلة الكبرى حول علاقة الدين بالدنيوية، تلك الصرامة في جوابات الأنوار فرضتها سلطة الاكليروس، غياب التأويل، المأزق الذي تجاوزها تجربتنا، من حيث أن الصراع بين المدارس حصل مبكرا في بغداد والأندلس، هذا يعني أن الأمة آنذاك لم تجتمع على ضلالة، لأن حروب التأويل استمرت.
جوابات ديكارت وسبينوزا، ما كان لها أن تدهشنا، لأن جزء منها يجري مجرى اللاموضوع في تجربتنا. لكن تستمر وجوه مشتركة من الأزمة. أما د. مصباحي، فلقد تحدث عن ثلاث معضلات، تتعلق بأزمة الدين نفسه، من حيث قضايا النزاع حول فتح باب الاجتهاد، وأزمة السياسة التي تتجلى في إشكالية الديمقراطية، ثم ثمة أزمة العلاقة بينهما. والله هو أمر يتطلب الكثير من النظر.
لكن لا مانع من التأكيد على أن مخاض التجربة الفلسفية الحديثة أظهرت أهمية العودة إلى القرون الوسطى، وأعتقد أن دان سكوت كان أفضل مثال عن تجاوز النظرة التحقيبية التي جعلت الأنوار نبتة مفصولة عن مخاض القرن الوسيط. هيدغر يقدم بحث الاستاذية حول نظرية المقولات عند دان سكوت. إن إلحاحية اتيين جلسون حول ضرورة العودة إلى فلسفة القرون الوسطى، هي رافعة تضعها أمام المتن السينوي والرشدي ونظائره. منذ نيتشه وهيدغر فقدت القرون الوسطى رهاب السيطرة وباتت إمكانية للدراسة برسم التجاوز.
على هذا الأساس تبدو محاولة د.مصباحي مشروعة في هذا التنسيب، يعني أنها محاولة تفتح أفقا لاستمرارية التفكير. والحق، لا شيء انتهى في سؤال النهضة والتنوير، فهو في تجربتنا العربية والإسلامية ظل مشروعا لم ينجز، ومن هنا بدا العنوان إشكاليا، حيث الأنوار تفرض التجاوز. وأمّا المصباحي فهو يرى أنّ هذا القدر من الأنوار وُجد في حقب تاريخية متفاوتة، وهو دائما أمر يمكن استئنافه بطريقة أخرى، بعقل آخر، لكن حذاري من الموقف السلفي.
الحديث هنا ليس في الإمكان، إمكان قيام تنوير إسلامي، لا سيما بعد عودة الديني إلى المجال العام، فهذا بما أنه حدث يوما ما، فيمكن أن يحدث دائما، لكن التفكير اليوم قائم على احتواء الموقف، لفتح جسور لأنوار ممكنة ومرنة ومنفتحة يلتقي فيها الوحياني بخبرة العقل، ليتحقق الرشد، وهو عنوان التنوير، كتلة أنوارية تتكامل فيها كل مستويات تعقل وتعقيل الواقع، ففي نهاية المطاف لا يمكن إقصار الخيال، وهو هنا يأخذ معاني أخرى وجب الحذر منها، كالخرافة والشعودة، أي ما يوجب تعطيل العقل والالتفاف على الواقع.
اشتغل المصباحي منذ سنوات على ابن رشد، كما اشتغل على ابن عربي، كما اشتغل على البيئة المصاحبة للرشدية، وعلى الميراث الفلسفي المشرقي، وهذا المحصول السكولاستيكي سيتمخّض ليلد سؤال استئناف التنوير ومهمّته.
فبالجملة وليس في الجملة – حيث ثمة فروع أخرى للمشكلة- تكمن أهمية هذه المحاولة في تمكين مستويات العقل من الفعل دون إقصاء، الخروج من حالة الجمود التي أنتجتها صرامة الأنوار الكلاسيكية، بحثا عما سميته بالبحث عن الإمكان الإسلامي والإمكان الحداثي، خارج أحكام قيمة التي ينتجها الموقف المتطرف من كليهما.
بهذا يمكن اعتبار هذه المحاولة رهانا على تنوير إسلامي ممكن في شروط متجددة، وخارج المقولات الصلبة النافية لمستويات تعقل الواقع، وهو ما يجعل مهمّة الفيلسوف تتجاوز لعبة الكاطيغورياس لتصبح أفقا للتفكير، والأمل.
وقف د.مصباحي عند الحل الذي يقترح الإسلام السياسي، وهو يبدو حلول مغالطة مسنودة بمفهمات أذكتها ما بعد الحداثة. التفاف على الواقع. غير أن الأمر هنا إشكالي بامتياز. ففي نظري مسألة العقلانية في أنماط ومستوياتها، ليس مسألة خاضعة للكاطيغورياس، بل ثمة شروط اجتماعية وتاريخية مفتوحة، تجعل العقل في نمو مستدام.
والحق، هو أن تجارب الإسلام السياسي تخلوا حتى من عقل الفقهاء، لأنها تجارب دعاة، ولأنها لا زالت تتهيب من وضع العقل مدركه الأساسي، لا زالت تستثمر على العقل ان يكون أصلا من أصول التشريع، ولا زالت تستثمر عليه التحسين والتقبيح.
وهي تدخل زمان الحجاج حول القضايا المعاصرة بأزمة الأسس المزمنة. لا هم فقهاء على نصيب وافر من العقلانية التقنية للفقيه، ولا هم علمانيون، إنما هي وضعية رمادية أتاحت لها موجة مابعد الحداثة مفاهيم تجاوزية زائفة. فالعقلانية المتجاوزة هنا هي انفتاح على آخر _ العقل (l’autre de la raison)، أي توسيعا لمدارك العقل وليس نفيا لحجيته. سؤال التنوير هو أكثر تعقيدا من أن يجد جوابه في الإسلام السياسي، حيث فقد مهارته السكولاستيكية وفقد أيضا استيعابه لأزمته المعاصرة.
هنا بالفعل تلعب الأيديولوجيا وظيفتها الارتكاسية، فيصبح سؤال التنوير أكثر إلحاحية من أي وقت مضى. يذكر د.مصباحي بأن هناك أزمنة متعددة، زمن القرون الوسطى وزمن الحداثة، زمن الوحي وزمن الطبيعة، لكن يبدو لي أن الإسلام السياسي عندنا بات بلا زمن، ليس له وفاء لا لزمن القدامة ولا لزمن الحداثة.