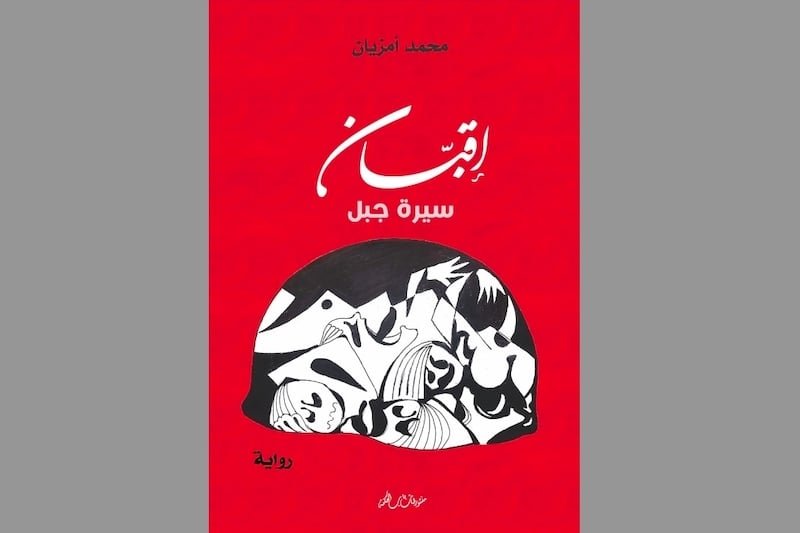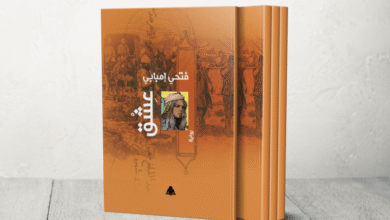محمد أمرنيس
صدر عن باب الحكمة سنة 2025 رواية جديرة بالاهتمام معنونة ب “إقبان سيرة جبل” لصاحبها محمد أمزيان، بعدد صفحات يتجاوز الثلاثمائة.
يستعرض فيها صاحبها أحداثا وقعت في الماضي، منذ ما ينيف عن مئة سنة، بحس نقدي متزن، وبلغة إبداعية موزونة. وقد قسمها إلى خمسة فصول بداية بـ “عودة” ثم “ألميريا مرة أخرى” و “اتركوني يا قوم” ثم “على طرفي نقيض، نهاية ب “طريق الآلام”.
رواية إقبان سيرة جبل تاريخ أم خيال؟
إن كل رواية تاريخية تقوم في الأساس على مرجعيتين: أولًا: مرجعية حقيقية متصلة بالحدث التاريخي، والتي تفرض على الكاتب الأمانة التاريخية في نقل الحدث كما هو متعارف عليه في الأدبيات التاريخية.
وثانيًا: المرجعية التخيلية الروائية، التي يستدعيها الكاتب من أجل إضفاء مسحة جمالية. تلعب كلتا المرجعيتين دورًا هامًا في المنتج الأدبي، وتمنحه روحًا ونَفَسًا إبداعيًا فريدًا، لكن بشرط ألا يتم تغليب جانب على آخر.
كثيرًا ما ينساق الكاتب وراء الحدث التاريخي، وينسى أن عمله روائي بالأساس، فتجده ينسج حكاية أشبه بما يكتبه المؤرخون لغةً ومضمونًا، في حين أن عمله يقتضي تأنقًا فنيًا، وفرادَةً إبداعية تنقل العمل من التاريخ ومن الرواية إلى مجال الرواية التاريخية.
في هذا الصدد، يأتي منتج “محمد أمزيان”، فهو وإن كان يتحدث عن فترة زمنية محددة، وعن أحداث وقعت في الماضي في مجال معين، إلا أنه أضفى على عمله الجانب التخيلي الإبداعي، ونسج حكايته بالمرجعيتين التاريخية والتخيلية.
فرغم أن مجمل الحديث دار حول انتفاضة 1958 بمنطقة الريف، إلا أن السرد سار في منحنيات أخرى، بين روابي الحب ومتاهات العشق..
بين ذاكرة مثخنة بالجراح، وواقع ما ينفك يزيد الكدمات. لم تكن الانتفاضة وحدها محور الحديث، بل كان ماضي الروبيو، أو بالأحرى “ذاكرة الروبيو”، وجنون ماريا.
كانت الأماكن والشخصيات. كانت البنية الذهنية والاجتماعية والثقافية. تقاطع في العمل الواقع والخيال؛ ما جرى وما لم يجرِ؛ ما كان وما لم يكن؛ ما كان ولم تتحدث عنه كتب التاريخ، وما تم الحديث عنه ونقله بشكل خاطئ وكاذب.
تكمن الصعوبة من وجهة نظرنا في كون كاتب الرواية التاريخية يتعامل مع شخصيات جاهزة لها حضورها وصفاتها وصيرورتها التاريخية، وهذا ما يجعل الروائي مقيدًا بشكل أو بآخر بقالب جاهز، يُرغمه على نسج حكايته وفق المادة التاريخية، عكس الروائي الذي يستدعي شخوص عمله من المخيلة.
لكن المفارقة هي أن محمد أمزيان التزم بكلتا المرجعيتين، لدرجة أننا قد نتوه بين الواقع والخيال.. بين ما كان وما تم إقحامه عنوة.
عذاب الذاكرة
استند محمد أمزيان في كتابة أحداث الرواية التاريخية إلى الذاكرة، باعتباره ابن قائد وزعيم الانتفاضة، إضافة إلى “أوراق الانتفاضة” التي أشار إليها في مجموعة من المواضيع.
ورغم أن الذاكرة والتاريخ مفهومان يحيلان إلى نفس الدور، وهو استعادة الماضي، إلا أن دلالتهما مختلفة: “فالأول عبارة عن تمثلات الماضي مشوبة بالعاطفة والأيديولوجيا والانتقائية والرهانات الفردية والجماعية؛ أما الثاني، فيدل على دراسة ذلك الماضي وفق مناهج علمية وقواعد عقلانية ومهنية”.
(عبد العزيز الطاهري، الذاكرة والتاريخ في مغرب الزمن القريب والراهن، مجلة أسطور، العدد 21، يوليوز، 2024، ص 121) واعتبارًا إلى أن الذاكرة أصبحت موضوعًا من مواضيع التاريخ، استثمر الكاتب ذاكرته لكتابة فصل مهم من فصول الانتفاضة، رغم أن الحديث ليس كله واقعًا بالضرورة.
لن ندخل في إشكالية “من يملك الأحقية” باعتبار أن الذاكرة والتاريخ يدعيان أنهما يملكان الحقيقة. لكن لا بد من استثمار الذاكرة على الأقل من أجل ملء الفراغات التي تركها المؤرخون، ومن أجل سد الثغرات التي صال فيها البعض وجال دون أي حق.
وبالنسبة للروبيو فالذاكرة سجنه الكبير، تطوقه من كل جانب ولا تترك له مجالًا للنسيان. هل تنسى الذاكرة ما حفره الدهر؟
لم ينسَ الروبيو الماضي، بل كان مثقلًا به، غارقًا فيه. لكنه لم يكن أيضًا يبحث عن النسيان: “ليس الهدف أن نعثر على إجابات تداوي جراحاتنا أو تطفئ نيران الغضب في أعماقنا، بل التحرر من خطيئة التساؤل ذاته؛ أي أن نتجاوز دون أن ننسى”.
(ص 116) كان متصالحًا مع عذابه، لا يفتش عن الترياق ليتشافى. وكان التجاوز بالنسبة له هو السبيل. “التجاوز هو مصالحة مع الذات أولًا وقبل كل شيء؛ اعتراف بأن الآلام جزء لا يتجزأ من وجودنا الإنساني.
قد يكون كذلك نوعًا من القبول والرضا، مصالحة عقلانية مع ذلك الماضي بأفراحه العابرة وجراحاته النازفة.
لكن الرضا هنا ليس هروبًا أو عجزًا، بل هو إدراك وإرادة تسعى للفهم. ألم يقل السلف: الحياة مدرسة؟ فالماضي هو جزء من هذه الحياة، جزء من هذه المدرسة التي نتعلم فيها معنى أن نكون.. أو لا نكون”. (ص 115).
كان الروبيو يصارع ذاكرته، يتوهم بأنه نسي الماضي، لكنه يجد نفسه يكتوي مرة أخرى بلعنة الماضي. هذا الاقتباس يلخص الفكرة: “لطالما توهمت أنني تخلصت من هذا الماضي. قتلته ألف مرة وأنا أقاتل “الروخوس” أو أصارع الكوابيس في بار فرناندو.
لكنني لم أجرؤ على دفنه. من الصعب أن تدفن قطعة منك، حتى ولو كانت بلا روح. تقول لغة العرب: “أنفك منك ولو كان أذى”.. هكذا حالي تمامًا.
ماريا: حب بذاكرة مثقلة بالجراح
كان لماريا دور محوري في الرواية. فهي وإن عاشت لحظات عصيبة، مبهمة مليئة بالفجوات (ص 17) إلا أنها استطاعت برقتها وحنانها أن تنتشل الروبيو من مستنقع التيه والضياع الذي كان يعيش فيه.
وإن كنا في الحقيقة نتحدث عن مستنقعين؛ واحد يغرقه في ماضيه الأليم، والثاني، يمزق أواصر حاضره ومستقبله.
نحيل أولًا القارئ إلى ضرورة قراءة الجزء الأول المعنون بـ (أوراق الخزامى) ليفهم سيرورة الأحداث، لأننا لن نعيد الحديث عن القصة من الأول.
أحبت ماريا ريفيًا، والريفي في العادة لا يجامل (ص 19) لكنها تمكنت من نسف جزء مهم من بنية الروبيو الذهنية، وجعلته يتخلى برغبته عن طباعه الشرسة، وعن تكتمه المرهق للذاكرة، حتى أصبح يغازلها بكل جرأة “أنت نجمي الذي يهديني في صحراء ضلالي.
أنت شمسي التي لم تغب مذ أنارت سواد عواطفي”. (ص 25). وأصبح “مصيرهم واحدًا” (ص 20). كانت مدركة لمعاناته، تعرف أنه ينزف “كما الجرح المفتوح” (ص 24)، لكنها لم تستسلم للواقع، بل بحثت معه عن وسيلة لتنتشله من “الدوامة المظلمة” التي يعيش فيها. كان يستمد منها القوة “لتجاوز البلية” (ص 27).
كانت ماريا “رهيفة مثل جناحي فراشة، كائن سريع الاحتراق” (ص 28) وفي المقابل كان الروبيو كائنًا متناقضًا، يجمع ما بين الضدين: يجمع ما بين النور والظلام، بين الحب والعذاب.
إن دور ماريا في حياة الروبيو يشبه دور الثقب الأسود الذي يحتوي كل قطرة تعب وندم وحيرة وشك في حياة الروبيو. يشبه دور الأم والأرض، التي يتعلق بها المرء وهو مدرك أنها ستحتويه.
الريف في معترك التاريخ، حرب مع الوجود
كان الريفيون دائمًا في صراع مع الآخر، وأحيانًا مع بعضهم البعض، وقد كان لهذا الصراع مظاهر مختلفة. أحيانًا كان نتاجًا لطباعهم الشرسة، وأحيانًا نتيجة سوء فهم! وهو ما يجعل الكثيرين يشعرون بأنهم يحملون “لعنة أزلية على ظهورهم، ووزر أخطاء لم يرتكبوها.” (ص 43).
لم يستطع المخزن كبح جماح الريفيين، ولم يستطع أيضًا أن يسيطر عليهم أو يفرض عليهم رغبته. كانوا يسيرون شؤونهم الداخلية بمجالسهم، ويحتكمون إلى أعرافهم فيما يحدث بينهم من مناكفات.
لم يكن للمخزن دور إيجابي في حياتهم، ذاكرتهم مرتبطة بجوره وتعسفه فقط، لأنه لم يكن يتدخل إلا في اللحظات العصيبة.
حدث مثلًا في مأساة بقيوة في نهاية القرن التاسع عشر، وحدث أيضًا في انتفاضة 1958 التي يتحدث عنها المؤلف. وحدث بعدها في الكثير من المرات. أصبحت ذاكرة الريفيين تجاه المخزن مرتبطة بالصراع أكثر من أي شيء آخر.
إن كانت مأساة بقيوة مرتبطة بالقرصنة البحرية، فإن الانتفاضة كانت نتيجة سوء فهم مقصود! “ما يحزن النفس ويعمق سوء الفهم، هو الخلط المتعمد للأوراق. انتفاضتنا واضحة الأهداف والمطالب”. (ص 46).
لكن هل نكتفي بلعب دور الضحية؟ بإلقاء اللوم على الآخر؟ ربما لم نحسن قراءة التاريخ ولا قراءة الواقع!
لم يكتفِ المؤلف بإلقاء اللوم على الآخر، كما يفعل الناس عادة، بل تجاوز الأمر إلى جلد الذات: “ما جدوى أن تحلم في مجتمع عيناه في قفاه؟” (ص 58) “لطالما نصحني بأن أبتعد عن الريفيين، لأنهم لا يرحمون.
يحتقرون الضعيف، يتغامزون على العاقل، ويعتبرونه بليدًا لا يفهم مقالب الحياة، أو مغفلًا يسهل التلاعب به وخداعه. الريفيون يا صديقي يعشقون الضباع النهاشة، يحترمون القوي المتسلط، صاحب السلطة، حتى لو كان جبارًا طاغية.” (ص 59) كان المجتمع الريفي مخطئًا أيضًا، لكن هل كان يستحق ما حدث؟ ألم يكن الأجدر بمن يتحملون مسؤولية الحكم أن يظهروا بعض التفهم لهذا الغضب المتأجج؟ “الريفيون حَديون بشكل مرعب، عنيدون، ضيقو الصدر كشعاب الوادي الذي احتشدوا فيه. تغلي في دواخلهم رغبة عارمة للمواجهة، ويسكنهم توجس مرضي من الآخر. (ص 73)..
لقد حاول السي امحمذ أن يوصل صوته وصوت الريفيين لكن كان من الصعب “أن توصل صوتك لمن لا يريد أن يسمع”.
من محاسن هذا العمل، هو إعادة الاعتبار لشخصية لم تنل قدرًا كافيًا من الاحترام والاعتراف. قائد الانتفاضة كان ذكيًا وسط قوم لا يفقهون، سلميًا وسط قوم مندفعين، قائدًا شجاعًا أمام مخزن لا يحب القيادات.
جاءت الانتفاضة في فترة حرجة، وسط فوضى مغرب ما بعد الحماية. كان حزب الاستقلال يسعى إلى الانفراد بالحكم محتكمًا إلى بطولاته السابقة، وكان القصر يسعى جاهدًا إلى احتكار الكلمة العليا، من خلال التدخل في كل شيء.
ثم أيضًا مسألة التخلص من جيش التحرير وما أعقبه من دسائس ماكرة. كان العقاب قادمًا لا محالة لأحد الأطراف، لكن المخزن اختار معاقبة الريف، بذريعة تدخل أطراف خارجية. احتكم المخزن إلى لغة القوة حين استشعر الخطر من البيئة المحيطة، لكنه أخطأ الهدف.
كان الحوار مفيدًا، لرتق الصدع، ولَمِّ الشمل، لكنهم أضاعوا الفرصة.
يبق أن نشير إلى جمال لغة محمد أمزيان السلسة، وأسلوبه الرقيق الجذاب، وطريقته في إيصال الفكرة. إنه يعرف كيف يولد المعنى من الجبال الصماء، وبستخرج البهاء والنقاء من أرض ملوثة. والأكيد أن الرواية تستحق كل التنويه والإطراء، ليس كرما زائدا، ولا تنويها مغشوشا، بل هو تقدير مستحق بجدارة.
في النهاية يفضح القلم ما تم السكوت عنه، ولو بعد حين.
أنهي هذه القراءة بهذا الاقتباس الجميل:
“القلم.. ذلك الشاهد الذي لا يموت. هو نبض الشعوب إن داعبته العقول النيرة، والقلوب الحية. هو الحارس الأمين لصرخات المظلومين، وصوت الأمل في متاهات الظلام. لكنه، في يد التافهين، يتحول إلى أداة قتل للروح والأمل، إلى سلاح يغتصب براءة المعرفة. يمجد الزيف على حساب الحقيقة”. (ص 293).