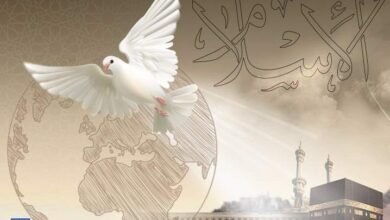معلوم أن الثقافة والحضارة الأمازيغية ليست مرتبطة بالتقويم الأمازيغي فقط، الذي بلغ 2975 سنة، والذي هو بدوره مرتبط بتاريخ صعود فرعون مصر شيشنق الأول لعرش مصر سنة 950 قبل الميلاد. وللإشارة، فهو أمازيغي من أصول ليبية، ويمثل أبهى فترات التطور والقوة والازدهار في شمال أفريقيا عمومًا.
ويعتبر هذا التاريخ أيضًا (12 أو 13 يناير حسب دول شمال أفريقيا) دلالة على ارتباط الأمازيغ بالأرض والزراعة والفلاحة، كونه يتزامن مع رأس السنة الفلاحية. إضافة إلى ذلك، فهو يتزامن مع فترة الليالي السود، التي تتسم بانخفاض حاد في درجات الحرارة وبداية التساقطات المطرية الوفيرة. وبالتالي، فهو تشكيل بين الثقافة، والفلاحة، والمناخ.
بل إن الثقافة والحضارة الأمازيغية متجذرة في عمق التاريخ، حتى قبل هذا التقويم الذي تم توثيقه. وبالعودة إلى بعض المحطات العلمية الحديثة، يمكن الجزم بأن الأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا من مصر إلى المغرب الأقصى، حيث تؤكد الدراسات الأثرية والجينية ذلك.
وهذا ما تدعمه الاكتشافات الأثرية، مثل مقبرة تافوغالت في المغرب، التي تعود إلى حوالي 15 ألف عام، وتُعدّ من أقدم المقابر البشرية المكتشفة. إضافة إلى ذلك، تم العثور على حُليّ من قواقع بحرية يعود عمرها إلى 150 ألف عام، في مغارة قرب الصويرة (موكادور)، مما يعكس الوعي الثقافي والرمزية لدى الإنسان الأمازيغي القديم. ولعل اكتشاف أقدم جمجمة لإنسان عاقل في أدرار ن إيغود بالمغرب، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 ألف عام، يعيد صياغة فهمنا لتاريخ البشرية، ويؤكد هذه النظرية التاريخية.
وبالتعريج على المغرب، نجد أن الأمازيغ ساهموا بشكل كبير في تشكيل الحضارة المغربية الحديثة، عندما احتضنوا المولى إدريس الأول وفتحوا له ولعائلته الأبواب الجغرافية للمغرب الأقصى، وزوجوه منهم، واعتنقوا الإسلام، وشيدوا دولة الأدارسة جنبًا إلى جنب معه. وكان لهم دور بارز في باقي الدول المؤسسة في المغرب من مرابطين وموحدين وغيرها، حيث برز منهم قادة خلدهم التاريخ مثل طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين وغيرهم.
التأثير المتبادل بين الأمازيغ والعرب داخل الرقعة الجغرافية المغربية بصم على تنوع ثقافي وزخم حضاري كبير أغنى الإرث الحضاري والثقافي للأمة المغربية على اختلاف روافدها. حيث نجد البعد الأمازيغي حاضرًا لدى كل سلالات الملوك المغاربة، إلى أن تم التنصيص على قانونيته في العهد الجديد للمغرب على يد العاهل المغربي محمد السادس.
فبعدما تم الإعلان عن قرار إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في خطاب العرش لسنة 2001، جاء الخطاب الملكي الشهير في 17 أكتوبر 2001 بأجدير، مدينة خنيفرة، ليشكل لحظة تاريخية تم فيها التوقيع الشريف على ظهير إحداث هذا المعهد الذي يُعنى بالشؤون الأمازيغية.
وأكد خلاله الملك أن الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية الوطنية للمغرب، منصهرة ومنسجمة مع باقي الروافد الثقافية، في تناغم مع ثوابت الأمة، رغم محاولات المستعمر إصدار الظهير البربري سنة 1930 لتفريق المغاربة على أساس العرق وإضعاف شوكتهم في مواجهة الاحتلال الفرنسي. هذا الأخير سعى إلى تقسيم المغرب بين مناطق يسود فيها الحكم العرفي، وإخراجها من نظام المخزن التابع للسلطان، واحتكامها للمحاكم العرفية.
تلت هذه المبادرة الملكية عدة مبادرات أخرى ساهمت في تكريس الأمازيغية كعنصر مهم من عناصر الأمة المغربية. من بين هذه المبادرات: الاعتراف الرسمي بحرف تيفيناغ (ⵣ) كحرف رسمي للكتابة الأمازيغية سنة 2003، والبدء في تدريسها في بعض المدارس العمومية، والانفتاح الإعلامي على الثقافة الأمازيغية من خلال إطلاق أول قناة تلفزيونية عمومية تحمل اسم “القناة الأمازيغية” سنة 2010.
ثم جاء دستور 2011 الذي يُعد نقطة تحول، حيث تم الاعتراف بالأمازيغية كأحد مقومات الهوية الوطنية. ونصّ الفصل الخامس من الدستور على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، داعيًا إلى إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة. وكان آخر ما قامت به الدولة المغربية في الاهتمام بالأمازيغية هو إقرار فاتح السنة الأمازيغية، 14 يناير، كعطلة سنوية رسمية مؤدى عنها.
رغم محاولات فاشلة من بعض القوميين من كلا الجانبين للتفريق بين العرب والأمازيغ داخل المجتمع المغربي، وركوب قضايا أمازيغية لتحقيق أهداف سياسية، إلا أن الوعي المجتمعي المتنامي بين الأفراد أجهض كل تلك المحاولات.
هذا التعاون بين الإرادة الملكية، التي ما فتئت تسعى إلى اندماج كل مكونات المجتمع وانصهارها في مقومات وثوابت الدولة، جعل اللغة والتعابير الثقافية أبرز تجليات هذا الانصهار الثقافي. فالدارجة المغربية تمثل مزيجًا لغويًا بين العربية والأمازيغية، والأمثال الشعبية تنهل من المنبعين معًا وتمزج بينهما.
إضافة إلى ذلك، تعكس الأعراس المغربية مزيجًا من اللمسة العربية والأمازيغية في نفس المناسبة، كما تزخر الاحتفالات والمواسم الثقافية بمظاهر هذا التنوع. أما الطبخ المغربي، فيجمع بين الذوق الأمازيغي والعربي في كثير من الأطباق، فيما يُظهر العامل الفني والموسيقي تداخل الموروث الثقافي والفني. ولم تغب العمارة عن هذا المشهد، إذ تدهش المشاهد بإبداع الفن المعماري العربي والأمازيغي من خلال القصور والبنايات التاريخية التي تحمل في طياتها الأثرين معًا.
إن المجتمعات، بصفة عامة، والمجتمع المغربي على وجه الخصوص، تجاوز عقبة التفرقة على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو أي معيار آخر، وجعلت “تامغرابيت” وحدها مقياس الانتماء الوطني. لقد كُرّس هذا المفهوم كمبدأ للمشاركة في التنمية وتطور المجتمع والدولة، ووسيلة لتخطي العراقيل التي قد تحد من تقدم الأمة.
إن التعدد الثقافي والحضاري، الذي كان في عدة تجارب دولية سببًا لفشل الدول وانهيارها، يستفيد منه المغرب بشكل إيجابي، حيث اعتمد مفهوم “التعدد المغني للوحدة”. فجعل كل رافد ثقافي مساهمًا في بناء الدولة والمجتمع، وحجر أساس في البناء الديمقراطي والاقتصادي والثقافي دون تمييز أو إقصاء. وهذا ما يميز التجربة المغربية، ويجعلها قادرة على تجاوز العقبات التي قد تواجه مسارها التنموي.
ختامًا، في صراع الحضارات، لا يوجد منهزم أو منتصر، بل إن الجميع خاسرون. هذا ما فطن له المغرب، حيث لم يجعل الأمر معركة حضارية أو ثقافية، بل جعل كل ثقافة في خدمة الأخرى، ناقلة لها ومسوّقة لامتيازاتها، ليَستفيد العربي من الأمازيغي، والصحراوي من الأندلسي، في تفاعل تبادلي بين كل الثقافات.