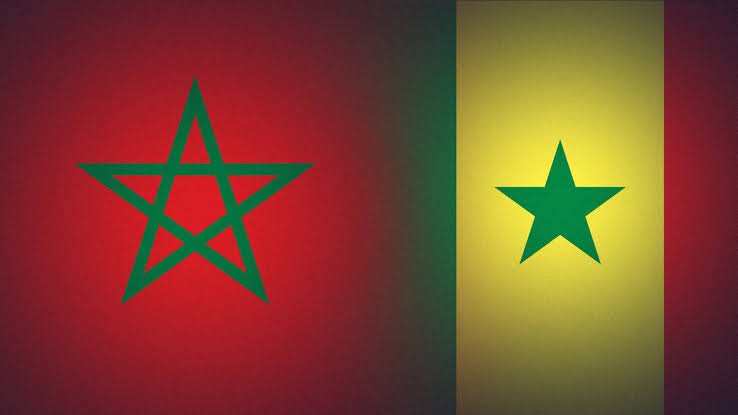لا أحد منا ينازع في متانة العلاقات التي تربط المملكة المغربية الشريفة بشقيقتها الجمهورية السنغالية. هذه العلاقات ليست وليدة الأمس، ولا وليدة هذا القرن الذي نحن فيه، ولا حتى ما قبله، فهي ضاربة ومتجذرة في القدم، وعلى مرّ السلالات التي تعاقبت على حكم هذه المملكة، وإلى يومنا هذا.
علاقات متنوّعة تجاوزت كل الأبعاد والحسابات السياسية إلى ما هو أعمق، وغير قابل للتأثر بالمتغيرات أياً كانت طبيعتها وحجمها. وأياً كانت الإكراهات أو الضغوطات من الداخل أو الخارج، فإن هذه العلاقات تظل في نظافتها ونقاوتها في منأى، وعصيّة على أي عبث طارئ أو أي عبث مُدبّر.
ولفهم استثنائية هذه العلاقات، لا بد من التأكيد على أن ما فعله البعد الروحي في متانتها وصلابتها لم تفعله السياسة ولا غيرها. فعلى مرّ القرون التي خلت، كان الفضل كبيراً للمملكة الشريفة في نشر الإسلام والمذهب المالكي في مختلف ربوع إفريقيا الغربية، وكانت أرض السنغال من أكثر المناطق التي أنارها الإسلام على يد علماء وفقهاء مغاربة، أوعز لهم سلاطين وملوك المغرب بمرافقة القوافل التجارية لتبليغ الدعوة وتعليم الناس في تلك الربوع أصول هذا الدين الحنيف.
وقد اكتسبت هذه الدعوة زخماً كبيراً مع حركة المرابطين في القرن الحادي عشر، خاصة في مناطق السنغال ومالي ونيجيريا، عبر التجار والدعاة.
ولعبت الزوايا الصوفية المغربية دوراً محورياً في نشر المذهب المالكي بغرب إفريقيا، حيث ساهمت مراكز العلم والتصوف في التعليم الديني والتربية الروحية عبر الطرق الصوفية.
هذه الدبلوماسية الروحية أسست للتصوف السني المعتدل كإطار مرجعي ثابت، وحافظت على الهوية الإسلامية في المنطقة عبر قرون وإلى يومنا هذا.
كما أسست الزوايا الصوفية مدارس ومحاضر لتعليم الفقه المالكي والتفسير والحديث، مع التركيز على العقيدة الأشعرية، وتخريج علماء ورجال دين نشروا هذه العلوم في عمق إفريقيا.
ومن أبرز تلك الزوايا المغربية نجد:
أولاً، الزاوية التيجانية التي انتشرت بقوة في السنغال ومالي والنيجر، ولعبت دوراً في التقارب بين المذاهب.
ثانياً، الزاوية القادرية التي وصلت إلى حوض النيجر.
ثالثاً، زوايا الصحراء (الرقيبية والعروسية)، حيث كانت بمثابة جسور بين المغرب والمناطق الجنوبية، تنشر العلم وتساعد على توفير الأمن الروحي.
هذا الأمن الروحي لعب دوراً لا يشق له غبار في تأمين العلاقات الروحية وتحصينها بين المملكة الشريفة ودول غرب إفريقيا، وعلى رأسها السنغال ومالي والنيجر.
وانعكس هذا الارتباط الروحي بشكل جلي في مساجد تلك البلدان، حيث ما زالت إلى يومنا هذا تُرفع الدعوات لملك المغرب، الذي يُنظر إليه في تلك الدول كأمير للمؤمنين، على غرار تلك الدعوات التي تُرفع كل يوم جمعة في المساجد المغربية.
أتباع هذه الزوايا، وبالخصوص الزاوية التيجانية، وبحكم ارتباطهم الروحي بالمملكة المغربية الشريفة، يحجون مرة كل عام إلى مدينة فاس، حيث يرقد سيدي أحمد التيجاني بعد أن وافته المنية يوم الخميس السابع عشر من شوال من عام 1230 هجرية.
وهي مناسبة دينية يلتقي فيها أتباع هذه الزاوية قادمين من كل فج عميق. وما زال هؤلاء الأتباع يتلقون الهبات الملكية، بالإضافة إلى بناء مساجد جديدة، وتأثيثها، وتزويدها بالمصاحف القرآنية المكتوبة برواية ورش وبالخط المغربي.
ولكن هذا السرد الموجز للمقومات التي بُنيت عليها العلاقات المغربية السنغالية، والتي لا يمكن إلا أن نعتز ونفخر بها، كما يتعين على السنغاليين أنفسهم أن يفخروا بها هم الآخرون، يبقى من المهم أيضاً، وفوق كل ذلك، التركيز على كيفية صون هذه العلاقات من أي عبث، وما أكثر المتربصين في هذه الأيام بتلك العلاقات، والذين يحاولون النيل منها من أي ثقب يريدون التسلل منه.
ومادامت النوايا سيئة عند بعض المتربصين، فإن هؤلاء كانوا في الأصل على نية مبيّتة ضد هذا العرس الإفريقي الذي أثث له المغرب كل مقومات التميز والنجاح، فإذا بيد الغدر تمتد لتريده أن يتحول إلى ملتقى رياضي فاشل.
لقد حاولوا ذلك بعد خروجهم من دور ربع النهائي، لكن محاولتهم باءت بالفشل، لأن المغرب كان على علم مسبق بمخططاتهم الشيطانية، وعرف كيف يتصدى لهم.
لكن مرة أخرى شاءت الأقدار أن يتسلل المتربصون إلى من هم أقرب إلينا في الأخوة، ليعلنوا حرباً بالوكالة على المغرب، مستخدمين، بكل أسف، ذلك البعض الذي باع ضميره فوق أرضية الملعب من أشقائنا في السنغال.
فما حدث في مباراة النهائي لكرة القدم لا يمثل الشعب السنغالي، الذي هو عاشق للمغرب، كما لا يمكن لتلك الأحداث أن تؤثر على عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين أو البلدين.
هذا هو الثابت في العلاقات، وهذا هو الذي يفترض فيه أن يستمر. لكن ما ينبغي على الجميع أن يدركه أن الأصل في بناء العلاقات بين البلدين الشقيقين يعكس حرص الطرفين على إقامتها، كما يجب أن يعكس حرص الطرفين على الحفاظ عليها.
وحينما يستجد طارئ، يجب على الطرفين معالجة تلك الشوائب في حينه، للإبقاء على صفاوة وطهارة تلك العلاقات، وقطع الطريق إلى ما لا نهاية أمام من يحاول تعكير صفوها.
وهذا أمر ضروري، فلن يكون المغرب هو المطالب الوحيد بإعادة المياه إلى مجاريها، كما لا ينبغي أن يظهر بمظهر المتودد أو المتسول للإبقاء على تلك العلاقات. فالعلاقات بين الدول مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين، وحرص المغرب لا ينبغي أن يكون أكثر من حرص الأشقاء في السنغال.
الواقعة التي أمامنا اليوم لا تعدو أن تكون سوى واقعة رياضية. وبالرغم من محدوديتها على أرضية الملعب، فإننا لا نريد أن نملي على أشقائنا ما ينبغي أن يفعلوه في تحديد ملابسات هذه النازلة، وإلا كان ذلك تدخلاً من جانب المغرب. فالسنغال، إن كانت تبدي الاحترام للمغرب كما يبديه لها، فهي اليوم مدعوة لتوضيح الموقف، لا لترك الحبل على الغارب.
فجميع المغاربة ينتظرون اليوم من هذا البلد الشقيق إنزال أشد العقوبات بمن كان وراء التحريض، وبمن كان وراء هذه الفتنة، وكيف حصلت هذه الفتنة، وكيف تم زرع بعض المتربصين في الطاقم التقني للمنتخب السنغالي. أسئلة عديدة وغامضة يجب فتح تحقيق في شأنها. فهل الأشقاء السنغاليون على أتم الاستعداد؟
وكعربون عن حسن النوايا، نقول رغم ذلك: عاشت العلاقات المغربية السنغالية.