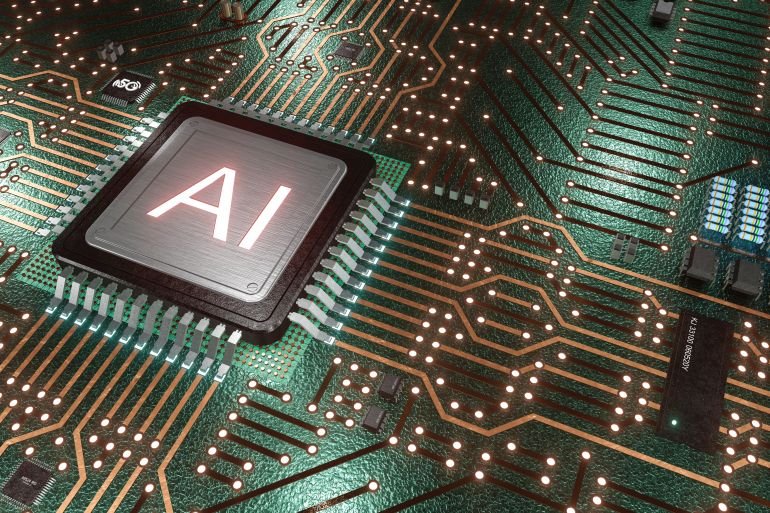لنتخيل معًا مباراة في دوري الأبطال بين ريال مدريد وفريق كاتيانا المتواضع (وكاتيانا فريق إيطالي يلعب في الدرجة الثالثة )، صافرة البداية تُطلق، فينطلق الفريق الإسباني بعدد لا يحصى من التمريرات المحكمة، والجمهور بالكاد يلحظ أن الفريق الآخر ما زال يبحث عن حذاءه المفقود في غرفة الملابس.
(ملحوظة: كلمة كاتيان في اللغة العامية الدارجة في بعض الدول العربية تدل على الضعف الشديد)
هذه الصورة تختصر الفجوة بين إسرائيل والعرب في الذكاء الاصطناعي: الأولى استثمرت مليارات الدولارات، صنعت آلاف الشركات الناشئة، ودفعت التكنولوجيا لتكون العمود الفقري لاقتصادها؛ أما الثانية فما زالت غارقة في استهلاك برمجيات الغير، أو تعقد مؤتمرات بلا مردود حقيقي. في الملعب كما في مختبرات الذكاء الاصطناعي، المباراة محسومة قبل أن تبدأ! .
لمحة واقعية: لماذا يتفوّقون علينا؟
إن “إسرائيل” تبدو اليوم وكأنها عملاق في صناعة الذكاء الاصطناعي، لا لأنها تمتلك عصاً سحرية، بل لأنها عرفت من أين تؤكل الكتف. يكفي أن نبدأ من الاستثمار في البحث والتطوير لندرك حجم الفجوة.
ففي عام 2022 خصّصت إسرائيل نحو 6% من ناتجها المحلي لهذا القطاع، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هذا الاستثمار ليس مجرد رفاهية، بل هو الوقود الحقيقي الذي يغذّي المختبرات ويحوّل الأفكار إلى صناعات متينة، بينما كثير من الدول العربية ما تزال ترى البحث العلمي ترفاً يمكن الاستغناء عنه عند أول عجز في الميزانية.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن القطاع التكنولوجي الإسرائيلي أصبح عصباً أساسياً للاقتصاد، إذ يشكّل قرابة 20% من الناتج المحلي، ويحتضن آلاف الشركات الناشئة وعشرات الآلاف من العاملين في مجالات البرمجة والابتكار.
بهذا المعنى، فإن التكنولوجيا ليست مجرد قطاع ثانوي بل أصبحت العمود الفقري الذي يربط الاقتصاد المحلي بشبكات الاستثمار الدولية.
على الصعيد المؤسسي، تُظهر التقارير أن إسرائيل لم تترك الأمر للمصادفات، بل وضعت سياسات واضحة وهيأت مؤسساتها لتبنّي الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والإدارة الحكومية. في المقابل، لا تزال دول عربية كثيرة تتبنى البيروقراطية التي تلتهم الطموحات قبل أن ترى النور.
وحين ننظر إلى الابتكار والملكية الفكرية نجد أن إسرائيل تحجز لنفسها مكاناً متقدماً في ساحة براءات الاختراع، لا سيما في الذكاء التوليدي. وترصد منظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO) تزايداً هائلاً في هذه البراءات خلال العقد الأخير، بينما الآخرون يكتفون بالتصفيق أو إعادة استهلاك ما ينتجه غيرهم.
خطة عمل ذكية وواقعية لتمكين العالم العربي في الذكاء الاصطناعي
إذا أردنا أن نخطو خطوة عملية في مجال الذكاء الاصطناعي، فعلينا أن نتحرّك وفق خطة متماسكة لا تترك مكاناً للشعارات الفضفاضة. الخطة ليست معجزة، بل سلسلة من خطوات بسيطة وقابلة للتنفيذ إذا ما توافرت الإرادة السياسية والرغبة المجتمعية.
البداية لا بد أن تكون من المال الموجَّه، والمطلوب رفع الإنفاق على البحث والتطوير تدريجياً، مع إنشاء صندوق مخصص لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي. هذا الصندوق يمكن أن يُغذَّى عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب حوافز ضريبية للشركات التي تُموّل أبحاثاً محلية أو تتبنى مشروعات جامعية واعدة.
ثم تأتي الخطوة الثانية: استعادة العقول المهاجرة فكم من باحث عربي يقود اليوم فرقاً في مختبرات أوروبية؟ هؤلاء يمكن إعادتهم عبر برامج «عودة المواهب» التي تقدم رواتب تحفيزية مستدامة.
النفط الجديد
لا يمكن أن نتحدث عن ذكاء اصطناعي بلا بنية بيانات وطنية فالبيانات هي النفط الجديد، لكنها بلا قيمة إذا بقيت مبعثرة. المطلوب إنشاء منصات وطنية مفتوحة وآمنة، منظّمة بمعايير الخصوصية والشرعية، ليتمكن الباحثون من تدريب نماذج محلية بكلفة أقل وبجودة أعلى.
من جهة أخرى، لا بد من ثورة تعليمية تعيد صياغة المناهج من الصفوف الأولى حتى الجامعة، بحيث يتعلم الطلاب منذ الصغر مفاهيم هندسة البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وهندسة برمجياته. وإلى جانب ذلك، ينبغي فتح برامج تدريب مهني مكثف لتخريج آلاف الشباب سنوياً بمهارات تطبيقية يحتاجها السوق فوراً.
والذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تحالفات إقليمية من أهمها منصة سوق عربية تُتيح للشركات أن تنمو بحجم السوق الكبير، لا بحجم دولة منفردة محدودة الموارد.
ولا بد من تعزيز المنافسة الصحية بين الجامعات والقطاع الخاص فيمكن منح براءات اختراع عاجلة للمشروعات التطبيقية. هكذا تتحول المعرفة النظرية إلى منتج عملي سريع الدخول إلى السوق.
تقديرات عملية وسريعة (أرقام افتراضية واقعية)
ولكي لا تبقى الخطة حبراً على ورق، فإنها تحتاج إلى أرقام واقعية. البداية يمكن أن تكون من ميزانية تأسيسية للصندوق الإقليمي للذكاء الاصطناعي، تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار تُضَخ خلال ثلاث سنوات.
هذه الكلفة يمكن توفيرها بسهولة عبر شراكات بين الحكومات العربية والبنوك التنموية والصناديق السيادية التي كثيراً ما تنفق أضعاف ذلك على مشاريع استعراضية لا تعود بفائدة طويلة الأمد.
إلى جانب المال، هناك الإنسان الذي سيشغّل الآلة ويُبدع النماذج. ولهذا فإن الخطة تتطلب تدريباً وتأهيلاً سنوياً لآلاف الشباب في مهارات تقنية متقدمة، على مدى خمس سنوات.
هذا الاستثمار في البشر سيحوّل جيوش العاطلين أو الباحثين عن فرص إلى قوة عاملة متخصصة، قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
يا عرب، إن فعلتم ذلك، فسيرى العالم نهضة عربية حقيقية في الذكاء الاصطناعي. وستتحولون من مقاعد المتفرجين إلى صدارة الملعب العالمي.