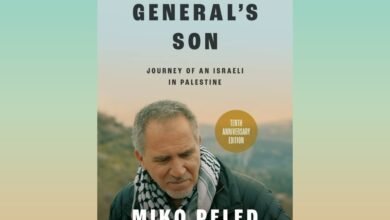ليس هناك في الحقيقة ما يمكن تسميته على وجه الدقة «لباسًا شرعيًا» كما يحلو للكثيرين أن يرددوا اليوم. إنما هناك، في النصوص الدينية القديمة، توجيهات عامة تتعلق بالحشمة وستر العورة، وهي توجيهات فضفاضة تركت تفاصيلها لأعراف المجتمعات وأزمانها المختلفة.
لكن ما حصل عبر التاريخ، خصوصًا في القرن العشرين، هو أن فكرة الحشمة تحولت إلى شعار سياسي واجتماعي تحت مسمى «اللباس الشرعي»، فأصبح يُقدَّم وكأنه حكم ثابت نزل بنص صريح، بينما هو في جوهره اصطلاح مستجد أكثر من كونه حقيقة فقهية راسخة.
فعندما نتتبع جذور الفكرة في التراث الفقهي، لا نجد مصطلح «اللباس الشرعي» بهذه الصيغة عند الفقهاء الأوائل، بل نجد حديثًا عن حدود العورة، وعن لباس يناسب الزمان والمكان، وعن التزام مبدأ الحياء والوقار، من غير تحديد شكل واحد بعينه يصلح لكل مجتمع ولكل عصر.
هذا النمط من تحويل المبدأ إلى زي محدد ليس مقصورًا على المسلمين وحدهم. في التاريخ اليهودي مثلًا، نشأت لدى جماعات الحريديم الأرثوذكسية المتشددة أنماط مميزة من الثياب: معاطف سوداء طويلة وقبعات تقليدية، لكنها لم تكن وحيًا منزلاً من التوراة، بل امتدادًا لأزياء أوروبا الشرقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
مع مرور الوقت تحولت هذه الأزياء إلى علامة هوية دينية واجتماعية، أي أنها غدت «زيًا شرعيًا» بالعرف لا بالنص.
والأمر نفسه يمكن أن نراه في التقاليد الأفغانية؛ فالملابس التي نربطها اليوم بصورة طالبان أو غيرها من الجماعات المتشددة ليست سوى امتداد لأزياء محلية كـ«البرهان تنبان» و«الشابان» وأغطية الرأس التي فرضتها طبيعة المناخ والقبائل، ثم جاء من منحها لاحقًا صفة دينية وألبسها قداسة لم تكن لها في الأصل.
في العالم الإسلامي، أخذ هذا المصطلح شكله الحالي خلال القرن العشرين مع صعود الحركات الإسلامية الحديثة كرد فعل على الاستعمار والتغريب والتحديث السريع.
وجدت هذه الحركات في المظهر وسيلة لإعلان هوية مغايرة ولتأكيد الخصوصية الإسلامية، فبدأ الحديث عن «زي إسلامي» أو «لباس شرعي» باعتباره واجبًا دينيًا، لا مجرد اختيار ثقافي.
في مصر مثلًا، خلال موجات الصحوة الدينية في السبعينيات، صار غطاء الرأس المعروف بالخمار والجلباب الفضفاض يقدَّم على أنه تجسيد للالتزام الديني، وانتشر المصطلح في الدروس والكتب الدعوية. وفي إيران، بعد الثورة عام 1979، تحوّلت أشكال معينة من الحجاب إلى قانون رسمي ووسيلة لفرض رؤية سياسية باسم الدين.
ومع انتشار وسائل الإعلام الدينية والتعليمية من الخليج إلى شمال أفريقيا، تجذر التعبير في الخطاب العام حتى صار مألوفًا وكأنه مبدأ أصيل لا يقبل النقاش.
بهذا المعنى، فإن «اللباس الشرعي» ليس أكثر من بناء اجتماعي وسياسي يوهم بوجود حكم إلهي محدد، بينما الحقيقة أن النصوص الدينية تركت مساحة واسعة للاجتهاد والتنوع الثقافي.
إن ما هو شرعي في جوهر الدين هو قيمة الحشمة والوقار، لا شكل معين من القماش أو طريقة بعينها في تغطية الجسد. وكل محاولة لتحويل هذه القيمة الأخلاقية إلى نمط إلزامي واحد إنما تخدم مشروعًا سياسيًا أو هوياتيًا أكثر مما تستند إلى نص قطعي.
وإذا كان الناس في كل مجتمع يبتكرون ملابسهم بما يناسب مناخهم وثقافتهم ثم يضفون عليها مع الزمن طابعًا دينيًا، فإن القول بوجود «لباس شرعي» واحد يصلح لكل زمان ومكان ليس إلا اختزالًا للتاريخ، ومصادرة لتعددية المجتمعات، وتغليبًا للوظيفة السياسية على الحقيقة الدينية.