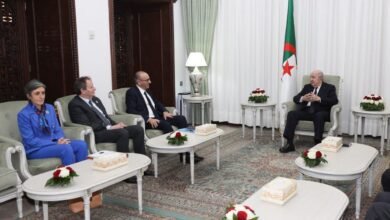فيصل مرجاني
نحن اليوم أمام مفارقة بنيوية عميقة في التحليل السياسي والمؤسساتي المغربي، تتجلى في صدام مباشر بين الواقع الاجتماعي للشباب والنهج الحكومي، وبين الأطر التنظيمية التقليدية التي اعتادت عليها الأجيال السابقة. فقد انفلت الخطاب الشعبي الشبابي من أسر الكلاسيكيات التنظيمية، ليصبح عامل ضغط سياسي واجتماعي مباشر، يفتح من أفق واسع للفهم والوعي بالتحولات العالمية، لكنه يظل مرتبطاً بواقعه الملموس الذي يعاني من تدهور الخدمات الأساسية وانعدام العدالة المجالية والتنموية.
لقد تجسدت هذه المفارقة بوضوح في مبادرة شبابية تحمل اسم “جيل زيد- GenZ”، والتي تعتبر مبادرة مفعمة بتطلعات جيل نحو مغرب مزدهر ومستقبل واعد، يتمثل في مؤسسات تعليمية رفيعة الجودة، ومنشآت صحية عالية الكفاءة، إضافة إلى المطالبة بالحد الأدنى من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
إن هذا الجيل الذي ينظر إلى العالم برؤية شمولية، تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية إلى فضاءات افتراضية متشابكة، غير أنه في الآن ذاته يدرك تماماً أن الواقع الملموس لوطنه لا يوازي طموحاته في الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والفرص الاقتصادية.
وبذلك شهدنا جميعاً، بلا استثناء، التحولات الجوهرية في الخطاب السياسي لهذا الجيل، ونحن الجيل المخضرم الذي يتموضع وسط هذا الجيل وبين الجيل التقليدي الذي ناضل يوما من أجل مغرب محمد السادس، مغرب الحرية والتعبير والمؤسسات. وتبعا لذلك، يظهر بوضوح التوتر القائم بين الشرعية المؤسساتية وفعالية الفعل السياسي الشبابي، وهو ما يقتضي قراءة دقيقة لمفهوم العقد الاجتماعي المعاصر، ولفهم أوضح في العلاقة بين الدولة الحديثة وشرعية الاحتجاج المدني.
حيث إن هذا الجيل لم يكتفِ بالمطالبة بالمكتسبات، بل دعا إلى الخروج في مسيرات سلمية حضارية، في ممارسة فعل سياسي مباشر يرفض اللامبالاة والتسيير العشوائي والفساد المستشري. غير أن الرد الرسمي جاء عبر مقاربة أمنية تقليدية، اعتمدت على الاعتقال والترهيب، متجاوزة آليات السياسة التشاركية والإدارة المرنة، في محاولة فاشلة لفرض السيطرة على حراك شبابي واعٍ ومسالم. لقد أدى هذا الأسلوب إلى تعزيز صلابة الموقف عند هدا الجيل، ومنحه نقطة انطلاق قوية وحادة لم يكن أحد يتوقعها، وهو ما يوضح فشل الحكومة في الاحتواء المؤسساتي للوعي الشبابي.
وفي جانب متصل، لا يمكن غض الطرف عن الفجوة المتزايدة والخطيرة بين توقعات الشباب ومقاربات وزارة الداخلية، والتي تكشف عن هشاشة الأداء المؤسساتي في مواجهة التحولات الاجتماعية، إذ أن هذه الأخيرة على دراية كاملة بالاحتقان الاجتماعي وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الصحية، وضعف المؤسسات التعليمية، وانعدام فرص التنمية في المناطق المهمشة، وهو ما يشكل اختلالاً صارخاً في العدالة المجالية والتنمية المستدامة. ورغم ما أكده خطاب العرش الأخير لصاحب الجلالة نصره الله، حين قال بصرامة: “لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين”، فإن وزارة الداخلية لم تستجب بما يتطلبه من وعي استراتيجي وتحرك استباقي، متجاهلة توصية صريحة للتنمية المتوازنة وسرعة الحوار المؤسساتي.
هنا تتجلى المفارقة بين السرعتين: من جهة، هناك سرعة البناء والتنمية والحوار، التي تعكس روح الدولة الحديثة، وواجبها في الاستجابة لتطلعات المواطنين، وخصوصاً الشباب، بما يحفظ شرعية الدولة واستدامة المؤسسات.
ومن جهة أخرى، هناك سرعة الاعتقال والإقصاء والتهميش، التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية والمقاربات التقليدية، والتي تقوض الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الإحباط الاجتماعي، وتخلق فجوة استراتيجية بين الشرعية المؤسساتية وفعالية السياسات العمومية. هذه الثنائية لا تشكل فقط فشلاً إداريًا، بل أزمة شرعية سياسية حقيقية، تعكس عدم انسجام بين القول والفعل، بين الخطاب المؤسسي والواقع الاجتماعي، وبين الإشارات الملكية السامية والتطبيق التنفيذي على الأرض.
وعند مراجعة التجارب السابقة، يظهر بوضوح أن الوزارة كررت أخطاء كارثية في إدارة الأزمات: من التعامل العشوائي مع جائحة كورونا، إلى ارتباكها في معالجة تبعات زلزال الحوز، لتعود اليوم وتكرر ذات النهج مع هذا الجيل، عوض اعتماد مقاربة إدارية شبابية تتماشى مع التحولات الاجتماعية والسياسية، وتعتمد على الحوار المؤسساتي والتفاوض الاستراتيجي.
لقد اختارت الوزارة مواجهة التطلعات المشروعة للشباب بممارسات تقليدية قائمة على القمع والعنف والإقصاء، متجاهلة توصية جلالته لمغرب يسير بسرعة واحدة: سرعة الحوار والبناء والتفاهم والتنمية، لا سرعة الاعتقال والتهميش والإقصاء.
ولا يمكن حصر المسؤولية فقط في وزارة الداخلية وحدها، بل تشمل كذلك الأحزاب السياسية، سواء في الحكومة الحالية أو سابقاتها، إذ لم تقدّم أي منها مشروعاً بديلاً قادرًا على تجديد الثقة في المؤسسات، أو على فهم ديناميات الفعل السياسي الشبابي خارج الإطار الحزبي التقليدي. والأسوأ من ذلك، أن شيخ المعارضة عبد الإله بنكيران يحاول اليوم الركوب على موجة هذا الحراك الشبابي، متناسياً أن حكومته وحزبه هم من تسببوا في أزمات عميقة خلال العقد الذي حكموا فيه، العقد الذي يحق تسميته بالعشرية السوداء، بما حمله من ارتجال، تبعية، وشعبوية مدمرة.
هذا الإرث السياسي أسس لحقبة اتسمت بضعف الإدارة، انعدام التوازن المجالي، وتراجع الثقة في المؤسسات، مما عمّق اليأس الاجتماعي، وأرسى قطيعة بين المواطن والدولة، وفشل في صياغة سياسات عمومية متماسكة ومستدامة.
ضمن هذا الصدد، يظهر بأن الرهان اليوم غير مرتبط بمعالجة الأزمات المؤقتة، بل ينبني على ضرورة ووجوب إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطن عبر مقاربات شاملة، حديثة، ومرنة، تضمن توازن السرعات بين البناء والتنمية من جهة، والضبط والأمن من جهة أخرى، بما يعزز شرعية المؤسسات، ويستجيب لطموحات وتطلعات الشباب بالقدر الكافي والمطلوب الذي يجسد العدالة المجالية والتنمية المستدامة على أرض الواقع.