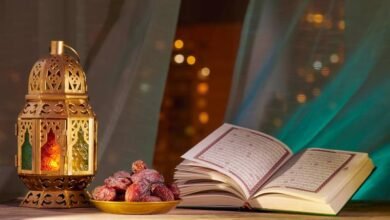نحن أمّة تجلجل القيم في خطبها، وترفع الأخلاق راية في وجه العالم، حتى تبدو الفضيلة وكأنها خُلقت من لغتنا، ويبدو تاريخنا كقممٍ الجبال.
لكن ما إن تغادر هذه القيم المنابر وتحاول أن تمشي في الشارع أو تقف في طابور أو تعبر مفترق طرق، حتى تتعثّر وتفقد بوصلة المثال.
وفجأة يصبح ما نقوله بريقًا جميلاً، وما نمارسه واقعيةً جافة ومتناقضة. إذ أن هذه الظاهرة تبرز في عالمنا العربي بدرجة أكبر، وقد نبّهنا القرآن الكريم منذ القدم بقوله تعالى: ﴿أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب﴾؛ هذه الآية هي مرآة لواقعنا، لكننا نميل فيها إلى تعديل الإضاءة كي لا نرى التجاعيد التي خلّفتها الازدواجية على وجوهنا.
فالمشكلة تتجلى في إنسانٍ يحب الفضيلة قولا وجهرا ويتهرّب منها سلوكًا وفعلا، وفي مجتمعٍ يعلو فيه خطاب الأخلاق ويتراجع فيه مستوى تطبيقها، فالمشكلة إذن ليست كما يعتقد معظم الناس في الدين الواضح كالشمس، ولا في القيم الأبهى من أن تُناقش.
حيث نعلّق أخطاءنا دومًا على “الآخر”: الحكومة، الشارع، التربية.. بينما المرآة التي أمامنا متّسخة من أثر سلوكنا نحن. وهنا يبرز سؤال جريء ومزعج: هل نحبّ الأخلاق ونتبناها في سلوكنا.. أم فقط نحبّ الحديث عنها؟
وحين نعود خطوة إلى الخلف وننظر بعمق داخل الذات العربية، نكتشف أن ازدواجية الخطاب هي نتيجة ثلاث طبقات نفسية وثقافية تتعايش في داخلنا منذ زمن بعيد لا كما يقر البعض بكونها حادثًا عابرًا أو سلوكًا شادا:
• طبقة الوعي الأخلاقي: نحن نعرف تمامًا ما هو الصواب؛ فالقيم الدينية والحضارية ظلت تروّي وجداننا منذ الطفولة، ونحفظ الأخلاق ونتقن الكلام عنها… لكننا لم نتقن كيفية تحويلها إلى ممارسة عملية يومية.
• طبقة المجتمع والتمثّل: نحن نخاف العيب أكثر مما نخاف الخطأ، فنرتدي الفضيلة أمام الناس، ثم نخلعها في غيابهم. وهي الثنائية التي وصفها علي الوردي بدقة «أنا مثالية للمجتمع… وأنا واقعية للذات..»
• طبقة التبرير الذاتي: وعندما ننزلق، نُدين الظروف والآخرين بدل أن نواجه أنفسنا. حيث نُبدع في صناعة الأعذار، ونمارس إساءة الفعل ونحن مقتنعون ببساطة أننا على صواب.
وهنا يأتي رأي محمد عابد الجابري أن العقل العربي يميل إلى حبّ الخطاب النظري أكثر من التزام الفعل العملي.
فتكبر الشعارات.. وتفتقد السلوكيات. وتتشكل تلك الهوّة المؤلمة بين ما نرفع من قيمٍ في الوجدان، وما نمارسه من أخلاقٍ في واقعنا اليومي.
حيث تتجسّد ازدواجية الخطاب في تفاصيل الحياة اليومية التي نراها جميعًا، وتشاركنا فيها غالبًا، سواء أحببنا الاعتراف بذلك أم لم نحب.
فالازدواجية في ثقافتنا ملموسة إلى حدّ أنك تراها في أول خطوة خارج بيتك. فبينما نرفع أصوتنا عاليًا في تمجيد القيم، تتعثّر هذه القيم نفسها عند أول احتكاك لنا بتفاصيل الواقع.
ونستنكر من يرمي النفايات في الطريق ثم نفعلها خلسة إذا غاب الرقيب؛ ونشجب فوضى السياقة في الطرقات ونخرق إشارات المرور عند أول استعجال لنا؛ كما نتحدّث عن حماية البيئة واستهلاك مواردها ونهدر ونفرط في استعمال الماء..؛
ونرفض الرشوة في العلن، ثم نلجأ إلى “المعرفة” لتيسير مصالحنا؛ ونطالب بخدمات مثالية، ولا نلتزم نحن بإتقان ما نُكلَّف به؛ كما نُمجّد النظام والنظافة، ونترك مرافقنا العامة تنوء تحت آثار إهمالنا؛ ونتغنّى بالصدق، ونخنق الحقيقة تحت ركام المجاملات.
وكما تظهر لنا هذه الأمثلة، فإن الحضارة، تقاس بالأفعال اليومية البسيطة، هذه التفاصيل الصغيرة المتكررة، تكشف مدى صراحة مجتمعنا مع قيمه، ومدى قدرته على محاربة الازدواجية في السلوك.
وهكذا تُولد الازدواجية الحقيقية في أبسط تصرفاتنا اليومية فتتسلل بهدوء إلى سلوكنا حتى تطبع ضمير المجتمع كله، فتغدو عادة أكثر منها استثناء.
ولعل ابن خلدون لامس هذا الجوهر حين أقر بأن الأخلاق تترسّخ بالممارسة حتى تصبح طبعًا جمعيًا يحدّد صورة الأمة ومصيرها.
فحين ننظر إلى الغرب لا ينبغي علينا أن ننظر إلى تلك الصورة الجاهزة، وإنما ينبغي أن نحلل تلك المنظومة التي تشكّلت عبر تاريخ من الصراع بين الفكر والمؤسسات.
فالمجتمعات الغربية تجاوزت خطاب الازدواجية من خلال ترسيخ آليات تحول القول إلى فعل ولم تتجاوزه من باب الاستعلاء الأخلاقي، وذلك من خلال قوانين صارمة، ومحاسبة واقعية، ووعي جمعي يعتبر الفضاء العام امتدادًا للبيت الخاص.
فالفرد هناك يدرك أن الحق العام هو حقٌّ شخصي له ولغيره، فتتولد لديه أخلاق السلوك من منطق المصلحة المشتركة.
أمّا في العالم العربي، فنحن نملك تراثًا قيميًا غنيًّا ومبادئ أخلاقية راسخة، لكنّها غالبًا تبقى معلّقة في رسائل الخطاب دون أن تتجسد على أرض االواقع.
فما زال المواطن العربي هنا يُربّي ذاته على عين المجتمع لا كما ينبغي على عين القانون، فيسعى إلى تجميل صورته بدل تصحيح سلوكه. و يلتزم حين يتواجد من يراقبه، ويتحرّر من هذا الالتزام حين يغيب ذلك الرقيب.
ولكن المشكلة ليست في كوننا نفتقد القيم، فنحن نفتقد نظامًا فعّالًا يجعل القيم قابلة للقياس والمحاسبة، ويحوّل الأخلاق من أمنيات إلى مسؤوليات. وفي هذه النقطة تتحدد الفجوة: إذ الغرب بنى منظومةً تجعل السلوك هو اللغة الحقيقية للقيم، بينما ما زلنا نعتقد أنّ الكلام وحده يكفي لإثبات الفضيلة.
ومنه يمكن تلخيص مكامن الازدواجية في سلوكنا الاجتماعي في ثلاثة محاور رئيسية، تكشف عن جذور المشكلة في الثقافة أكثر من كونها مسألة قيم:
• ثقافة الوعظ دون القدوة: كثيرًا ما يُقدَّم الخطاب الأخلاقي كنصيحة عامة، بينما يظل السلوك الشخصي بعيدًا عن هذه القيم.
• غياب المحاسبة الذاتية: هناك ميل للتساهل مع الأخطاء الصغيرة وتبرير التجاوزات، مما يسمح لها بالتراكم حتى تصبح عادة مستمرة.
• هيمنة منطق العيب على القانون: يُمارس الصواب غالبًا بدافع الخوف من الملاحظة أو العيب الاجتماعي، لا اقتناعًا بالقيم أو احترامًا للقانون.
كما يؤكّد ابن خلدون أنّ الأخلاق تتكوّن من التصرّفات المتكررة حتى تصبح عادة اجتماعية، وما يميز ثقافتنا أحيانًا هو السماح للتجاوزات بالاستمرار دون ضبط، مما يرسّخ الانفصال بين القول والفعل.
حيث إن إدراك هذه المكامن هو الخطوة الأولى نحو إصلاح جذري، إذ لا يمكن معالجة الازدواجية الأخلاقية دون فهم الآليات الثقافية والاجتماعية التي تسمح لها بالاستمرار والتجذر في المجتع.
فالتغيير الحقيقي يبدأ من الفرد، لكنه يحتاج إلى بيئة مجتمعية تدعم الممارسة الفعلية للقيم وليس فقط الحديث عنها. ويمكن تلخيص خطوات الإصلاح في أربعة مستويات متكاملة:
• البيت: أن تكون القدوة أفعالًا قبل أن تكون محاضرات، فالأسرة هي المدرسة الأولى للقيم والسلوكيات.
• المدرسة: تعليم السلوك الأخلاقي بالممارسة الفعلية اليومية، من خلال أنشطة تربوية تعزز الالتزام بالقيم وتحويلها إلى عادات.
• الإعلام: يجب اعتماد خطاب عملي وبسيط وواقعي، يبرز الأمثلة العملية بدلاً من الشعارات الطوباوية، ليكون النموذج أمام الناشئة والمجتمع.
• الفضاء العام: تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، على الكبير قبل الصغير، وعلى المسؤول قبل المواطن العادي، مما يحوّل الالتزام بالقيم إلى ممارسة اجتماعية ملموسة.
ويمكن للحضارة المكتملة أن تُبنى على سلوك محترم واحد يتكرر كل يوم، أكثر من أي خطاب طويل أو شعارات براقة.
وأخيرا يمكن القول أننا نملك أجمل القيم وأسمى المبادئ، لكنّ العالم لن يصدّقها إلا حين يراها مجسّدة في أفعالنا اليومية، بعيدًا عن شعارات المنابر والكلمات المعلّقة على الجدران واللافتات.
حيث إن اللحظة التي تتطابق فيها أقوالنا مع أفعالنا، وتصبح قيمنا حاضرة في كل تصرّف صغير وكبير، هي اللحظة التي نستحق فيها أن يتحوّل خطابنا إلى حضارة حقيقية. ومنه علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن ننتقد الآخرين:
هل نحبّ أخلاقنا ولنا رغبة في سيادتها في المجتمع.. أم نحبُّ الحديث عنها فقط؟ إذ الحقيقة المؤلمة هي أنّ الكلام وحده لا يبني حضارة، لكن الحقيقة الملهِمة هي أنّ الفعل المتكرر والصادق هو ما يصنع المجتمع المثالي، ويحوّل قيمنا من شعارات إلى واقع ملموس. فحين تتطابق أقوالنا مع أفعالنا… فقط عندها نستحق حضارة تشبه خطابنا.