مطالعة عامَّة واستقراء
طالعتنا كتب التاريخ في العصر الحديث بأخبار المدارس الفكرية والثقافية في السودان، منها على سبيل المثال مدرسة الغابة والصحراء في ستينيات القرن الماضي (1962 تحديداً) والتي انتبهت لقضية الهُوِيَّة الوطنية السودانية، وما دار حولها ومعها وفيها من أحاديث ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية وخلافه، انتصرت هذه المدرسة أم لم تنتصر لكن غياهبها اليوم ما نراه على الساحة الوطنية القومية السودانية من نزاعات وتصدعات وما أشبه، في حين كنت، بعد مراجعتي فكرياً لهذه المدرسة ونظريتها الفلسفية في البحث عن الهُوِيَّة الوطنية بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معها.
أقول: يظل أثرها قائماً بلا منازع وفكرتها مع كل التقدير لم توفق في اختيارها ولا العمل لأجلها، راجع أدبيات خلافاتهم مع بعض إذ لم تكن مطروحة على العقل العام الجمعي السوداني قبل طرحها لهم بعد ثورة أكتوبر المجيدة 1964 أي بعدها بسنتين تقريباً من تكوينها وما أفرزته من سلبيات جليَّة أمام الرأي العام الفكري والسياسي والثقافي واضح للعيان بما لا يحتاج معه إلى شرح بلا شك ولم يكن هناك داعي لطرحها أصلاً وربما أتت نتائجها السلبية من ناحية التطبيق أكثر من ناحية التنظير والله أعلم أي ذلك كان.
المدرسة الكلاسيكية.. الغابة والصحراء
قلت بعد مراجعتي لأدبيات تلكم المدرسة لم أجد في جوهرها ما يبعث على البحث عن الهُوِيَّة آنذاك وأن تقوم لها كل تلك القيامات من قبيلة المثقفين السودانيين لأكثر من ستين سنة، ولم أر نتيجة بيِّنَة توصلتْ إليها لحسم النظرية أو القضية المطروحة خلاف المزيد من التصعيد الثوري في كافة المجالات الحياتية والسياسية تحديداً وهذا رأيي، ربما لم أكن فيه موفقاً لكنها قراءة لا أكثر ولا أقل.
من أهم روَّاد مدرسة الغابة والصحراء: النور عثمان أبَّكر، علي المك، محمد المكي إبراهيم، تاج السر الحسن، صلاح أحمد إبراهيم، محمد عبد الحي، مصطفى سند ـ يوسف عيدابي، عبد الله شاب، وآخرون، وربما يجب علي أن أتخطَّاها لأنَّها معروفة لدى الكثيرين مما يغني عن الإعادة ههنا.
المدرسة الرومانتيكية.. الكتابة ومصادر المعرفة
بعد حقبة انتشار تلكم المدرسة، ظهرت مدرسة أخرى لم تكن ذائعة الصيت أو قل لم تجد حظها من الإعلام والذيوع في الوسط السوداني المثقف أو السياسي لسبب أو لآخر كما هو الحال اليوم من انتشار الإعلام بكل مسمياته ودرجاته، لكنها في تقديري أشد ايغالاً وأكثرها إيجاباً منها وهي المدرسة الرومانتيكية الكتابية السودانية، من خيرة أبناء الوطن وهم على سبيل المثال: محمد خلف الله أسامة الخوَّاض، عبد اللطيف علي الفكي، أحمد الصادق، الماحي علي الماحي، كمال الجزولي، بابكر الوسيلة، محمد عبد الرحمن حسن، وآخرون، راجع كلمتنا حولهم في عنوان “المتن الروائي المفتوح ” بين طيات هذا السفر.
أهم أطروحات المدرسة الرومانتيكية
تتلخص فكرة المدرسة الرومانتيكية الكتابية السودانية في نقل وتدوين وتثبيت وتوثيق التاريخ والحضارة والهُوِيَّة الوطنية السودانية من حالة الشفاهية إلى حالة الواقعية بالتدوين الكتابي، مما جعلها في تقديري أشد اعتدالاً وحصافةً وجدارةً بالبحث والتأمل، ذلك لأنَّها اختزلت جوهر فكرتها ونظريتها الكتابية لا في البحث عن الهُوِيَّة على غورابها فقط، بل بالتأكيد على أن الهُوِيَّة الوطنية السودانية هي مجموعة القيم والحضارات القديمة والتاريخ والآثار والأحفوريات وحتى الأساطير الشعبية ذات الطابع التربوي، فحرصت أشد ما يكون الحرص على توكيد وتوحيد البنية الأساسية لهُوِيَّة السودان من باب التصحيح والمراجعة والتدقيق للتاريخ والحضارة الإنسانية والأخلاقية السودانية للذين سبقوا بالكتابة عنها من المستشرقين والمبتعثين الأجانب في فترتي الحكم التركي المصري (1821 – 1899) والفترة المهدية وخليفته عبد الله التعايشي من بعده (1881 – 1898) والحكم الانجليزي المصري (1899 -1956)، حتى لا يكون السودان فكرة مبتذلة أو شعب رخيص ووضيع في المخيلة الفكرية والثقافية والاجتماعية الإنسانية بعامة وخصوصاً للمهتمين من أبناء الوطن الواحد بالنسبة للمجتمع الدولي.
إنَّ قيام فكرة المدرسة الرومانتيكية الكتابية دليل على الوعي والمسؤولية التضامنية لإبراز صورة السودان في العقل الجمعي العالمي في أبهى صوره الفكرية من كافة النواحي الحياتية، حتى يستعيد صدارة المجد والخلود للإنسانية كلها من ثبات وهدها ومهدها الوثير بلا شك.
أهم مميزات المدرسة الرومانتيكية
إنَّ أهم ما يميز هذه المدرسة وحركتها التي أطلقتُ عليها اسم المدرسة الرومانتيكية الكتابية، هو قضية إعادة كتابة التاريخ والحضارة الإنسانية السودانية الشفاهية القديمة من جانبي الحداثة والمعاصرة ومن جانبي العنصر البشري والمستقبل الاجتماعي سيراً نحو فكرة التوثيق والتنوع الثقافي لدلالة المكوِّن الأساس للتركيبة الشعبوية السودانوية بلا حدود.
في أحسن التقدير، لم تدرك أو لم تدر جماعة وروَّاد مدرسة الرومانتيكية الكتابية السودانية أنها شكلت بصورة ما هذه اللوحة الفنية والإبداعية والتراثية المجتمعية الإنسانية الرائعة كما استخلصتها أنا من واقع قراءة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمسرح الحياة السودانية كذلك، من واقع دراسة الانثروبولوجيا والديمغرافية السودانية في عُدَّة كتب كتبتها متاحة، وغير متاحة الآن لكنها جاهزة للطباعة والنشر والتوزيع، وإن كانت تأخذ أبعاداً متباعدة في التنوع والتعدد الفكري، لكنها في ذات الوقت تأخذ شكل الأوركسترا الموسيقية التي تختلف الآتها العزفية مجتمعة وفي ذات الوقت تعطي لحناً موسيقياً رائعاً يعبر عن الحالة المزاجية والنفسية للتركيبة الوجدانية السودانية، وفي الحقيقة أطَّرَت لمفهوم الوحدة الوطنية السودانية المتضمنة في حيثياتها آصل أصولها التعددية البشرية والطبيعية الاثنية للناس بالسودان فساقت الاتجاهين معاً نحو فكرة المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية الإنسانية للمواطن السوداني أينما كان.
المدرسة الوسطية بين الرومانتيكة والتجديدية
هناك امتداد طبيعي لتيار شبه ثوري يجمع ما بين الأدب والسياسة والثقافة والشعر وخلافه، في أغلب الظن وفي تقديري الشخصي إن هذا التيار لا يحمل فكرة بعينها لكنها تأثرت بشكل عام بمدرسة الغابة والصحراء، وكان لهم حركة وحماس في الوسط الثقافي السوداني بعامَّة، ولكن تأثرهم بالتيار السابق لم يتأثر به روَّاد المدرسة التجديدية للكُتَّاب السودانيين فكل مرحلة حياتية سودانية ترتبط بشكل أو بآخر بالمراحل السياسية، وقد جمعت بصورة كبيرة ومقدرة بين التأثير والتأثر وإن كان بعضهم يرفض هذا التصنيف، لكني أرى بقراءة عامة للمشهد الثقافي السوداني على مسرح الحياة والقدوة الوطنية اعتراضاً أو اتفاقاً مع موجهات السياسة العامة للدولة، أنهم في أغلب الأحوال يندرجون تحت المسمى الوسطي المعتدل / المدرسة الوسطية / فلا هم ينتمون لمدرسة الغابة والصحراء ولا هم ينتمون لمدرسة التجديد، فأخذوا من المدرستين غِلاباً بيد أنَّهم للاعتدال أقرب منه إلى الحداثة والتجديد.
أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: محمد الحسن سالم حميد، عالم عباس محمد نور، محمد نجيب محمد علي، محمد المهدي بشرى، فضيلي جماع، كمال الجزولي، بشرى الفاضل، مصطفى سند / لمرحلتين / روضة الحاج محمد، التيجاني سعيد، الباقر العفيف، الخاتم عدلان، الواثق كمير، علي مهدي نوري، الطيب زين العابدين، عمر الطيب الدوش، يحي فضل الله، عبد الله حمدنا الله، يحي التكينة، علي هاشم السراج، وآخرون.
أهم مميزات المدرسة الوسطية
إنَّ أهم ما يميز هذه المدرسة وحركتها النشطة هي محاولة إعادة شكل الدولة الحديثة ومفهوم الوطنية السودانية في حقل الفكر والشعور القوميين الاجتماعيين نحو تطلعات وآمال الشعب السوداني، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حول ماهية التغيير الذي ينشدونه لكنها تظل مدرسة قائمة بذاتها لا يمكن تخطيها بحال من الأحوال.
من الخطأ وأنا استرسل حول هذا الموضوع الشائك والمعقد أن ادرج هذه المدارس الفكرية والثقافية والأدبية والفنية والسياسية، إن لم أذكر فترة زمنية محددة وهي مرحلة حكم الإخوان المسلمين للدولة السودانية باسم الإسلام السياسي (1989 – 2019) وهي التي أفرزت نتيجة طبيعية المدرسة التجديدية للكُتَّاب السودانيين التي نكتب عنها الآن، لأنَّها ذات أيديولوجية معينة ولا يمكن قياسها بتلك المدارس المختلفة والمتباينة والمتعددة وإن كان لروَّادها حُجَجهم وأهدافهم وغاياتهم النبيلة تجاه رسم خارطة الدولة الحديثة سواء نجحوا في ذلك أو اخفقوا لكن تظل مدرستهم قائمة تاريخياً بلا انتقاص منها مهما اتفقنا أو اختلفنا حولها..
وفي تقديري الشخصي هي من الضعف بمكان إذ أنها أنتجت تفاريخاً أودت بالشعب موارد الهلاك والتشظي وما يحدث الآن في البلاد (2019 -2025 / والحرب المؤرَّخة 15 / 4 / 2023 – 23 / 9 / 2025) هو نتاج طبيعي مستمر من تلكم السياسات العقيمة والأفكار الشمولية لتمرير أجندتها السياسية باسم الإسلام والدين لذلك هي خارج المنافسة التشريفية بين المدارس الفكرية المذكورة آنفاً، وبطبيعة الحال لها روَّادها ومعجبوها ومؤسسوها بلا شك.
أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: المحبوب عبد السلام، أمين حسن عمر، حسين خوجلي، سناء حمد العوض، ياسر يوسف، إسحاق أحمد فضل الله، يونس محمود، الطيب مصطفى، عبد الله أحمد فضل الله، غازي صلاح الدين العتباني، وغيرهم.
المدرسة التجديدية للكُتَّاب السودانيين
قبل أن أكتب عن هذه المدرسة التجديدية التي أَشْرُفُ بأن أكون أول من انتبه لها وكتب عنها احقاقاً للحق وللتاريخ والهم المشترك وتحمل المسؤولية الفردية أو مع الجماعة وأرجو الله أن تستمد طاقتها الحياتية لأزمان قادمة طويلة مستخلصة من عبق الحضارة والتاريخ السودانيين في أسمى الغايات، كان لا بد لي أن استعرض تاريخياً ولو قليلاً من التجارب الفكرية الوطنية السابقة لأمَهِّد للقارئ طبيعة الحركة الفكرية الثورية الطليعية التجديدية في إحدى درجاتها زماناً ومكاناً.
بطبيعة الحال، يأخذ الزمان والمكان دورتيهما الطبيعية في تشكيل العقل الحادث بما يحمله من هموم وقضايا وحلول وتحديات العصر والمستقبل لما يواجهه السودان في القرن الواحد والعشرين من كل التحديات للمكونات والتكالبات الدولية والمحلية والإقليمية، لينهض روَّاد هذه المدرسة بأعباء المرحلة المقبلة وإن كانوا لا يعرفون بعضهم مجتمعين إشارات هذه الأبعاد المذكورة أعلاه..
وفي ذات الوقت يعزفون ذات السيمفونية الرائعة لذات الآلات الموسيقية المختلفة من أمكان وأزمان مختلفة، ليشكلوا ملامح المستقبل الواعد لحناً موسيقياً عبقرياً باقياً يعطي بداهة الأشياء لرسم الملامح الأولية للأحياء فكراً وشعوراً، وللأشياء رمزاً ومعنى، وليس شرطاً أن يكون هناك اتفاقات ثنائية مسبقة أو اجتماعات متتابعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الوطنية المنشودة، بل يكفي وهي في عرصات التنوع الثقافي والتعدد الاثني تؤكد مخرجات ونتائج أهمية وحتمية الخروج من هذا المأزق التاريخي الاستثنائي بنتيجة إيجابية تكون أساس الفكر والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية ريادة وقيادة وسيادة في كل مناحي الحياة.
أنا اطمئن للغاية أن أكون أوَّل من انتبه وكتب عنها وأسس لهذه المدرسة التجديدية للكُتَّاب السودانيين في العصر الحديث، بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف حول ماهيَّة التغيير الذي تتبنَّاه أو ماهيَّة الحالة التي هي عليها أو ضرورة الكتابة عنها والتنبه إليها فهي على عمومها تحكي حالتها تلك من عزفها لأغنية الخلاص الجديد، وأؤكد أن هذه المدرسة التجديدية للكُتَّاب السودانيين من روَّاد الفكر والشعور الانسانيين هدية للعالم أجمع بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، ولعلهم ولأول مرة يكتشفون ذواتهم يسيرون في اتجاهات مختلفة نحو غاية واحدة فقط هي السودان أولاً – السودان دائماً، تحت شعار (السودان هو الهُوِيَّة الوطنية) السودان للسودانيين إلى الأبد.
على سبيل المثال لا الحصر نعطي نماذجاً لأسماء روَّاد المدرسة التجديدية للكُتَّاب السودانيين من جانبي التنظير والتطبيق وهم: عبد العزيز بركة ساكن، راشد دياب، بدر الدين إبراهيم العتَّاق، عماد الدين البليك، عبد المنعم رحمه، أحمد إبراهيم أبو شوك، بشير محي الدين، التجاني حاج موسى، اسحاق الحلنقي، أبو عاقلة إدريس إسماعيل، عفيف إسماعيل، سامي حامد طيب الأسماء، شوقي عبد العظيم، عثمان ميرغني، الأمين عمر الأمين، أشرف عبد العزيز ، وآخرون.
لا يعني ذكر بعض الأسماء نسيان أو تغافل غيرها – حاشا لله – أو عدم مشاركتهم لنا في هذه المدرسة بحال ما، بل ما يجمع هذه الأسماء مع من لم يُذْكَر هي التلاقي المشترك في الأفكار والأفهام والغايات والأهداف والانسجام مع الثوابت الوطنية العليا وخلافه وإن لم يُذكر صراحة..
ومن يجد نفسه وفكره وحياته ولو قليلاً متماشياً معها ومعنا فهو مِنَّا بمنزلة الوالد من الولد والأخ من الأخ والصديق من الصديق، بصرف النظر عن السبل المختلفة والمتعددة لتحقيق تلك الغايات النبيلة أو معرفتهم ببعضهم البعض، لكنها كلها في ذات الوقت وذنَّاك السياق تتفق وتجتمع في صعيد واحد على قلب رجل واحد هو شكل الدولة الحديثة (السودان الجديد).
أهم مميزات المدرسة التجديدية
إنَّ أهم ما يميز هذه المدرسة التجديدية للكُتَّاب السودانيين هو اختلاف المساقات الكتابية لكنها كلها تصب حاق المعرفة والوعي والوعد الحق لتشكيل مفهوم الدولة الحديثة ولا تنشأ أي دولة ولا أي مجتمع بشري على كوكب الأرض إلَّا على أكتاف المفكرين والمثقفين والمبدعين اللذين يحملون اللَّبِنات الأولية لغرس مفاهيم الأصالة والمعاصرة وتعريف جديد لمعاني ودلالات الهُوِيَّة الوطنية أينما كانت في أعلى وأجل وأكبر معانيها لا في حصرها كما السودان في بندين اثنين هما الزنوجة والعروبة أو الإسلام والوثنية…
بل تتخطاهما بلا نهاية نحو فكرة عنصر الإنسان السوداني نفسه كيفما اتفق ، فالشعب السوداني من ناحية العنصر الإنساني الوجودي هو الأصل في مفهوم التركيبة الاجتماعية الشعبوية بكل حسناتها وسيئاتها وبكل تنوعها وتباينها واتفاقها واختلافها وهو ما يشكل دولة الإنسان الحادثة الحديثة للإنسانية القادمة بطريق الوعي وتحمل المسؤولية الاجتماعية لبناء الدولة المنشودة.
تعريف كُتَّاب المدرسة التجديدية السودانية
لم يكن اختياري للأسماء أعلاه من باب الشخصنة ولا طبيعة العلاقة بيني وبينهم بلا شك، لكنها أتت بقراءة غزارة المنتوج الكتابي الصادر منهم والذي يشكل – في تقديري الشخصي – أرضية صلبة لبناء قاعدتي الفكر والشعور القوميين، ولأنهم يكتبون بلا توافق متعارف عليه بل يكتبون بتوافق راقي وعالي وانسجامي وحس وطني وشعور قومي دقيق ورفيع لفهم قضايا المجتمع عامَّة وآلية الخروج من حالته الراهنة المشحونة بالصراعات والتصدعات والحروب وخطابات الكراهية والجهوية والمناطقية والبغضاء والعنصرية والعنف بكل أشكاله وصوره ورفض الآخر إلى مصاف الحداثة والسلام والعلم والمعرفة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والأخلاقية والمعاملة الحسنة والسلوك القويم والديمقراطية وحقوق الإنسان المنشود في خضم تحديات العصر الآن، فكلٌ يكتب نحو هذه الغايات والأهداف بشكل مختلف ويعبر عنها بأسلوب جديد ويطرحها للمتلقي من باب الهم والمسؤولية الاجتماعية المشتركة بين أبناء الوطن الواحد ليصل في النهاية إلى الحرية الفردية المطلقة والعدالة الاجتماعية الشاملة والمواطنة نحو أسس علمية حديثة لبناء دولة الإنسان السوداني رغم التحديات والصعوبات التي تواجههم..
وأنا على ثقة بأن الهدف السامي المشترك هذا لا تعكره الأساليب المختلفة للتعبير عنه وعن الذات والهُوِيَّة الوطنية السودانية بل في هذا بلا شك اصحاح للحالة المعلولة التي نعيشها الآن وأمس تحسباً للغد، فنحن نكتب ونعمل ونرسم جميعنا لوحة الخلاص الأبدي نحو الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان على مذابح التفرقة والتحزب والتخندق في شِعْبٍ ضيق لا يسمن ولا يغني من جوع.
هؤلاء هم روَّاد المدرسة التجديدية للكُتَّاب السودانيين في العصر الحديث وتلك هي أهم ما يميزهم عن غيرهم وأنهم نواة لمن بعدهم في دورة زمكانية حلزونية جديدة تتدرج لأعلى مستوى نحو القمة بلا نهاية وبلا منازع وبلا خنوع إن شاء الله.


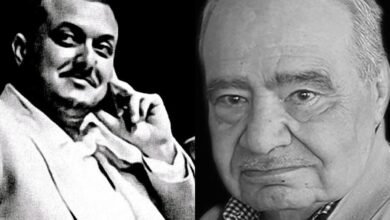
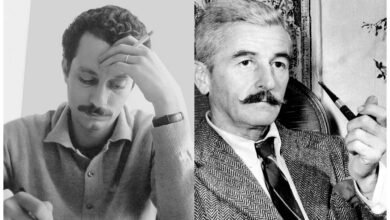

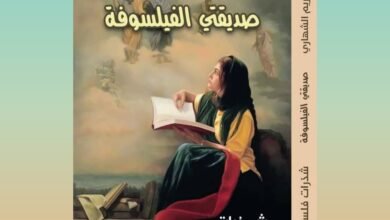
هذا الكتاب المُفصّل يقدم فكرة رائعة لـ المدرسة الرومانتيكية الكتابية، وإن كان القول إنهم أطَّرَوا لمفهوم الوحدة الوطنية قد يثير دهشة بعض من شاكر التعددية! لكن البحث عن الهوية وطبيعة السودان الجديد هو سعي طبيعي ومهم. والنقطة التي تُظهر فيها المدرسة الوسطية أنها ليست مدرسة متوسطة فقط بل مدرسة معتدلة/وسطية قد تكون مجرد محاولة لتصنيف الفن مثلما تحاول تصنيف الكتب، فالفن والفكر لا يُصنفان بسهولة. وأخيراً، إن لم يكن هناك اتفاق مسبق، فكيف يمكن لروَّاد المدرسة التجديدية أن يتفقوا؟ ربما لأنهم يتفقون على ضرورة الاتفاق بالطريقة التي يرونها، وهو ما يجعلها، كما تقول، هدية للعالم أجمع.free ai watermark remover