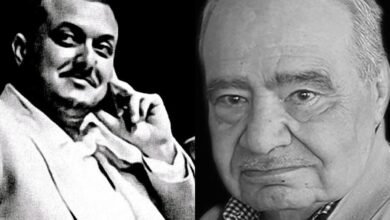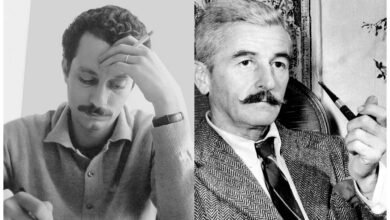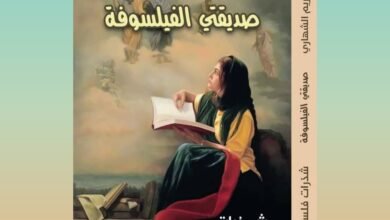أولاً، علاقة الدين باحتفالية المولد
أود أن أثبت للقارئ الكريم وأن ألفت النظر في عموم وخصوص هذه الكلمة أنَّ الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية ولا بغيرها من المتعلقات ذات الصلة، بل لها علاقة مباشرة واصيلة واكيدة بالعرف الاجتماعي في أي موضع كان سواء قبل هذا العرف والاحتفال أم بغيره أو برفض إقامة الاحتفال من أصله وعليه يكون القياس.
ولا يجب أن تتحكم فيه دوائر بعينها تنسب نفسها للدين أو لها حق فرض الوصاية الإلهية المطلقة من الله على الخلق فيقدسون الفتاوي من المشايخ والعلماء باعتباره هو الدين لا غير وأن رجل الدين أيَّاً كان له ادعاءاته الخاصة به سلباً أو إيجاباً هو في الواقع شخص عادي يخطئ ويصيب وما لم يقرر العرف الاجتماعي لبلد ما أو لمكان ما ممن يقيمون الاحتفال أو يرفضونه بطريق القانون التشريعي من قبل البرلمان المنتخب أو غير المنتخب أو حتى دون أن يقره القانون طالما هو متعارف عليه فلا حاجة لقوننته وإن كان القانون أفضل، من المجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية الرسمية للدولة فعليه يكون التقدير.
ثانياً، تاريخية الاحتفال بعيد الميلاد
جاء بصحيفة اليوم السابع المصرية بالإنترنت ، وكذلك في بعض كتب التراث ككتاب (سير أعلام النبلاء) لشمس الدين الذهبي (1274 – 1348) / ذكر فقط طرفاً من تاريخ ولايته لا المولد / إنَّ أول من احتفل وأقام المولد النبوي الشريف هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين بن بكتكين، والي أربل أو أربيل في شمال العراق (1153 – 1232) {79 عاماً} وهو محل مراجعة بلا شك إذ أنَّ أول من أقام الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بعد مقارنة التواريخ مع بعضها البعض يتضح أنَّ الفاطميين (906 – 1171) عند تمدد دولتهم الشيعية في شمال أفريقيا من مركز دعوتها أو عاصمتها تونس الحالية، هم أول من أقام واقر العرف الاجتماعي سماحاً واسماحاً للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
ثم امتدت هذه الإمبراطورية أو الدولة الفاطمية إلى تخوم بقية بلاد افريقيا من وسط القارة الأفريقية وصولاً إلى بلاد مصر سنة 969 م، أي بعد ستين سنة من قيام الدولة الفاطمية (909 – 969) بقيادة جوهر الصقلي، وكان الغرض من إقامة ذكرى المولد هو استقطاب الشعب المصري وقبولهم الدولة الحديثة نكاية في الدولة العباسية أو نوعاً ما من المعارضة السياسية التي كانت تسيطر على أغلب بلاد الشام والجزيرة العربية وأفريقيا وأوروبا آنذاك مما أوعز لعبيد الله بن الحسن المهدي (873 – 934) مؤسس الدولة الفاطمية أن يتوغل بمعارضته السياسية من طريق رجل الدولة المعز لدين الله الفاطمي (932 – 975) ورجل الجيش جوهر الصقلي (911 – 992)، نحو مصر في تخوم أفريقيا من جهة الشمال والوسط وبمحاذاة الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط لتكون له الغلبة على أمير المؤمنين في الدولة العباسية آنذاك.
هذا ! جاء ابن بكتكين بعد مائة أربعة وثمانين عاماً (1153 – 969) {184 عاماً} من سنة الاحتفال بذكرة المولد النبوي الشريف، بمعنى أنَّ أوَّل من احتفل بالمولد النبوي الشريف هم الفاطميون وليس ابن بكتكين كما ذكر المؤرِّخون مما يجب التنبيه إليه ههنا.
رجع الحديث
لم يستنكر ولم يستنكف الشعب المصري ولا شعوب المنطقة آنذاك فكرة قبول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حين كانت مخاطبته من قياداته السياسية من طريق الدين الإسلامي ودغدغة المشاعر والميولات النفسية والعقلية والعقدية تجاه النبي محمد عليه السلام فكان لهم ما أرادوا، ولم يعترض عليها بطبيعة الحال أحد، بل قبلوها وعملوا بها.
سبب آخر، التخطيط الاستراتيجي السياسي لتحقيق أهداف إقامة الدولة الفاطمية هو الجانب الاقتصادي، إذ هي محاولة قوية من استغلال النفوذ السياسي والتوسع الاستعماري لإدارة التنوع الاقتصادي في الدولة الحديثة مما يسهل عملية الجباية والاتاوات والرسوم الحكومية لرفد الدولة بالمورد المالي ومن ثم يتسنى لهم التوسع والتوغل في مصر وجنوب قارة أفريقيا.
هذا ! لم يتم التوغل بالصورة المخطط لها لأنَّ نهايتها كانت على خلفاء الدولة العباسية سنة 1171، {يوسف المستنجد بالله (1160 – 1170) ثم الحسن المستضيء بالله (1170 – 1180)} لكن في ذات الوقت تقبَّلت شعوب المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم فكرة إقامة المولد النبوي الشريف وصار عُرْفَاً إلى يومنا هذا.
الجانب الثالث، هو الجانب الاجتماعي المحض، فأغلب السياسات للدول آنذاك وحتى اليوم تستغل الدين لتمرير الأجندات السياسية وتحاول الهيمنة على الشعوب بتلك الطريقة أو ما يعرف اليوم بالإسلام السياسي كما كان الحال في جمهورية السودان في العهد الماضي من تجربة الإسلام السياسي (189 – 2019) من حركة الإخوان المسلمين وفشلت بلا منازع.
تحاول الجماعات الإسلامية أو الدينية بشكل خاص الاستحواذ على مقاليد الحكم في أغلب الأحيان باسم الدين أيَّاً كان حتى إن لم يكن أول ما تدعوا له في برنامجها الانقلابي أو الثوري إن شئت، كما فعل الرئيس الأسبق جعفر نميري (1930 – 2009) إبَّان حكمه للسودان (1969 – 1985) ثم محاولة تمديد أمد الحكم حينما طرح البرنامج الإسلامي بديلاً عن الاتحاد الاشتراكي أو قل: موازياً له تحت إعلان ما عرف آنذاك بقوانين الشريعة الإسلامية سبتمبر 1983 أو ما عرفت شعبياً بقوانين سبتمبر، فلم يستمر في حكمه منذ الاعلان أكثر من عام ونيف ثم أطاحت به ثورة شعبية سنة 1985 انهت حكمه بلا رجعة، أو كما فعل الرئيس الأسبق عمر البشير عندما جاء بانقلاب عسكري أنهى الحكم الديمقراطي سنة 1989 ثم بعد عامين إلَّا قليلاً أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية (1991)، البرنامج الذي بدأه النميري ولم يفلح هكذا يعيد التاريخ نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة.
هذا ! انتهت الدولة الفاطمية سنة 1171 في عهد أمير المؤمنين العاضد لدين الله (1160 – 1171) أخر الخلفاء, وكذلك الدولة العباسية سنة ١٢٥8 في عهد الخليفة أمير المؤمنين عبد الله المستعصم (1242 – 1258) لكن انتشرت فكرة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في كل الاصقاع ووجدت قبولاً منقطع النظير من كل الشعوب العربية المسلمة وغير العربية ومن ثم تواصلت هذه الاحتفالات بأكثر من طريقة لأكثر من دولة.
ثالثاً، رأي الدين في الاحتفال
الدين أفيون الشعوب، كما قال كارل ماركس وأقول: متى ما استُغِلَّ الدين لأجندات سياسية كان افيوناً شعوبياً مهلكاً للحرث وللنسل، وحقيقة الأمر، إنَّ الدين برئ من تلكم التداعيات مع أكيد احترامي لأصحاب الرأي المخالف براءة الذئب من دم ابن يعقوب لكن، لا علاقة للدين الإسلامي بأي حال من الأحوال بإيجازة إقامته حلاله من حرامه، والأمر برمته كما بَيَّنْتُ سابقاً إنَّ الرأي الأول والأخير يصدر من الشعب أو من العرف الاجتماعي لا غير، وأي محاولة لبعض اللذين يستغلون أو يخطئون في فهم مقاصد الشريعة الإسلامية والدين، هي محاولة فاشلة وبائسة وخدعة ذهنية بجدارة أساسها امتلاك المعتقد البشري والتصرف فيه كيفا اتفق، الغرض منها في أفضل الاحتمالات هو ملء الفراغ الفكري والعاطفي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي بجرعة من جرعات الدين الزائدة لذات الأسباب التي دعت ودفعت رجالات السياسة في الدولة الفاطمية قبل أكثر من تسعة قرون أو عليها تزيد أن يوظفوا الدين لأغراض سياسية دنيوية محضة، فيسهل الإحكام عليهم وتطويقهم بكهنوت صكوك الغفران من الحلال والحرام، ويجوز ولا يجوز في حين أنَّ الأمر – تكراراً – ليس له علاقة بتلك الآراء ولا تلك الفتاوي لا من بعيد ولا من قريب.
لا استبعد خيار الناس لإقامة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من تأثر المسلمين بالثقافة المسيحية واليهودية، لأنَّ تلاقح وتلاحم الشعوب آنذاك كانت الثقافات المعتقدية السائدة هي المسيحية واليهودية فتأثَّر بها جمع من علماء الدين الاسلامي أو قل: عامة المسلمين بعدم ممانعة إقامة شعائر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كما يحتفل المسيحيون النصارى بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح، فوافق الشعور الجمعي والعقل الشعبوي والمناخ الملائم مع فكرة طبيعة المعتقد الشيعي في أتون الدولة الفاطمية القادمة من خارج مصر، باعتبار أنَّ مصر هي مركز الهجرات العربية ونقطة مركزية حتى اليوم لعوامل كثيرة منها الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية والتجارة والعلوم الإنسانية والمياه وخلافه، فلم تجد الدولة الفاطمية في مصر اعتراضاً أو ممانعة في طرح الفكرة عِلْمَاً بأنَّ الشيعة أو الدولة الإيرانية اليوم تنتهج منذ قديم الزمان المنهج العقدي لإدارة دولتها، عندما قَلَّل ذلك أو أمسك أو أنهى من نفوذ دولتي فارس والروم في حدود أرض جزيرة العرب ووضع يدهما عليها كما هو معلوم.
هذا التمدد العقدي مع التمدد الاستعماري السياسي الجديد، فتح فرصاً كبيرة لنشر الفكر الشيعي مع نشر الفكر السُنِّي مضاهاة بالمعتقدات المسيحية واليهودية الأسبق للإسلام أغلب الظن وهذا التاريخ يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي الفارسي آنذاك حين توسعت الدولة الإسلامية أو قل دولة الخلافة الراشدة من المدينة المنَّورة أو العراق في كل بلاد الشام ومصر وأفريقيا وأوروبا، مما شكَّل لها تهديداً مباشراً بانتهاء دولتهم وامبراطوريتهم على انتشار الفتوحات الإسلامية العربية واتساع رقعة جغرافية الإمبراطورية الإسلامية الحديثة في العالم.
إنَّ رأي العلماء المسلمين في هذا الباب لهو محل احترام وتقدير بلا شك، لكن ليس ههنا موضع الإفتاء بجوازية إقامة الاحتفال من عدمه وخصوصاً الفئات المتناحرة بين المتصوفة وبين جماعة السلف الصالح فعليهم أن يعلموا جيداً أن لا مُقَام لهم ههنا فليرجعوا إلى حجورهم بلا شنار ولا غبار.
خذ مثالاً : الإمام ابن حجر العسقلاني (1372 – 1449) (77 عاماً)، أجاز الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بشروط معينة معروفة ، أي جاء بعد انتشاره في مصر بأربعة قرون (1372 – 967) فيكون تمام السنوات (403 سنة) وذهب بعض علماء الدين الإسلامي بمذهبين مختلفين فمنهم من جوَّزَه ومنهم من أبطله، لكن حقيقة الأمر، إنَّ الله تعالى يقول في محكم كتابه: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} سورة الأعراف فتمام الفهم والحكمة هي تطبيق الأمر بالمعروف لكل القضايا المختلف عليها لا المولد النبوي فقط.
أمر آخر، يُتَنَاول كثيراً وموسمياً كلما هلَّت بشائر إشراقات الميلاد المجيد في الدوائر الدينية والشعبية هو: إنَّ الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لم يقوموا بأي نوع من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ولا النبي نفسه, فكيف لمن جاء بعدهم فعل ما لم يفعله الأوائل ؟.
هذا السؤال ملغوم بطبيعة الحال، لأنَّ حركة المجتمع المدني تطوراً وأخذت طوراً وأمداً بعيداً في العلوم الحياتية من عهد النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حتى تاريخ بداية انتشار وقيام وقبول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد أربعة قرون وليس في القرن الثالث الإخراجي – بالتحديد سنة 335 خ – إذا اعتبرنا أنَّ النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 634 م، وأنَّ سنة الاحتفال 969، وأنَّ سنة الإخراج النبوي كان سنة 624 باعتبار أنَّ مكوث النبي بالمدينة عشر سنوات (624 – 634) عند الإخراج من مكة، فيكون تمام السنوات 345 سنة بعد إضافة المكوث بالمدينة، أي في القرن الرابع الإخراجي وليس القرن الثالث الإخراجي كما هو مشاع في كتب التراث الإسلامي.
هذا ! بطبيعة الحال حكم الوقت والتطور الاجتماعي المدني الاسلامي والمحلي والاقليمي والدولي إذا جاز التعبير، هو ما أملى على من قاموا به دون الأوائل دون الحاجة إلى الرجوع لعمل السلف الصالح أو القرآن بلا تقليل من شأنهم بكل تأكيد، فهذا الأمر لم يكن مطروحاً آنذاك في العقل الجمي العربي ولا الشامي ولا غيره واعباء الدولة والرسالة لم تسمحا بفكرة الاحتفال من عدمه فلا معنى لأن نُحَمِّل الصحابة والتابعين ما ليس لهم يد فيه كما ليس من المنطق تحميلهم عدم قيامهم بثورة التعليم الرقمي والتكنلوجي المعاصرة وكذلك اختراع الموبايلات الحديثة ولا ركوب المترو بديلاً عن الخيل والبغال والحمير والجمال، فهذه معادلة غير سليمة بالعقل والعلم كما ترى.
رابعاً، الحداثة والصراع الايدلوجي
إنَّ سبب الصراعات الايدلوجية اليوم ومن الزمان الباكر (969 – 2025) {1056 سنة، أحد عشر قرناً}، وبعد ظهور طبقات المجتمع المتدين بعد القرن الرابع الإخراجي وبالتحديد القرن الثاني الإخراجي لبداية ظهور الفقه الإسلامي على مسرح الحياة أو قبله بقليل ، وحتى لحظة كتابة هذه السطور (345 خ – 1447 خ) {1102 سنة أي: اثنا عشر قرناً}، كان سبباً رئيساً في قيام الخلافات العقدية وتعدد المذهبية والطائفية بين شعوب العالم العربي والإسلامي وبالتحديد الصراع بين تلك المسميات المعروفة كالصوفية والسلفيين وخلافه، وأخص بالذكر في السودان أبعد من ذلك، سيطرة المعتقد الديني على العقل الجمعي العربي والإسلامي وبالتحديد في السودان، لهو من أس المشاكل التي تصاعدت ابخرتها في عالم السياسة والاقتصاد والاجتماع إن لم تكن فارقتهم أصلاً وأوجدت وأوعزت خطابات الكراهية والبغضاء والعنف والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد، في غير مظنة حسنة..
فكلٌ يتعصب لرأيه وكلٌ يجمع حوله من الشباب من يؤيدون هذه الفكرة أو تلك، ومن ثَمَّ انتقل الصراع والنزاع إلى كافة طبقات المجتمع المدني لذات الأفكار المتعصبة للرأي فخرج من روح التعظيم والتبجيل والمحبَّة والاقتداء والذكرى للنبي إلى مصاف التفرقة والتحزب والتخندق في مُدَّخَلٍ واحدٍ أو متعددٍ، وكانت النتيجة صفر كبير في رتق النسيج الاجتماعي والتطور التكنولوجي وفرض استراتيجية السلام لإنهاء الصراع والحروب القائمة بلا هوادة حتى اللحظة هذه، فبدلاً عن أن يكونوا دعاة سلام ومحبة، كانوا دعاة حرب أهلية وعصبية لم تفض لغير المزيد من التشققات المجتمعية الإنسانية بسبب أو لآخر.
خامساً، خلاصة مستفادة
هنا أشير لسوء فهم التفريق بين الدين والسياسة والوطن والحزب والمجتمع المدني والعرف والتاريخ والشريعة الإسلامية وخلافه، فكلٌ أُدْخِلَ في بوتقتي الدين والشريعة الإسلامية بغير وجه حق حين أنَّ محلها التاريخ والثقافة والحضارة الإنسانية والأخلاقية بعامة وخصوصاً في السودان.
إنَّ التفريق بين كل تلك المصطلحات العلمية والمهنية والأكاديمية والبشرية لهي مفتاح التخلص من ربقة التعلق بمنح أو منع صكوك الغفران والكفران من بعض الشخصيات والجهات المعنية وبالتحديد المؤسسات الدينية في أي مكان والبلاد العربية خصوصاً، وهي ذاتها مفتاح النجاة من التعصب الديني والرأي المتزمت بلا فائدة وسيظل العرف الاجتماعي هو المصدر الثاني للتشريع البشري بعد القرآن الكريم وبالتحديد البنود العشرة من الشريعة الإسلامية العالمية كما وردت في كتابنا “الفكرة الإنسانية العالمية” فلتراجع في موضعها إن شاء الله.