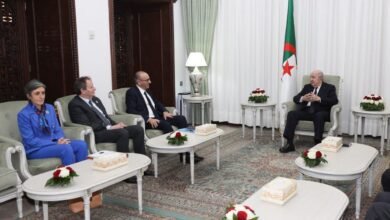في ظل ما تحمله الممارسة البرلمانية من رمزية دستورية ودلالات ديمقراطية، لم يكن من السهل إغفال المعطى العددي الصادم الذي رافق المصادقة النهائية على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
إذ لا يمكن المرور مرور العابر على حضور 62 نائبا فقط من أصل 395 عضوا في جلسة حاسمة، صادق خلالها البرلمان على نص قانوني يمس بشكل مباشر بجوهر التوازنات التي تقوم عليها العدالة الجنائية، ويمتد أثره إلى مواقع حساسة في المشهد الحقوقي والقضائي الوطني.
فأن يصوت لفائدة النص 47 نائبا ويعارضه 15 دون أن يسجل أي امتناع، في غياب 333 نائبا عن الجلسة، أمر لا يترجم فقط خللا في الانضباط البرلماني، بل يكشف بعمق عن اختلال في مفهوم المشاركة التمثيلية حين يتعلق الأمر بتشريعات جوهرية .
ما يدعو إلى التأمل أن النص المصادق عليه لا ينتمي إلى خانة التعديلات الشكلية أو الجزئية، بل إنه يطال مباشرة مفاصل الإجراء الجنائي، ويعيد ترتيب مساحات الفعل المدني في ملاحقة جرائم الفساد، مما جعله مدار نقاش محتدم بين فاعلين سياسيين، ومؤسسات دستورية، وهيئات حقوقية، ومكونات المجتمع المدني الحقوقي المهتمة بحراسة المال العام.
ومع ذلك، فإن الأغلبية الساحقة من النواب ارتضت لنفسها الغياب، مخلفة وراءها علامات استفهام مشروعة بشأن حدود التزامها بمقتضيات النيابة عن الأمة، ليس فقط من باب التمثيل الانتخابي، بل من زاوية المسؤولية الدستورية والأخلاقية أمام المجتمع ومؤسساته.
قد يبدو مستساغا من الناحية الشكلية أن تستكمل المسطرة التشريعية بهذا التصويت، ما دام النص قد حصل على النصاب القانوني، لكن المشكل لا يكمن في الشكل الإجرائي، وإنما في المشروعية السياسية والأثر المجتمعي لمثل هذه المصادقات التي تتم في ظل غياب شبه جماعي.
فحين يرتبط الأمر بتشريع أثار جدلا مجتمعيا واسعا، واصطدم برفض جمعيات حقوقية، وعرف انقساما داخل الأغلبية والمعارضة على حد سواء، فإن من غير المفهوم أن تحسم مآلاته في قاعة تكاد تكون فارغة، وقد غابت عنها أصوات 333 نائبا .
إن ما يخشى من مثل هذه الحالات هو أن تفرغ المؤسسة التشريعية من مضمونها الجوهري، وتتحول أداة التصويت إلى إجراء روتيني تنقصه الحيوية الديمقراطية، ويغيب عنه التفاعل البرلماني الحقيقي.
وفي هذا السياق، لا يمكن اعتبار الغياب الجماعي مجرد موقف سياسي، أو سلوك فردي، بل هو تعبير عن أزمة أكبر تطال العلاقة بين ممثلي الأمة ومتطلبات الانخراط الجاد في العمل التشريعي، خاصة حين تكون النصوص المعروضة ذات أثر بالغ على الحقوق والحريات.
ليس خافيا أن تمرير مشروع القانون المذكور، وما تضمنه من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة، قد أعاد ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مجال تتقاطع فيه مفاهيم الرقابة، والمسؤولية، والمساءلة.
فحين يعاد تحديد من يملك حق الترافع في قضايا المال العام، وتقيد مساحات الدخول المدني على خط الدعوى العمومية، فإن الأمر لا يمكن اعتباره تفصيلا تقنيا، بل هو إعادة هندسة للفاعل في الحقل القضائي، واستدعاء لقراءة دقيقة تضع في الحسبان توازنات دقيقة بين قرينة البراءة وضرورة صيانة المال العام .
لقد سبق لعدد من الفاعلين، من مواقع مختلفة، أن طالبوا بإحالة النص على المحكمة الدستورية، لا من باب الطعن السياسي، وإنما حرصا على تطابقه مع روح الدستور ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، وهي دعوة ما تزال قائمة، ما دام النقاش لم يغلق بعد، وما دامت الأسئلة الكبرى لا تزال عالقة بشأن موقع الجمعيات، وحدود تدخلها، وطبيعة السلطة التي خصصت لها، وكيفية ممارستها لهذا الدور الترافعي.
وإذ يفهم تشبث وزير العدل بمضامين المشروع على أنه دفاع عن رؤية مؤسساتية لتطوير العدالة الإجرائية، فإن ما لا يجب أن يغيب هو أن مسار الإصلاح لا يقاس بنصوص القوانين فقط، بل بمناخات التشاور، وحرارة النقاش، وشروط الحضور النيابـي الكامل، وإشارات الانخراط المؤسساتي في لحظات صياغة القرار العمومي.
ولعل ما حدث في هذه الجلسة هو بالضبط النقيض لذلك، حيث فتح الباب لمصادقة شكلية على قانون جوهري، في غياب أغلب من أوكل لهم الناخبون مهمة التشريع باسمهم.
قد تتيح هذه الواقعة فرصة جدية لإعادة النقاش حول مبدأ الحضور الإلزامي للنواب في الجلسات المرتبطة بالنصوص الكبرى، وتفرض التفكير في آليات تجديد العلاقة بين الناخب وممثله تحت قبة البرلمان، حتى لا يبقى الأداء التشريعي محكوما بمن حضر، ولا تتحول أهم محطات البناء القانوني إلى تمرينات باهتة لا تعكس رهانات المجتمع ولا صوته الحقيقــي .