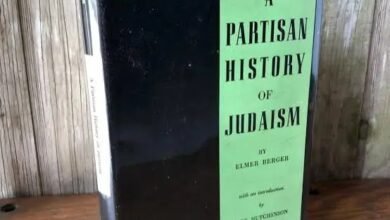مدخل
قال تعالى: {وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون} سورة الأنبياء.
وقال عز من قائل: {وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فهل أنتم شاكرون} سورة النحل.
السربال جمعه سرابيل، والسرابيل هي ما يستر به المرء جسده من ثياب من أي صناعة كانت، إمَّا تُقية البأس فيعني شدة الحرب إذ كانت السرابيل آنذاك تصنع من الحديد للقتال خشية نفاذ السيف أو الرمح أو القنا إلى الجسم فتفسده ومن ثم تحيله إلى الموت المحقق ناهيك مما يتسبب له من آلام مبرحة لوقت طويل.
نبي الله داود، أول من صنع تلك الدروع الواقية من السلاح الأبيض في القرن الألف الرابع قبل الميلاد أي ما يقارب الستة آلاف سنة حتى اليوم.
بحكم التدرج أو التطور الحياتي فقد استبدل لباس الحرب المصنوع من الحديد – والعرب تسميها “لَأْمَة” وقد جاء في الخبر من أهل السير أن النبي في معركة أحد لبس لَأْمَتَه ثم خلعها فجاءه الوحي أن ليس لنبي أن يخلع لأمته بعد أن لبسها، ثم دخل المعركة مقبل غير مدبر – وقد كانت تعبر العرب قديماً عن التأهب للحرب حتى خوضه ونهايته بلبس جلود النمور، كناية عن العزيمة في القتال، أي يمكن أن تكون مرحلة معروفة في تاريخ الحروب عند العرب.
قال الفِنْدُ الزِّمَّاني:
صفحنا عن بني ذهل \*\*\* وقلنا القوم إخوان
عسى الأيام أن ترجـ \*\*\* ـعن قوما كالذي كانوا
فلما صرح الشر \*\*\* وأمسى وهو عريان
ولم يبق سوى العدوان \*\*\* دناهم كما دانوا
شددنا شدة الليث \*\*\* غدا والليث غضبان
بضرب فيه توهين \*\*\* وتخضيع وإقران
وطعن كفم الزِق \*\*\* غذا والزق ملآن
وفي الشر نجاة حين \*\*\* لا ينجيك إحسان
وبعض الحلم عند الجهل \*\*\* للذلة إذعان
هذا! إلى لباس يميز المقاتل من غير المقاتل كما هو الحال في الزي العسكري النظامي أو شبه النظامي اليوم، ثم عرفت فيما بعد باسم المهمات الخاصة لمنتسبي أي قوات عسكرية في العالم ويحمل بجانبه – أي المقاتل – السلاح الأبيض آنذاك، وحتى القرن التاسع عشر إبَّان الثورة المهدية في السودان (1881 – 1898) كان الحال كذلك، ثم تغير الوضع إلى حمل السلاح الناري إضافة إلى أجهزة اللاسلكي وهواتف الثريا أو ما أشبه.
فكرة الموضوع
الزي الوطني – الهُويَّة السودانية
بصورة عامة، هي الجلابية البيضاء، ثم دخلت العولمة وتطورت الأوضاع في الحياة وجُعِلَ معها اللباس الافرنجي القميص والبنطلون، الذي جلبه الافرنج والأجنبي لبلاد السودان منذ وقت ليس بالطويل، لتمييز الموظف الحكومي أو المستعمر بلباس خاص من المواطن العادي، ثم جعل معه أيضاً الزي القتالي وهو الرداء القصير مع الجاكيت والطاقية بصناعة متقنة ومتقدمة ومن ثم أحيل إلى اللباس المعروف اليوم للقوات المسلحة مع حذاء معين.
أيضاً، كان للطلبة قديماً زيَّاً معيناً وهو الجُلْبَاب مع لفة الرأس المعروفة بالعُمَامَة وتحتها الطاقية مع أي حذاء كان، ثم تغير الحال إلى الرداء القصير ومعه القميص، ولحقه تبديلاً البنطلون مع القميص ذي اللون المعين الخاص بالتعليم الحكومي، قال الحجَّاج بن يوسف، مستشهداً بقول سُحيم بن وثيل الرياحي: أنا بن جلا وطلَّاع الثنايا متى أضع العُمَامَة تعرفوني
وكان النبي يعتمر عمامة بيضاء وقيل غير ذلك وهنا موضع الاستشهاد من معرفة العرب منذ القِدم بلباس العُمَامَة.
هذا! عادة ما يلبس الرجل السوداني الجُلْبَاب / الجلَّابية / الأبيض اللون الغالب على عموم الشعب السوداني، قال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيماً} سورة الأحزاب، وقال أبو الطيب المتنبي:
من الجآذر في زي الأعاريب \* حمر الحلي والمطايا والجلابيب
أنا هنا أردت من هذا الاستطراد الاستدلال اللغوي والدلالي على التأصيل لمفردة الجلابية السودانية يا هداك الله.
هذا! ومعها من الملحقات ما يعرف بـــــ “العَرَّاقِي” المصنوع من القماش ذي الغزل الخفيف الذي عادة ما يكون لباساً منزلياً ما عدا إذا خرج به الرجل إلى الأماكن العامة فهو معيب ومعير، والسروال الواسع الذي تحزه ما يعرف بـــــ “التِكَّة” لضمان تثبيته على الخصر وسط الجسم كأنه حزام لكنه مصنوع من القماش من ذات عينة قماش الجلابية وربما يختلف في الصناعة التقليدية ويستورد من بلاد الصين ما يثبت باللِسْتِك على الخصر، ثم المركوب المصنوع إمَّا من البلاستيك أو جلود الحيوانات وأهما النمر والثور والأفعى.
وقد عرفت بتلك الصناعات بلاد غربي السودان من تخوم أفريقيا لكثرة ووفرة ما هو موجود من الصيد الجائر، قال تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون \* ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون \* وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرءوف رحيم \* والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون \* وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين} سورة النحل، فتؤخذ هذه الجلود بالدباغة والتشكيل بتعدد وتنوع الصناعات التقليدية المحلية وعند الفائض يُذهب بها للتجارة، وأغلب الظن أن بلاد السودان الشمالي أو بقية ارجاءه عرفت هذه الصناعات من بلاد غربي السودان والله أعلم.
ثم العُمَامَة التي توضع على الرأس وكانت معروفة منذ قديم الزمان كالخوذة عند رجال الجيش قديماً والأجهزة النظامية الأخرى فيما بعد مع اختلاف في الاستعمال والتصنيع بطبيعة الحال، والشال، الملائم للون للجلابية وغالباً ما تطرز حوافه بألوان زاهية تزيد من الثقة في النفس والزهو في المشي، ومن ثم لزيادة الزينة عند الرجل السوداني أن يحمل معه عصا مصنوعة من خشب الزان أو المهوقني أو التك المستجلب من بلاد جنوب السودان إذ هو أجود أنواع الأخشاب المستخدمة في هذا الباب لملمسها الناعم جداً ولطريقة النحت والزينة فيها ذاتها بطريقة أكثر من رائعة وذات وزن ثقيل لكن يسهل حملها، وفي الجانب العسكري يحمل المقاتل عصا قصيرة لا تتجاوز الستين سنتاً تكون خفيفة الوزن للتلويح والإشارة والتحية.
العصا مذكورة في القرآن أكثر من مرّة، وأشهرها عصا موسى بن عمران، ومن معه من سحرة فرعون، وعُرِفَت العصا من قديم الزمان، وأول من أبرزها هم اليونانيون الذين زاروا بلاد الأحباش قبل خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، ذكرها هيرودوت الاغريقي، وعرفها العرب بحكم المجاورة والمعايشة، ثم كنَّتْهَا صناعة موضع المقبض من اليد ما أشبه برأس العَنَزَة في القرنين والوجه أي كل الرأس.
وقد ذكرها البروفيسور / جعفر ميرغني، أستاذ التاريخ والحضارة بالجامعات والمعاهد السودانية في إحدى محاضراته القيمة باليوتيوب، فلتراجع في موضعها إن شاء الله، أنواع الجلاليب الأخرى، خلاف الجلابية السكروتة، أبرزها جلَّابية الأنصار المسماة “عَلَىَ الله، أو عَلَا الله”، أو “عَلَلَّلَهْ” اختصاراً، وهي تلبس بالاتجاهين، قصيرة مع سروال قصير وكُمَّيْنِ قصيرين.
وقد كانت إبَّان الثورة المهدية ترقَّع بألوان مختلفة لتميز المقاتلين من غيرهم أو الأنصار من غيرهم من بقية الشعب، ويحمل الانصاري بجانبها الحربة المُدَبَّبَة الحديدية في شكل مثلث، ذات الساق الخشبية المصنوعة من شجر القنا النباتي، وأذكر أنني لبستها سنة 1984..
ولم اتجاوز التاسعة من العمر، وكنت أدرس في المرحلة الابتدائية بمدرسة بيت المال الابتدائية بأم درمان، الصف الرابع، وقد ألزمتنا الأستاذة الفاضلة نفيسه بهذا الاحتفال، إلَّا أنا، نسبة لحجمي الصغير وبنيتي الضعيفة، لكنني أصررت على المشاركة مع بقية الطلبة، فقبلت بعد جهد جهيد مشاركتي المتواضعة، هذا! كان احتفال الأنصار بذكرى المولد النبوي الشريف، أو ذكرى الإمام المهدي، أو الاستقلال، لا أذكر على وجه التحديد.
لكن الغالب هو ذكرى الإمام المهدي، لأن المسيرة انطلقت من بوابة عبد القيوم في الجهة الجنوبية لأم درمان، وحتى حي ود نوباوي في الجهة الشمالية لها، وأقيم في مدينة أم درمان حي الملازمين، معقل حزب الأمة القومي والأنصار، بعض الاحتفاء، ثم نهايته كانت عند مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي بود نوباوي في حي الهجرة، لكنني سرعان ما انسحبت من المسيرة، بدون مبرر يذكر، عالباً من التعب وخوفي من الأحصنة التي كانت تلازمنا طيلة المسير، الله أعلم أيُّ ذلك كان، وأذكر أنَّ العمَّة المرحومة النعمة العتاق – رحمها الله رحمة واسعة – قامت بخياطة وحياكة الجلابية الأنصارية القديمة ذات الرقع الملونة من الجهتين الخلفية والامامية، بإتقان وصبر شديدين.
عرفت فيما يعد ميلها للأنصار، لأنَّ لنا فيها واقعة عرفت بواقعة المتمة يوليو 1897، ما زال الأنصار يلتزمون بهذا الزي المميز عن الآخرين، ولهم فيها ولع ومحبة وقدوة من الإمام المهدي الكبير، أمَّا الطائفة الأخرى، هي طائفة الختمية، ولهم زي بحمل ذات المضامين المعنوية كما الأنصار، ويغلب عليها اللون الأبيض، عدا تلك التي وافتها الحضارة والمعاصرة، فيتعدد اللون مع الاحتفاظ بالشكل العام بنمط منموط.
لكنها ذات لياقة بارزة وأزرار (زراير) حتى العنق، مخيطة بطريقة رائعة للغاية، وكنت قد حاولت لباسها، لكن لم يستقم لي الأمر، فارتضيت بقراءة “المولد البراق” زمنا طويلاً وكثيراً، بمساجد الختمية ببيت المال والملازمين في أم درمان، وكان يعجبني حد الفتنة لما فيه من وصف رقيق ودقيق لمولد النبي عليه السلام، هذا! تلبس الجلابية الختمية مع عمامة ملفوفة على الرأس دائرية، ليس لها ذوائب أو ذيل كما هو الحال في الزي العام القومي السوداني، بل قصيرة وتلف بإحكام على الرأس، وربما صاحبها شال أو عصا، أيهما كان من ذات معدن الصنع، طريقة اللبس في المديريات، في شرق السودان، يرتدون معها ما يعرف بالصديري، وهو عبارة عن قميص قصير مفتوح من الأمام ليس له أكمام، مصنوع بطريقة معينة..
نوع من الهُويَّة الوطنية المناطقية أو التمييز القبلي للسَكْنَى المقيم بشرق السودان، ويحملون معها السيف أو السلاح الأبيض، في ثقافة تنم عن العادات والتقاليد الاجتماعية هناك، وأغلب الظن أنَّ هذه الطريقة من اللبس وفدت إلينا من بلاد اليمن السعيد، نسبة للتداخل القديم العميق الذي يربط ما بين سكان شرق بحر القُلْزُم، وهم اليمانيون، وسكان شمال الجزيرة العربية، وما بين سكان غرب بحر القُلْزُم، وهم السودانيون، ويطلق على تلك المناطق الحدودية، ذات العامل التجاري الأبرز، ثم المصاهرة والمزاوجة، وما تاخمها من حدود بعيدة ببلاد الحبشة أو الأحابيش، ولهم سوق معروفة في مكة المكرمة، تعرف بسوق حُباشة، راجع كتابي “من حديث الشعر والنثر” لمزيد من التفاصيل.
وقد يجلبون تلك الأقمشة من بلاد اليمن، أو من بلاد الهند، مروراً باليمن، ومن ثم إلى داخل حدود القارة الأفريقية، إلى بلاد السودان الحديث، أمَّا في غربي السودان ووسطه وشماله، فقد تتشابه في الملبس مع بعض الاختلافات الطفيفة القبلية أو المناطقية فقط للتمييز لا التعالي بينهم، إذ يغلب على أهل المديريات الشمالية والوسط لباسها مع العَرَّاقِي والسروال، لكن في الغالب الأعم لا يتقيد سكان أهل الغرب بالعراقي مثلاً، أمَّا في جنوبي البلاد..
فقد تعرف اللبس القبلي خلاف القومي باللَّاوي، وهو لباس أو ثوب يلف من أعلى الجسد لأسفله، ويربط عُقْداً مع الكتف، ويتكون من قطعة قماش واحدة متعددة الألوان حسب التنميط القبلي، لكن أهل جنوبي سنار والنيل الأزرق، فبعض القبائل تلبسها، والآخر لا يكون عليه ثياب إلَّا ما يستر العورة، كقبيلة أم بررو، ولقد شاهدتم رأي عين حينما كنت أعمل في التعدين هناك قبل خمسة عشر سنة تقريباً، الزي القومي النسائي في السودان، لن أجلب التمر إلى هَجَر، فأعيد من القول ما هو معروف، قال زهير بن أبي سُلْمَى: ما أرانا نقول الا مُعَارا، أو مُعَادا من قولنا مكرورا، وهَجَرْ هي دولة قَطَر اليوم، وكانت تعرفها العرب قديماً بهَجَرْ – بفتح الباء المعجمة والهاء المهملة – لبعدها الشاق عليهم من أرض الجزيرة العربية إلى هناك، ثم قلة حاجتهم إلى تجارتهم فيها، ولكن كانت تهاجر إليها رغم ذلك على فترات متقطعة، إذ أغلب رحلاتهم بين الشام في شمال جزيرة العرب، واليمن في الجنوب منها، ولك أن تلاحظ كلمة تُهَاجِر من هَجَر، أي ترك وغادر، إذا كان المهاجر يقصدها، بينما يصطلحون على هجرتهم نحو الشام واليمن بالرحلة.
كما وصفها الحق عز وجل في قوله تعالى: {لإيلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} سورة قريش، بينما وردت الإشارة إلى قَطَر في لفظ هَجَر في الحديث الصحيح في صفة نهر الكوثر، فقال عليه السلام: [طوله ما بين صنعاء اليمن إلى حضرموت، وعرضه ما بين بُصرى الشام إلى هَجَر]، فتأمَّل أصلحك الله، أنا استطردت هذا الاستطراد لأبيِّن لكم طبيعة الزي القومي النسائي في السودان، وهو الثوب الأبيض في الغالب الأعم، وما زال يلتزمه الإخوان الجمهوريون حتى الآن، وهو ضارب في القدم، لكن ليس كما جاء في الإنترنت من أن له أكثر من عشرة آلاف سنة، فهذا خطأ!.
والصواب أنه انتقل إلينا عبر الهجرات السابق ذكرها، كالزي العربي القديم في الجُلْبَاب في فترة لا تتجاوز الثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، وإلى يومنا هذا، يعني قرابة الخمسة آلاف سنة من الآن، فنازلاً قبل الميلاد / ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، وألفين بعد الميلاد، راجع كتابي “من حديث الشعر والنثر” لمزيد من التفاصيل حول الموضوع، المسميات عبر السنين، في كل حقبة زمنية يطلق على الموضة اسماً معيناً، تماشياً مع تطورات الأوضاع في الساحة الحياتية، فمثلاً، أشهر هذه الثياب هو ثوب “الزَرَاق”، والذي كرهه الدكتور حسن الترابي، راجع اليوتيوب، لقاءه مع قناة الجزيرة 2007.
واعتبره من تخلفات العصر، ولا يشير إلى أي هُوُيَّة قومية خلاف العادات والتقاليد الاجتماعية السالبة الجامدة آنذاك، فزعم بالتجديد في كسر المفهوم السائد آنذاك، بوجوب ادخال الثياب الحديثة الموضة إلى النساء، بينما تلبسه النساء في مصر في مناسبات الأتراح حتى يومنا هذا، تعبيراً عن حالة الحزن، بينما في السودان، تعبيراً تقليدياً طبيعياً لحياة طبيعية كما العباية مثلاً، كما كان يعرف اللباس الداخلي القديم – أندر وير، الآن – للمرأة بــــــ “الكَمْفُوْسَة”.
وهي عبارة عن خِرْقَة من القماش البالي، تستر بها المرأة عورتها، وأقرب ما يكون إلى حبل الرَحَط المصنوع من جلود الحيوانات، على شكل سيور مجففة ومنفصلة عن بعضها البعض، أو حبال جلدية رهيفة وطويلة كالتي تلبس في طقوس الزواج، ويسمى بقطع الرَحَط، وقد استمر زمناً طويلاً إلى وقت قريب، أمَّا الطَرْحَة.
فهي عبارة عن غطاء تستر به المرأة رأسها، كما عند الرجال من عُمَامَة، وهذه الطَرْحَة كانت معروفة منذ القِدَم، من قبل ميلاد المسيح عليه السلام، والراهبات المسيحيات هم أكثر الناس احتشاماً والتزاماً بها، لما عندهم من تأثير بالسيدة مريم العذراء، من تعهدها بالطَرْحَة الطويلة، التي تغطي الرأس وصولاً إلى أدنى الصدر من الأمام، وتعرَّف عليها أهل بلاد الجزيرة العربية، بحكم الاختلاط والمعاملة والتأثير والتأثر، لما فيها من الحشمة والوقار، ثم تطورت بطبيعة الحال إلى ما يعرف بالخِمَار، الذي يغطي الرأس والوجه، المعروف اليوم بالنقاب.
لكن ليس له أصل في الإسلام، وما أشارت إليه الآية: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} سورة النور، يقصد بها تغطية الفتحات من الجسم، الجيب يعني الفتحة من جهة واحدة فقط، غير النافذة إلى ما سواها، والخِمار من المخامرة أي العادة، وتشير إلى الطَرْحة المذكورة آنفاً، ومنها ثوب أبي قجيجة، في منتصف القرن العشرين، وأحدث ضجة كبرى من ناحية التسويق، وكسر النمطية السائدة بشكلها القديم، ومنها المقولة الأشهر (ثوبك عينة يا بثينة).
يريدون بها زوجة الرئيس الراحل جعفر نميري – رحمهما الله رحمة واسعة -، وعندما سئل عن لماذا تلبس هذا الثوب الفخيم، فيما نما إلى علمي، قال: (انتو قايلنها مرة نجَّار)، يعني: أنتم تظنونها زوجة نجَّار؟ هي زوجة رئيس الجمهورية، فلماذا لا تلبس الجديد من الموضة؟، ومنها أيضاً ثوب الفَرْدَة، المنسوج بإتقان من القطن المغزول بمهارة فائقة، ويغلب عليه اللون الأبيض الداكن قليلاً، ومعمولاً بما يعرف آنذاك بــــــ “المُتْرَار”، قبل دخول الإبرة وماكينة الخياطة الحديثة سنجر وما أشبه إلى سوق الثقافة اليوم، ثوب الزفاف، يلبس في مناسبات الزواج فقط، وربما حديثاً في مناسبات التخرج في الجامعات والمعاهد العليا، وفيه طقوس جميلة ومحبَّبَة إلى النفس للغاية، كثوب الجرتق مثلاً، والمصنوع بألوان زاهية مع اللون الأبيض واللون الأحمر، فتزيد من الثقة في النفس والزهو بين الحضور، الآن، تغير الوضع كثيراً، واستعيض عنها باللباس الافرنجي، كالكارينا الداخلية – تعرف عند العرب قديماً بالمجسد أو المجاسد، وهو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، كالستيانة والقونلة واللباس الداخلي المعروف حديثاً مثلاً –، ورُبَّما تلبس فوق اللبس الذي يلي الجسد مباشرة، في شكل بلوزة ضيقة ملتصقة جداً مع الجسم، أو ما يعرف بالاسكيرت والبلوزة، على شكل قميص صغير، من أساليب الحداثة العالمية اليوم.
خروج، “يا بلدي يا حبوب”، كلمات الشاعر / سيد احمد الحردلو، غناء الفنان / محمد وردي، عشانك بقاتل الريح، عشانك فؤادي جريح، عشانك أنا مقتول، وبموت معاك مقتول، عشانك يا حزن نبيل، عشانك يا حلم جميل، عشانك يا بلد، يا نيل، يا ليل، يا سمح يا زين، يا بلدي يا حبوب، أبو جلابية وتوب، وجبة وسديري، وسيف سكين، يا سمح يا زين، يا وجه مليان غنا، مليان عشق وحنين، يا بنت يادوب، نهيداتا قايمين، شايلين تخا وفي رخا، شايلين بنات وبنين، يا سمح يا زين، يا آهة يا نمة، يا مدحة يا عمة، يا واحة في الصحراء، يا خصلة يا قمرة، يا بشارة يا بكرة، يا سمح يا زين، يا غابة قمحية، زي الصباحية، يا مزرعة باباي، غضبة الهبباي، يا نخلة مسقية، من ريق دبيشية، يا مقطعين دوباي، نازلين على الدنيا، أشواق وحنية، يا سمح يا زين، يا ليل ليل وليلية، يا نيل ونيلية، يا مرمي تحت الشمس، للقيلة ضلية، يا سحنة نوبية، يا كلمة عربية، يا وشمة زنجية، هذا! تظل العادات والتقاليد الاجتماعية السودانية، لا تبرح مكانها بسهولة، إذ لا يزال الحفاظ عليها أمداً بعيداً من الدهر، رغم الضغط الحداثي، بأثر الميديا والوسائط الرقمية الحديثة، لتحويل الفكر المتعارف عليه، إلى ابتكار أنواع وأساليب مختلفة جديدة، بطبيعة التطور الحياتي، ونجد أكثر المحافظات والمحافظين على التراث الشعبي السوداني، هم من الأطراف، بينما الإيقاع السريع نحو التغيير، يكون في العواصم للمديريات، والعاصمة الخرطوم على وجه الخصوص.
ملحوظة، هذه الكلمة مهداة للدكتورة / سلمى عبد المنعم تمن، الباحثة المجتمعية المتخصصة في الزي والتراث الشعبي التاريخي القومي السوداني.