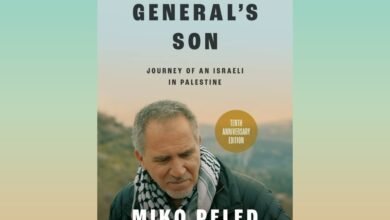منذ أن أدرك الإنسان أن الزمن لا ينتظر أحدًا، نشأت في الوعي البشري فكرة التقدم؛ ذلك السعي المستمر نحو تجاوز الذات، نحو مستقبل أكثر حرية ومعرفة وعدلاً. غير أن التأمل في الوضع العربي اليوم يبعث في النفس سؤالًا حارقًا: هل توقف الزمن عند العرب؟ وهل يعود هذا التوقف إلى تخلف حضاري ذاتي، أم إلى قوى خارجية فرضت عليهم عزلة عن حركة التاريخ؟
بدايةً، علينا أن نفكك المسألة: الزمن، بمعناه الفلسفي، ليس مجرد تعاقب ميكانيكي للساعات والأيام، بل هو حركة للوعي نحو معانٍ جديدة، نحو إبداع مستمر للذات والعالم. التقدم إذن ليس آليًا، بل هو ثمرة قلق وجودي، وشك متجدد، وتمرد على الجاهز والثابت. من هنا يبدو أن تخلف العرب، بالمعنى الفكري والاجتماعي، هو نوع من الاستقالة من الزمن، انسحاب من مغامرته المفتوحة نحو مستقبل مغاير.
لكن، كيف نفهم هذا التخلف؟ هل هو مجرد تخلف مادي عن الإنجازات التكنولوجية والعلمية الحديثة؟ أم أنه بالأحرى تخلف روحي وفكري أعمق، أصاب البنية العقلية ذاتها؟ الواقع أن التقهقر العربي لا يكمن فقط في فقر الإنجاز، بل في تعطيل آلة السؤال: سؤال الحرية، سؤال العدالة، سؤال المعنى. كأن الوعي العربي علق في حلقة مغلقة من التكرار والاجترار، يعيد إنتاج الأجوبة القديمة على أسئلة لم تعد تطرح، وكأنما الزمن قد توقّف عند لحظة منسية، لا حياة فيها سوى للتقليد والماضي المنهار.
تاريخيًا، عرف العرب وهجًا حضاريًا حين كانت روح السؤال مشتعلة فيهم: عصر الترجمة، عصر الفلسفة والكيمياء والرياضيات والطب، عصر كان فيه التقدم مغامرة عقل لا يهاب المجهول. ثم جاءت لحظة الانغلاق، حين غُلب النقل على العقل، وتحول الدين من تجربة روحية إلى مؤسسة سلطوية، وابتلع الخوف روح المبادرة.
هنا بالضبط بدأ الزمن يتجمد: حين توقفت الرغبة في المغامرة، وتجمد الفكر في قوالب فقهية ولغوية وسياسية مغلقة.
ومع الاستعمار، ومع الهزائم السياسية والخيبات المتكررة، ترسخ هذا الجمود. لم يعد الحاضر مجالًا لصناعة المستقبل، بل ساحة للحنين إلى ماضٍ متخيل، واستبطان عميق لفكرة العجز. كل محاولة للنهوض كانت تصطدم بعوائق داخلية من التخلف، وخارجية من التبعية، مما جعل الزمن العربي وكأنه يدور في حلقة مفرغة: كلما أطل مشروع تحرري أو نهضوي، قُمع أو فشل، فعاد العرب إلى اجترار خطاب الضحية وانتظار المعجزة.
فهل معنى ذلك أن الزمن العربي قد انتهى حقًا؟ أم أن هذا التوقف هو حالة مؤقتة، مرهونة بإعادة إشعال شرارة السؤال؟ لعل الزمن، في أعمق معانيه، لا يتوقف أبدًا؛ بل نحن الذين قد ننسحب من حركته، فنصبح كائنات معطلة داخله. والمفارقة أن الجمود نفسه ينتج أشكالًا جديدة من العنف والتفكك، كأن الزمن، إذ يُهمل، ينتقم بإطلاق قوى الخراب بدل قوى البناء.
إن العودة إلى الزمن ليست عودة إلى عقارب الساعة، بل إلى حركة الوعي: إلى الجرأة على التفكير، على النقد، على الابتكار. العرب لن يستأنفوا الزمن إلا إذا حرروا عقولهم من أسر الخوف، وقلوبهم من عبادة الماضي، وأرواحهم من انتظار المخلصين الزائفين. وحدها الحرية، بوصفها شغفًا بالعقل والحياة، تستطيع أن تعيد الزمن إلى مداره الحقيقي.
وهكذا، فالسؤال الحقيقي ليس: هل توقف الزمن عند العرب؟ بل: هل نملك الشجاعة لنكون أبناء الزمن، بدل أن نظل أسرى أطلاله؟