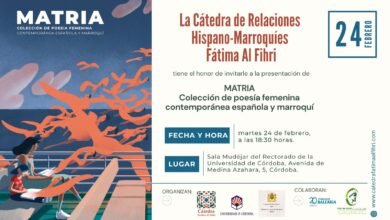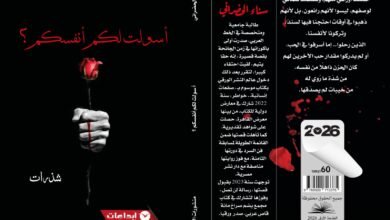إنّ الفلسفة لا تلتقي مع الكيدية والحقد، لأنّها في الأصل محبة الشيّء الأهم في المعرفة والاجتماع: محبّة الحكمة.
ومن هنا، تلعب المشاعر دورا مهمّا في قيام الفلسفة الصحيحة، باعتبارها محبّة وشوقا للحقيقة والحكمة. ومن هنا، أؤكّد على أنّ قيام التّعقُّل الصحيح لا يستغني عن المشاعر الصادقة.
يحدث هذا في الفلسفة والعلم، فالمشاعر النّقية والتّوق إلى الحقيقة ومحبة الحكمة هي متراس أساسي للعقل، ما لم نواصل خطيئة العقل اليتيم والمجرد خلف أسلاك الانفعالات.
ما جعلني أستنتج هذا الدور الفائق للمشاعر النّقية ودورها في تسهيل مهمّة العقل، هو أنّ المفاهيم الكبرى التي اهتدت إليها آراء أرباب الحكمة، تتعرّض للاستغلال، بل إنّ المشاعر النّقية في تحالفها مع العقل وحدها تستطيع كبح المغالطة وإخراجها من بيئة التّعاقلات البشرية.
وبما أنّ الفلسفة ليست جدلا نظريا خارج الواقع والمتوقّع، فهي اليوم تحمي الحقيقة من الإسفاف، بل هي الحاسم في معركة التحرر الكبرى، التحرر الذي يبدأ من الضمير.
وعليه، سأقصّ عليك بعضا من هازم المُغالطة:
– إنّني حقّا أُثمّن حكاية الحبل الممدود بين قردية الكائن وإنسيته. ولنيتشه صولات حول هذا الترنّح الأنطولوجي لكائن هارب من إرادته الحرّة. بالفعل، ما نشاهده اليوم يؤكد أنّ الأنسنة زيف مُضاف إلى سجلّ قرد مخاتل، قد تكون القردة، في نظر نيتشه، أكثر طيبة من أن تكون أصلا للإنسان؛ في شروطه ومآلاته اليوم. فالقردة لا تنحطّ تحت ما خُلقت له وما ينبغي لها.
غير أنّ كافكا سيكشف قبل هذا التباسط في صناعة المعنى، حكاية القرد الهارب من القهر نحن هوية متأرجحة:ليس قردا متصالحا مع قرديته ولا إنسانا حرّا، ما عدا خضوع قهري لشروط مناقضة لإرادته، تلك التي يسمّيها البعض أنسنة، بينما وجب القول، بأنّ المسار المتبع في مسمى هذا الانعتاق، هو رحلة النسنسة، التنكّر، الهروب، الضّحالة، إنّ الأنسنة هي الشروط الجديدة لقرد في حالة هروب كما يوحي التقرير القردي إلى الأكاديمية.
– لنتحدّث عن القضية المُلحّة اليوم، قضية الحرب التي لا زالت تستمد شرعيتها ومبررها الدّموي من الأفكار الكبرى المؤسسة للتفوّق العرقي والعنصري. منذ فجر العصر الجديد والتقنية تبحث عن رقبة كائن ارتهنت هويته لعقد إذعان مثقل بشروط التفكير ضدّ إرادته. نقلت التقنية المجتمع من النمط العبودي الكلاسيكي إلى العبودية التقنوية، أي الاستلاب التقونوي. هنا بات الوجود على المحكّ، وهنا بالفعل داهم الذهن البشري النسيان الأونطولوجي، ودخل في وهم كبير.
أعود إلى الحرية، فهي وإن كانت نتيجة الانفعال كما ذهب ديفد هيوم، وليس العقل، فلأنّ العقل بالمفهوم الهيومي محدود ويكاد يكون حالة ناذرة في سلوك البشر المدين للانفعال في كلّ موقف. عذرا، لكن في نظرنا كيف يتميّز الإنسان العاقل بهذه الملكة إن كانت ستكون مجرّد زائدة دودية أو ذات وظيفة محدودة، ومحصورة في الضرورة؟
إنّ المشكلة تبدأ حين نعتبر أنّ العقل مجرد، وهو يشغل مساحة منفكة عن سائر انطباعاتنا وانفعالاتنا. أليس هذا التعريف هو ما حكم في الأصل على العقل بالاستقالة؟
فكيف إذن نحرر العقل من انفعالاتنا نفسها، وما هو الدافع والحاجة لتحرير العقل من الانفعالات التي تنتج هذا الغمر من المغالطات التي بها نحيا، وهي، أي الانفعالات، لن تملك إنتاج المغالطة دون استعباد العقل ضمن شروط تقرير إلى الأكاديمية، أي حين تصبح حربا على الإرادة نفسها.
إنّ الانفعال نفسه محكوم بالضرورة وليس العقل وحده.
إنّ الكائنات التي آثرت المغالطة في تدبير تفاكُرها ومعايشها، هي واقعة تحت قهر اختيارات وميول ومصالح مُلحّة. فحين يُستلب الكائن، فهو يستلب كلّيا، إذ حتى عقله يصبح فاعلا ومنفعلا بشروط موضوعية للبيئة، فيصبح العقل مقيدا بقواعد تفكير تنحو منحى “قرد” كافكا. ويبدو أنّ مثل هذه التقارير هو الأفق الذي انتهى إليه تكوين العلم وبنيته.
إنّ مقاومة المغالطة والتحرر منها أمر بالغ الصعوبة. ولكننا ندرك أنّ للمغالطة في الذروة تبلغ حالة السُّكر والهذيان، وهنا وجب الانقضاض عليها واجتثاتها، للتفرغ لسيل عارم جديد من المغالطات، حيث العقل ليس في وضعية مريحة، بل هو في حالة مقاومة دائمة، وأنّ تحرير العقل هو مشروع لم ينته، وبأنّ المغالطة تنتعش بوجود الغفلة والنّسيان، وهي وحدها تمتعض من المقاومة في العقل والاجتماع، وهكذا المقاومة ضدّ الاحتلال هي امتداد لمقاومة العقل ضد المغالطة، فكلاهما حركتان تحرريتان.
مع بروز دور الذكاء الإصطناعي، ذكاء يقع في المدى الذي حدده تقرير إلى الأكاديمية، خضوء تقنوي لأسوأ أنماط التفكير البشري، القياسية اللّعينة التي تنتج الإسقاط والتّقمص في النّظر والعمل. تزداد المغالطة بوسائل تقنوية، تعزّز الكسل واستقالة العقل من جهة، وتجعل مهمّة مقاومة المغالطة أصعب من أي وقت مضى.
ذلك لأنّ ما يسمّى “وجهات نظر” بات وسيلة على الحقيقة، لأنّ الموضوعية نفسها باتت وجهة نظر، فكيف يقوم إذن اجتماع بشري خارج قهر المُغالطة؟