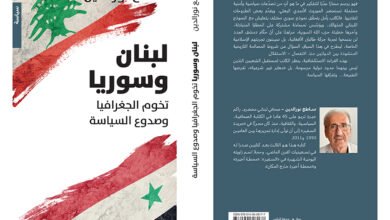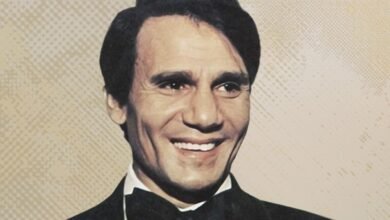جهان نجيب
تختلف مرحلة البحث في المجال التداولي الإسلامي عن باقي المجالات الأخرى الغربي المسيحي مثلا، فبينما نستهل دراسة التاريخ المسلمين بداية القرن السادس ميلادي ظهور الدين الإسلامي، فإن دراسة المجال التداولي الغربي المسيحي مثلا يمكن البحث فيها على ما قبل المسيحية ما دمنا نبحث في الدين من خلال الإمبراطورية الرومانية التي لم يكن العالم منقسما إبان بداياتها الأولى إلى شرق وغرب.
فلم يكن المجال الإسلامي الديني يعرف بدايات صراعية مع الدولة، حيث إن هذه الأخيرة لم تكن موجودة في البيئة التي انبعث فيها الإسلام، فما دام الدين المسيحي انبعث في ظل وجود دولة إمبراطورية قوية، دخلت معه في صراعات امتدت لقرون ثلاثة من حيث إن صراعه كان مزدوجا مع الإمبراطورية التي تدعم الأوثان ومع المجتمع الذي يقدس الإمبراطور ويرفض عبادة آلهة غير مرئية.
اقتضت الضرورة الأكاديمية أن تتم دراسة المجال الديني الإسلامي من أجل البحث عن المتشابه وتسليط الضوء عن التاريخ الديني والسياسي في الفكر العربي المعاصر لفهم هذا التاريخ يدعونا التحقيب الكرونولوجي إلى تعقب مراحل تطور المتخيل الديني بدءا من العصور الوسطى وصولا إلى العصور المعاصرة.
من سيمات التجربة الإسلامية المبكرة أن معالمها السياسية والدولتية تشكلت من غير تقاليد سابقة لها. ففي اللحظة التي أنبعت فيها الإسلام لم يكن لدى العرب من تجارب سياسية أو مؤسساتية خارج ما كرسته الممارسة القبلية، كما أن معتنقي الديانة الإسلامية الأوائل والمنافحين عنها لم يكونوا في مواجهة السلطة الإمبراطورية، كما في التجربة المسيحية وإنما كانت المواجهة منحصرة داخل المجتمع المنقسم إلى قبائل وفروع.
بل إن المواجهة امتدت إلى داخل السلالة الواحدة والأسرة الواحدة، وبهذا لم يواجه النبي محمد {ص} لحظة بعثته إشكالية الدولة أو السلطة، أو كان همه الوصول إلى السلطة أو إزاحة نظام حكم، من أجل تكريس نظام سياسي مغاير، وإنما غاية ما كانت تهدف إليه التجربة النبوية في بداياتها، هو انسيابية الدعوة الدينية وتحقيق الانتشار الأوسع.أما بعد التجربة النبوية فإن الوضع قد تغير نسبيا، حيث ظهرت بوادر سياسية وسلطوية لدى المسلمين، وتشكلت لديهم رغبة في تنظيم أنفسهم وهو ما طرح عليهم سؤال خلافة الرسول {ص} وطرق اختيار من يتولى هذه الخلافة والشروط الواجبة في الشخصية التي ستدير دقة الإمارة والحكم، ولهذا سيكون النقاش محتدما وستتخلله فصول من الصراع والتناحر حول السلطة، وسينتقل المسلمون من وضعية الدعوة والأمة، إلى وضعية السلطة والدولة، ولم تكن الوسائل المعتمدة في تدبير الخلاف بين مسلمي ما بعد الرسول تقتصر على الشأن السياسي، وإنما تم الدفع بالنصوص الدينية إلى ساحة الجدل وسارع كل فريق إلى استحضار حججه الدينية من أجل التدليل على مشروعية السياسة وفي هذه الأثناء ستظهر الانقسامات بين العائلات ثم فيما بعد بين التيارات الدينية والطوائف.
رغبنا من خلال هذا الإيجاز، التقديم لدراسة الدين والسياسة في بواكير التجربة الإسلامية، وهو ما سيتم تناوله في مطلبين حاولنا في أولهما ملامسة الإجابة عن السؤال الأتي، هل سعى النبي محمد إلى تشكيل أمة ترتكز على الإيمان، أو رام تأسيس دولة سياسية؟
أما المطلب الثاني فبدوره تم تخصيصه لمحاولة الإجابة عن السؤال التالي: أخلف النقاش المحتدم في سقيفة بني ساعدة عقب وفاة الرسول، دولة دينية أم دولة سياسية؟
الفصل الأول: سؤال الدولة في التجربة النبوية:
إن البحث في إشكالية الديني والسياسي والمقدس والدنيوي، وربطها بمسألة الدولة في التجربة السياسية الإسلامية، ينبغي ألا يغفل مجموعة من العوامل والمؤثرات الخاصة بهذا المسار السياسي والفكري، إذ يشكل الإسلام حسب أحد الباحثين الأمريكيين حالة تاريخية فريدة لديانة ظهرت بصورة متزامنة كجماعة كاريزماتية دينية، كجماعة سياسية، وقد تجلى في الكاريزما الدينية والسياسية المزدوجة لمؤسسها بوصفه رسول الله وقائدا سياسيا وعسكريا، بل يتجلى ذلك بصورة أكثر موضوعية في كون الحقبة الإسلامية لا تبدأ بولادة مؤسسها أو وفاته، أو بتاريخ الوحي، بل بالأحرى بالهجرة التي تحدد تأسيس الجماعة السياسية الإسلامية في المدينة المنورة، فالأمة أو الجماعة المسلمين اعتبرت نفسها في معظم الأحيان جماعة المؤمنين وأمة الإسلام بيد أن من الخطأ كليا أن نعتبر أن الإسلام لا يتضمن نطاقين متمايزين، الأول ديني والتاني سياسي، ففي الواقع ربما كان تاريخ الإسلام هو تاريخ المؤسسات المتنوعة للكاريزما المزدوجة الدينية السياسية التي تمتع بها النبي محمد ضمن مؤسسات دينية وسياسية متمايزة.
“ويشكل الإسلام حالة تاريخية فريدة لديانة ظهرت بصورة متزامنة لجماعة خلاصية كاريزماتية دينية وكجماعة سياسية وقد تجلى ذلك في الكاريزما الدينية والسياسية المزدوجة لمؤسسها محمد بوصفه رسول الله وقائدا سياسيا وعسكريا بل ويتجلى ذلك بصورة أكثر موضوعية في كون الحقبة الإسلامية لا تبدأ بولادة مؤسسها أو وفاته أو بتاريخ الوحي بل على الأحرى بالهجرة التي تحدد تأسيس الجماعة السياسية الإسلامية في المدينة المنورة: فالأمة أو جماعة المسلمين اعتبرت نفسها في معظم الأحيان جماعة المؤمنين وأمة الإسلام، بيد أن من الخطأ كليا أن نعتبر أن الإسلام لا يتضمن نطاقين متمايزين، الأول ديني والثاني سياسي.
في الواقع ربما كان تاريخ الإسلام هو تاريخ المؤسسات المتنوعة للكاريزما المزدوجة الدينية السياسية التي تمتع بها النبي محمد ضمن مؤسسات دينية وسياسية متمايزة.”[1]
وعلى الرغم من أن الظاهرة الإسلامية ارتبطت بتجربة المدينة بالمعنى الكبير والنموذجي للكلمة، إلا أنها أصبحت أنموذجا للعلم التاريخي وقدوة تحتذي من قبل كل أجيال المسلمين حتى يومنا هذا وهي أساسا تجربة رجل اسمه محمد ومواطن من مكة وقد استطاع بدءا من عام 622م أي العام الأول للهجرة أن ينجح في عملية ذات نمط تاريخي ومرتبطة بقوة الخطاب الديني المكتف في القران، نقصد بهذه العملية التاريخية إقامة ما أطلق عليه فيما بعد دولة المدينة وهناك من عد هذا الكيان النبوي أنموذجا جديدا، الدولة مستعارة من دولة أثينا أولا ومن الدولة الإمبراطورية الرومانية بعد تشكل الخلافة، ثانيا ثم أضيف إلى هذه الدولة البعد الديني الداعم لها، والمثمتل في الوحي القرآني ونتج عن ذلك شيء مشابه لما حصل في الإمبراطورية المسيحية في القرون الوسطى مع الرأس المزدوج للبابا والإمبراطور. الفرق الوحيد بينهما هو أن هذا الرأس المزدوج قد اجتمع في الإسلام في رأس واحد هو رأس الخليفة أو الإمام.
تجربة المدينة وهي عبارة عن حدث تاريخي بالكامل، وعلى الرغم من انزعاج اللاهوتيين والفقهاء إلا أني لا أستطيع إلا وأن أميز هنا بين الظاهرة القرآنية كما حددتها آنفا وبين الظاهرة الإسلامية وأصل هذه الأخيرة ونقطة بدايتها هي تجربة المدينة بالمعنى الكبير والنموذجي للكلمة لأنها أصبحت نموذجا للعمل التاريخي وقدوة تحتذي من قبل كل أجيال المسلمين حتى يومنا هذا وهذه التجربة هي أساس تجربة رجل اسمه محمد، مواطن من مكة، وقد استطاع بدءا من عام 622م أي العام الأول للهجرة أن ينجح في عملية ذات نمط تاريخي ومرتبطة بقوة الخطاب الديني المكتف في القرآن، نقصد بهذه العملية التاريخية إقامة مدينة دولة أو دولة المدينة.
وهذه الدولة الجديدة لم تدخل فقط في المجتمع العربي آنذاك وإنما بشكل أوسع في العالم المتوسطي ككل نموذجا جديدا للدولة مستعارا من دولة أثينا أولا ثم من الدولة الإمبراطورية الرومانية بعد تشكل الخلافة، ثانيا: ثم انضاف إلى هذه الدولة البعد الديني الداعم لها والمثمتل بالوحي القرآني ونتج عن ذلك شيء مشابه لما حصل في الإمبراطورية المسيحية في القرون الوسطى مع الرأس المزدوج للبابا والإمبراطور الفرق الوحيد بينهما هو أن هذا الرأس المزدوج قد اجتمع في الإسلام في رأس واحد هو رأس الخليفة أو الإمام.[2]
هذا التصور حول طبيعة الكيان السياسي الذي أسسه الرسول لا يقتصر تبنيه على الفكر الإسلامي، بل نصادف الفكرة ذاتها لدى الكثيرين من المفكرين الغربيين، فمنهم من يرى أن أهم ما يميز الدين الإسلامي في كونه، لا يطرح مذهبا دينيا فقط بل يطرح كذلك تقاليد ثقافية واجتماعية منفصلة أو تتفوق أو تتساوى في جوانب عديدة، مع تقاليد أوربا المسيحية.[3]
من أحد أكبر مميزات الدين الإسلامي أنه لا يطرح مذهبا دينيا فقط بل يطرح كذلك تقاليد ثقافية واجتماعية منفصلة أو تتفوق أو تتساوى في جوانب عديدة مع تقاليد أوربا المسيحية،كما يمكن مقارنة قرون من التقدم الفني واللاهوتي.[4]
لكن عدم التمييز بين مفهوم الدولة ومفهوم الأمة في التجربة النبوية قد يعيق الفهم والتواصل، ومن ثم التأثير في التأسيسات اللاحقة على الخطبة النبوية فإذا كانت ملامح البناء المحمدي تؤشر إلى أن الرسول لم يكن بصدد بناء دولة كما نفهمها اليوم، أي دولة مركزية قوية تبنى على رابطة المواطنة وتمنح فيها الجنسية لمن تنتمي إلى حدودها، ويحترم قوانينها فإن الكثير من الفكر سواء كان إسلاميا مؤد لجا أم إسلاميا الانتماء إلى الدين أم استشراقيا لا يزال يخلط بين البناء المؤسساتي للدولة وبين التركيب الديني والهوياتي للأمة المحمدية.
في هذا السياق نقرأ لهشام جعيط ما يأتي: “ترك النبي عند وفاته دينا مكتملا ودولة مهيمنة على الجزيرة العربية كلها، مترابطين بشكل لا يقبل الانفكاك فمن خلال اعتناق الإسلام وممارسته ولاسيما الصلاة والزكاة، ثم انصياع الأفراد والجماعات للدولة الجديدة، وقد دخل مسلمو الساعة الأولى، المثأترون بدعوى كانت تخاطب الأفراد أولا دخولا طبيعيا في نظام الدولة، فالوظيفة النبوية تؤلف بين الدنيوي والقدسي، بين العالم المرئي والعالم اللامرئي، ويقوم سلطانها على كلام الله مثلما يرتكز على التوجيه الفعلي للأمة.[5]
الواضح من هذا الطرح أنه لا يكتفي بالقول إن الرسول قد أسس دولة كاملة الأركان بل إنه يرجع سبب وحدة العرب ودخولهم التاريخ السياسي إلى ما يسميه جعيط الحركة النبوية، فضلا عن أن الدولة النبي قد جمعت من وجهة نظر هذه، بين الدين والسياسة إلى درجة الاندماج.
لعل غياب التمييز بين مفهوم الأمة، الذي هو من طبيعة أهداف النبوات وبين الدولة، التي هي مجال عملي للسياسة، مجال لديه قوانينه وتطبيقاته، من شأنه غياب التمييز، أن يقودنا إلى استنتاج أن الأمة، بما هي إطار انتماء عقائدي فصولي، وسلوكي للجماعة، لم يندمج اندماجا عضويا في الدولة.[6]
الأمر الذي كان مثار تنبيه وتحذير من قبل أحد أقطاب الفكر الإصلاحي الإسلامي بقوله: الرسالة غير الملك وليس بينهما شيء من التلازم بوجه من الأوجه، وإن الرسالة مقاما، والملك مقام آخر فكم من ملك ليس نبيا ولا رسولا وكم لله جل شأنه من رسل لم يكونوا ملوكا، بل إن أكثر من عرفنا من الرسل إنما كانوا رسلا فحسب.[7]
وهو ما دفع علي عبد الرازق، إلى طرح مجموعة من الأسئلة المهمة، فإذا كان الرسول قد أسس دولة سياسية أو شرع في تأسيسها، فلماذا خلت دولته إذا من كثير من أركان الدولة، ودعائم الحكم؟ ولماذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمنه.[8]
وفي سياق محاججة غير مباشرة لطرح عبد الرازق، يذكر المؤرخ هشام جعيط عدة أسس قامت عليها تلك الدولة، حيث السلطة العليا لله والكاريزما النبوية وتكوين جماعة متضامنة هي الأمة وكذلك بروز تشريع وتوطده ظهور طقس عبادي موحد هنا، يضيف صاحب كتاب الفتنة يتعلق الأمر بالعناصر البانية للدولة التي منحت النواة الأولى من المؤمنين تماسكها، ولكن تلك الدولة منظورا من مستوى الجزيرة العربية كلها، من زاوية علاقتها بالخارج، غير أن جعيط يعود إلى التنبيه إلى أن تلك الدولة، إنما بنيت على الحرب، وعلى تشكيل قوة تدخل سوف تعد والأداة الفعلية لتوسع الدولة الإسلامية.
إن العقبة الثانية، أو العهد المعقود مع مسلمي المدينة عشية الهجرة، يمثل أكثر من صحيفة المدينة التي ولدت بموجبها الأمة الإسلامية تحت نظر الله ونبيه، إنه يمثل وثيقة ولادة المدينة الإسلامية.[9]
لم يبين جعيط في كتاباته التاريخية، ما إذا كان يتحدث عن الدولة النبوية بمفهومها الوارد في اللغة، والمتضمن فكرة التبدل والتغيير وللاستقرار، أم الدولة بمفهومها الحديث، لأنه لو كان يقصد المفهوم الثاني، فإننا نرى أن الأمر مخالف لوصفه، إذ لو تحدث القرآن، أو الرسول عن الدولة و الكيان السياسي المنظم للجماعة، لأخضع الدين للدولة وجعل من بنائها مقصد الدين وغايته.
ولكانت النتيجة تأسيس الدولة الإلهية والدينية بالمعنى الحرفي للكلمة على الأرض، ومن ثم انتفاء الحاجة للبعث والحساب، ويوم الدين ولو حصل ذلك لكان محمد جابيا، ولم يكن هاديا.[10]
لقد كانت رسالة العرب في الإسلام أكبر من بناء الدولة بكثير وأكثر تحفيزا، كانت رسالة الأمر بالمعروف، أي بالخير والنهي عن المنكر،أي حمل كلمة الحق إلى كل أصقاع الأرض، ونشر العدل في كل مكان والجهاد في سبيله، كانت رسالة التضحية الكلية والدائمة في كفاح لا يكل من أجل العقيدة ورفع راية الإيمان والدين الصحيح، ولو تحدث القرآن أو الرسول في الدولة أو الكيان السياسي المنظم والمنظم للجماعة لأخضع الدين للدولة، وجعل من بنائها مقصد الدين وغايته،ولكانت النتيجة تأسيس الدولة الإلهية والدينية بالمعنى الحرفي للكلمة على الأرض ومن ثم انتفاء الحاجة للبعث والحساب ويوم الدين ولو حصل ذلك لكان محمد جابيا ولم يكن هاديا [11]
والواقع إن النبوة لا تقود المؤمنين إلى الدولة ولكنها تدعوهم إلى الخلاص من مخاطر الدولة والدنيا معا، بأن تنذرهم له من مهام ربانية فوق تاريخية وفوق إنسانية، لقد باع المؤمنون أنفسهم لله ووضعوا أرواحهم تحث تصرفه ليحققوا النصر لدعوته وتصدقوا بدنياهم صدقة خالصة لله وحده ولم يطالبوا لقاء ذلك بفائدة أو بمقابل في الأرض، وهكذا، ما كان من الممكن أو المشروع الحديث عن دولة إسلامية أو غير إسلامية، لقد كان الحديث عن دولة إسلامية بمثابة تقليص لرسالة الإسلام وتقليل من مكانة الدين وتقصير محدوده، لقد سموا اجتماعهم فيما بعد دار الإسلام أي فضاءه والحال المحمي الذي ينتشر فيه ويتحقق، وقد اعتقد العرب دائما أنهم لم يتغلبوا بسلطان السياسة ولكنهم تغلبوا بسلطان الدين، أي الإيمان الذي بته الإسلام في قلوبهم، والذي كان هو الهدف والغاية، أي لخدمة الدين أيضا.[12]
في هذا الصدد يصف أحد الباحثين النظام السياسي، الذي أقامه الرسول بكونه فريدا ونوعيا، فهو يختلف عن الدولة التقليدية، التي تتميز بأن سلطتها لا مهرب منها وذلك لكونه تجمعا طوعيا لم يقم على القهر ولم تكن العضوية في الجماعة طوعية فحسب، بل إنها كانت تنطوي على مخاطر كبيرة للعضو وفوق ذلك، كانت المساهمة في الأمور العامة، {مثل الانضمام للغزوات والسرايا، ودفع الزكاة} طوعيا ولم تكن للدولة أي آليات لفرض هذه المساهمات بالقوة، بل كانت الجماعة. على العكس تعاقب أهل النفاق والمشكوك في ولاءهم بحرمانهم من هذه المشاركة وليس بإجبارهم عليها.[13]
يقول: “لم يواجه المسلمون قضية الدولة بصورة مباشرة إلا بعد وفاة الرسول {ص} كان فريدا من نوعه، فهو يختلف عن الدولة التقليدية التي تتميز كما رأينا بأن سلطتها لا مهرب منها، وذلك لكونه تجمعا طوعيا لم يقم على القهر ولم تكن العضوية في الجماعة طوعية فحسب، بل إنها كانت تنطوي على مخاطر كبيرة للعضو، وفوق ذلك كانت المساهمة في الأمور العامة {مثل الانضمام للغزوات والسرايا ودفع للزكاة} طوعية أيضا ولم تكن الدولة أي آليات لفرض هذه المساهمات بالقوة، بل كانت الجماعة بالعكس، تعاقب أهل النفاق والمشكوك في ولائهم بحرمانهم من هذه المشاركة وليس بإجبارهم عليها، فقد أمر القرآن الرسول {ص} بالامتناع عن أخذ الزكاة من بعض الأفراد الذين رفضوا دفعها عن طيب خاطر، كما أمر الرسول {ص} بحرمان من ترددوا في الانضمام إلى بعض الغزوات الشاقة..[14]
أردنا أن نقارب إشكالية الديني والسياسي في التجربة النبوية من منظور مختلف لما اعتادته أغلب الأبحاث، لعلنا نصل إلى نتائج مغايرة لما تم بحثه من قبل المقاربات التي انصبت بشكل مباشر على الموضوع. لقد مكننا التركيز على الكيان السياسي الذي ساد خلال التجربة النبوية من استجلاء الموضوع في بعده المؤسساتي، وليس في بعده المجتمعي فحسب، وذلك لأننا نفترض أن النقاش حول ممارسة النبي للسياسة ممتزجة بمهمته الدينية من عدمها، لن يقودنا إلى نتائج يمكن التأسيس عليها، ما دام الاختلاف حاصلا حول مفهوم السياسة ومفهوم الدين من ناحية وعرضية السياسة في التجربة النبوية، وذاتية الرسالة الدينية، من ناحية أخرى، وهو الإشكال الذي نظن أننا تجاوزناه من خلال اعتماد منهجية علم السياسة للبحث في الجوانب المؤسساتية، إذ إن التساؤل حول طبيعة الكيان السياسي، الذي انتظم في ظله مسلمو الفترة النبوية قادنا إلى التأكد من أن هذه الفترة لم تشهد أي ملمح لمشروع دولة سياسية ذات تحديد قانوني لمختلف أبعادها السيادية والإقليمية، ومن تم فإن أية محاولة للتعويل على محتوى التجربة النبوية، التأسيس عليها في اللحظة المعاصرة {وهي اللحظة التي تقوت فيها الدولة، وتكرست دعائمها}، هي المحاولة من قبيل المقارنة مع وجود الفارق، إذ كيف يمكن مماثلة المضمون السياسي والديني لمرحلة اللادولة {الأمة}، بالمحتوى السياسي لمرحلة الدولة LETAS وهو السؤال الذي سيكون محور اهتمامنا خلال القادم من الأفكار لكننا قبل ذلك يمكن أن نعرض في الفقرة التالية، لبعض النقاش الدائر في الفكر المعاصر حول مسألة الدين والسياسة في التجربة النبوية.[15]
فإذا كانت إشكالية العلمانية لم تطرح، من قبل في الفكر العربي والإسلامي فذلك راجع، إلى أن الإسلام الديني كان هو الذي أسس بنفسه الحيز المدني فأكده وشرع له منذ آن جعل الرسالة المحمدية خاتمة النبوية، وكل وحي في العالم وأعطى للعقل، بدءا من ذلك الوقت، الدور الوحيد في تسيير المجتمع والتاريخ حتى قيام الساعة.[16]
يقول: “والقصد أنه إذا كانت إشكالية العلمانية لم تطرح من قبل في الفكر العربي والإسلامي فذلك لأن الإسلام الديني كان هو الذي أسس بنفسه الحيز المدني وأكد عليه وشرع له، منذ أن جعل الرسالة المحمدية خاتمة النبوة، وكل وحي في العالم.
وأعطى للعقل، بدءا من ذلك الوقت، الدور الوحيد في تسيير المجتمع والتاريخ حتى قيام الساعة والأصل أن اختتام الرسالة يعني أنه لم يعد هناك اتصال للجماعة المؤمنة مباشر مع الله، وحتى فيما يتعلق بتفسير القرآن، لم يعد هناك، ملاذ للإنسان إلى العقل وهو ما يعنيه الاجتهاد..[17] والقصد هنا بما أن الله قد ختم رسالته، ولا نبي بعد محمد، فهذا يعني أنه لم يعد أحد قادرا على ادعاء الاتصال المباشر بالوحي، كما أضحى العقل الذي زود به الإنسان من قبل الخالق، وعاء الوحي القادر على فهم مبانيه ومراميه.[18]
الفصل الثاني: تأسيس ديني أم سياسي {الدولة}
من النزاع إلى التوافق:
انتهت مرحلة النبوة، وخلا منصب الزعيم، وانجلت سحابة الوحدة، والتضامن وجاءت لحظة الخلاف والصراع، فمع وفاة الرسول المفاجئة التي يضعها الصحابة في الحسبان، وقبل دفن جثمان باقي الأمة وموحدها لاحت في الأفق مرحلة جديدة سيكون لها ما بعدها، فما الذي حصل إبان تلك اللحظة؟ وهل سبب اختلاف الصحابة يعود إلى السياسة أو إلى الدين؟ وهل تأسست الدولة، بعد وفاة الرسول؟[19]
يرى بعض المفكرين أن اللحظة التي أعقبت وفاة الرسول لم تطرح فيها مشكلة السلطة السياسية والزعامة، ولكن طرحت مشكلة الخلافة وملء الفراغ الذي نشأ بوفاته، وشغور موقع القيادة التي كان يمارسها والتي لم يكن أحد يناقش من قبل، أسسها ولا طبيعتها، وهي خلافة بالمعنى الحرفي للكلمة أي نيابة عن الرسول، لكن مع مراعاة انتهاء النبوة واستمرارها فقط عبر القرآن ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى التفكير في السياسة، فقد كان المطلوب الاستمرار على النهج المحمدي في قيادة حركة التقدم الإسلامي، أي عملية التبشير، وما يرتبط بها من جهاد وكفاح ضد الشرك الداخلي والخارجي، ولم يخطر ببال أحد أن يبني دولة، أو يرث سلطانا بأي معنى من المعاني.[20]
يقول: وعندما توفي الرسول {ص} لم تطرح مشكلة السلطة السياسية والزعامة ولكن طرحت مشكلة الخلافة وملء الفراغ الذي نشأ بوفاته وشغور موقع القيادة التي كان يمارسها والتي لم يكن أحد يناقش من قبل أسسها ولا طبيعتها وهي خلافة بالمعنى الحرفي للكلمة، أي نيابة عن الرسول، لكن مع مراعاة انتهاء النبوة الحية واستمرارها فقط عبر القرآن، ولذلك لم تكن هناك حاجة للتفكير في السياسة. فقد كان المطلوب الاستمرار على النهج المحمدي في قيادة حركة التقدم الإسلامي أي عملية التبشير والهداية، وما يرتبط بها من جهاد وكفاح ضد الشرك الداخلي والخارجي، ولم يخطر ببال أحد أنه يبني دولة أو يرث سلطانا بأي معنى من المعاني.
يحاول هذا النص، أن ينتصر لفكرة كون الصراع الذي تلا وفاة النبي لم يكن ذا خلفية سياسية، أو سلطوية وإنما هو راجع إلى الرغبة في تنظيم شؤون الدعوة بدليل أنه: “لا أبو بكر ولا غيره من معاصريه قد فكر في أن يطلق على نفسه لقب سلطان، أو ملك ولكنه استخدم ببساطة كلمة خليفة رسول الله ولم يكن اختبار هذه الكلمة التي لم تكن مستخدمة بهذا المعنى، أبدا من قبل اعتباطا ولكن تعبيرا عميقا عن روح المهمة التي تحملها، لكن هل، بالفعل كان الصراع من أجل الدعوة؟ وهل حقا غابت فكرة الخلافة عن البيئة العربية؟[21] حملت هذه التجربة الكثير من المعاني والدلالات ما جعل الفكر الحديث يسلط عليها بعض النقد وكثيرا ما قامت بعض القراءات مستعينة بالإنتاج الفكري المعاصر، بمحاولات تفسيرية لما حدث في ذلك التاريخ وسواء اختلفنا أم اتفقنا، مع هذا التوجه من شأن هذا الأمر الإسهام في تقديم وجهة نظر مغايرة لما سطرته كتب التاريخ وما لحقها من شروحات وهذا واحد من النصوص التي تسير وفق ما نحن بصدد الحديث عنه يقول صاحبه، {فلئن تقدم لنا التجربة نموذجا مبكرا على الأولوية التي تعطى للسياسية على الدين عند رجال السياسة وعلى التوظيف السياسي للدين وعلى تحكيم السياسة بالإمامة، بدلا من تحكيم الإمامة بالسياسة، على ما تفترض نظرية الحاكمية الإلهية، والمنطلقات اللاهوتية للإيديولوجيا الإسلامية، بشتى تلاوينها، وتضيف هذه القراءة فلئن تكن السياسة في أحد تعاريفها هي مضمار المدنس، كما الدين مضمار المقدس ولئن تكن العلمانية، في أحد تعاريفها هي الفصل بين هاذين المضمارين، فإن اجتماع السقيفة يقدم لنا عينة تاريخية مبكرة ومن ثم ثمينة جدا، عما ستكونه مؤسسة للخلافة في الإسلام من حيث هي مؤسسة سياسية قبل أن تكون مؤسسة إمامة، فباسم المقدس قد تخاض معمعة السياسة، ولكن تبقى وظيفته أن يوظف في خدمتها.
أما الديانة الإسلامية فهي لم تواجه في بداية وجودها التحدي، وإنما كان همها الأول هو كيف بمقدور الدين الجديد أن يتغلغل في نفوس سكان الجزيرة العربية، وكيف تقتنع به عقول عباد الأوثان أي: أن التجربة الإسلامية المبتدئة لم تواجه تقاليد سلطوية قوية قادرة على لجم دعاة الدين الجديد، والحد من قدراتهم، بل كل ما توافر لا يخرج عن قبائل قوية تعبد الأوثان وتبجل عبادة السلف، حتى إذا تحول زعيم القبيلة، أو أحد عناصرها الأقوياء عن دين الآباء، تحولت معه القبيلة وهذا ما ساعد الديانة الإسلامية على الانتشار بسرعة ومن دون مقاومة كبيرة من قبل السلطة غير الموجودة أصلا.[22]
أما في التجربة الإسلامية فإن ضعف الدعوة لم يعمر طويلا بل سرعان ما استقر القرار والنفوذ لصالح أصحاب الرسول محمد، وبزعامته السياسية والدينية، الشيء الذي لم يسجل معه أي صراع بين ما نطلق عليه اليوم، الدين والدولة أو بين رجال السلطة ورجال السياسة، وإنما عرفت علاقة انصهار وتناغم صعب معه تبين أين تنتهي مهمة الرسول الدينية، وأين تبدأ تصرفات محمد بصفته مدبر الشؤون السياسية، وإن تم تسجيل أنه خلال هذه المرحلة لم تتشكل بوادر {الدولة}، بمفهومها الحديث، وإنما كانت غاية النبوة تقتصر على تيسير طريق انتشار الدعوة وتقوية رابطة الأمة الدينية.[23]
الفصل الثالث: التحولات المحورية في منتصف الفترة الوسيطية ومحدداتها اللاهوتية والفكريةّ:
وهو ما يدفعنا إلى إثارة السؤال الذي يفرض نفسه في مثل هذه الحالات ونعني به: أنحن بصدد دولة دينية أم دولة سياسية أم هما معا؟
يمنحنا العرض السالف فكرة مهمة عن التحول ضرب بعمق في العقل الإسلامي وأصابه بهزات مثثثالية ما زالت رناتها تسمع إلى يومنا هذا. لقد تم الانتقال إلى نظام حكم لم يتحول إلى حكم ملكي فحسب وإنما أدار ظهره إلى مختلف المقولات السابقة، من قبيل قصر الحكم على قريش بداية وعلى العرب تاليا، ووحدة السلطة وخدمة الدولة للدين..
وهكذا أصبح الإنسان المسلم أمام واقع يتحكم في جزئياته سلاطين من غير العرب وتتنافس على حكمه علاقات متعددة، ليس من ضمنها العرقية العربية، واقع لأول مرة تخرج فيه السلطة، {القوة العسكرية}، من يد العرب، ثم لا تلبث أن تغادر مؤسسة الخلافة، المنطقة العربية نحو بلاد لم يتوقع العقل الإسلامي أن تحتضنها الأمر الذي يتناقض ومقولة “الإمارة من قريش” وهو ما جعل الفكر السياسي الإسلامي آنذاك يركز على القبول بأن تصر للحكم يحفظ ماء الوجه، ويدعي الحرص على تطبيق الشريعة، ولو زعما، ومن ثم تبدلت الرؤى وتغيرت المعاني.
خلال هذه الأحداث، لم نلمس حديثا عن الدولة، ولا عن مضمونها الفكري والسياسي بل كان الحرص الأكبر، من قبل المتصارعين على الحكم، يتمثل في كيفية القضاء على المنافسون واستدامة اجتياز السلطة دون أن يخلو الأمر من توظيف الدين وتسخيره لأهداف السياسة فما كان يمكن للبويهيين والسلاجقة، أن يحافظوا على المنصب الصوري للخليفة، لو لم يكن يحقق لهم أهدافا سياسية، كما لم تغب اللغة الدينية عن ساحة التنافس بين هؤلاء، فالأتراك ادعوا المنافحة عن المذهب السني في مواجهة الحماية للبويهيين الشيعة في بغداد والأمر نفسه قام به بنو بويه وغيرهم، فعلى الرغم من حقوق صوت اللغة الدينية في هذا المضمار إلا أنها بقيت مؤثرة بالنسبة إلى الذين يسعون إلى المزيد من التوسعات السياسية، أو الحفاظ على السلطة أكبر مدة ممكنة.
الفصل الرابع: في السياق الإسلامي
هذا الاندماج بين السياسي والديني، وبين شخص الحاكم والكيان الاجتماعي، سيثار أكثر مع الكتابات التي تأثرت بالرافد الفارسي، وذلك بعد الترجمات التي قام بها ابن المقفع ولاسيما القراءات التي تقدم بها كل من الماوردي والغزالي وهي كتابات تظهر مسألة الدولة والتمييز بين الشأنين السياسي والديني تكاد تكون شبه منعدمة بل يمكن القول: إن كتابات النصح السلطاني تؤسس لحكم أوتوقراطي مطلق يتزيا برداء خدمة الدين، ويدعي خدمة الشريعة ما دامت تخدمه.
وكان الماوردي قد خطا خطوة قوية عند عبور المجتمع هذه المرحلة الحساسة حيث قام باستخراج الأحكام السلطانية وقوانين الملك والسياسة من المصادر الدينية، وجمع الأحكام والقضايا الفقهية المتفرقة، التي كانت تتعلق بالمحاكم والمجتمع والعلاقات الاجتماعية في صورة عمل مستقل وقد استكمل هذا باجتهاده الخاص، بما يتفق وظروف العصر والمكان.[24]
الدين والسياسة عند أصحاب المدن الفاضلة:
يصعب على الباحث الإحاطة بجميع الأجناس الفكرية والسياسية، التي تواكبت على ساحة النظر في المجتمعات الإسلامية، كما يصعب تصنيف الكثير من هذه الأجناس، أو الفصل بينها إذ يحار المرء مثلا في أن يعد كتابات التوحيدي والجاحظ وابن مسكويه ضمن نصوص الآداب السلطانية، ويدرها ضمن أطرها الفكرية والسياقية ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن تبرير أن تدرس تلك الكتابات بمعزل عن الآداب السلطانية في الوقت الذي يعد كثير من دارسي هذا النوع من الكتابات أن ابن المقفع يعد أحد مؤسسيها وهو الذي يجمعه بمن يسميهم أركون الإنسية الإسلامية، كثير من التشابه الفكري كما تصعب دراسة النصوص ممثلي الفلسفة السياسية الإسلامية، {الكندي، الفارابي، وابن رشد، وابن باجة..} ضمن إطار آداب النصح السلطاني، نظرا لما حملته كتابات هؤلاء من طروحات عقلانية، للأشياء، ولكن في الوقت نفسه، يصعب تبرير عند الغزالي، مثلا أحد أعلام المرايا، على الرغم من أنه اشتهر بكثير من النصوص الفلسفية ذات المنحى العقلاني في الوقت الذي يشترك فيه مع فلاسفة السياسة في رؤاهم الأوتوقراطية والتيوقراطية للشأن السياسي.[25]
على المستوى الإسلامي:
فإن المرحلة القصيرة التي لم تتجاوز الثلاثين سنة لم تستطع التأسيس لعلاقة مستقرة في السياسة، بل تبدد حكم نظام الخلافة ولاحت بداية جديدة عمادها الدهاء السياسي والعودة للعصبيات القبلية وطغيان المصلحة الأمر الذي انعكس على طبيعة العلاقة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، فمن الدمج التام بين الديني والسياسي في عهد الرسول إلى الصراع السياسي حول السلطة إبان الحدث السقيفي مرورا بانقلاب الخلافة إلى الملك بلغة الفقهاء أو دولة السياسة الإسلامية انتسبت تارة إلى الأتراك {السنة}، وثارة أخرى إلى الفرس {الشيعة} وهي المرحلة التي تزامنت مع العصور الوسطى المسيحية وما صاحب ذلك من صراعات سياسية بين الكنيسة والدولة. {على الرغم من أنه في تلك الفترة كانت الدولة الغربية لم تتشكل بعد وإنما لاحت بوادرها}، فكان من الطبيعي أن يعيش المسلمون تاريخهم الوسيط أيضا، تاريخا هيمن عليه التجاذب بين مؤسسة الخلافة والمركز الجديد المثمتل في السلطة المفارقة، إنه خلال هذه المراحل لم نلمس حديثا عن الدولة ولاعن مضمونها الفكري والسياسي،بل كان الهم الأكبر من قبل المناوبين على الحكم هو كيف يثم التخلص من المنافسين واستدامة اجتياز السلطة، دون أن يخلوا الأمر من توظيف الدين وتسخيره لأهداف السياسة.[26]
بينما ظلت الكتابات السياسية، التي نظرت لدمج الديني بالسياسي سواء لدى كتاب نصائح الملوك أم الآداب السلطانية، أو السياسة الشرعية وفية لروح التجربة الفارسية الساسانية ممارسة وقولا، فإن جانبا مشرقا في الحضارة الإسلامية بدأ يشع، على الرغم من كل العتمة المحيطة به.
المقصود بهذا الوصف هو ما اصطلح عليه بالفلسفة الإسلامية ولا سيما طروحات الفارابي وابن رشد، وإذا كان الأول لم يقو على الابتعاد كثيرا عن مسلك الآداب السلطانية، فإن الثاني تجرأ على التفكير خارج الأنساق المتوارثة مفضلا مواجهة المتاعب على الاستكانة إلى ما يريد أهل السياسة، محاولا التمايز عن النموذج الطوباوي لأفلاطون والفارابي، لكن على الرغم من كل التحسينات
التي أدخلها القول الفلسفي على النظر السياسي، فإن الأمر لم يرق للحديث عن اجتهاد مفارق يمكنه نقل التفكير في السياسة خارج الأطر المعتادة ولم يحد عن هذا المنحى في التفكير إلا ابن خلدون الذي اهتم بعنصر العمران والاجتماع والاقتصاد في تكوين الأمم والدول.[27]
الفصل الخامس: العرب بين رهان بناء الدولة وإكراهات النموذج
إن مناقشة موضوع الدولة واكراهات النموذج لدى العرب في المبحث الأخير من هذا الكتاب لهو بمثابة استطلاع موقف الفكر العربي الإسلامي من قضية الدين والسياسة، وسؤال المتخيل الديني وكأن البحث يريد أن ينظر في تأثير التفاعلات التاريخية والفكرية والسياسية على ساحة النظر العربية الإسلامية الحديثة والمعاصرة في محاولة للوقوف على تجليات هذه التأثيرات والتحولات على مستوى الذهنيات وكذلك على مستوى الشخصيات، لأننا نفترض أن الجدل الذي احتدم ولا يزال حول قضية الدين والسياسة قد ترتب على عنصرين أساسين، العنصر الأول: يتعلق بالتاريخ الإسلامي إذ إنه لأول مرة تقريبا سيكون العرب والمسلمون في وضعية المتلقي، بعد أن كانوا خلال العصور الوسطى في وضعية المتلقي عنه، وفي أسوأ الأحوال الوسيط بين الفكر اليوناني والفكر المسيحي الوسطوي وهنا يطرح السؤال، الذي نعده سؤال الأسئلة التي جاءت في هذا البحث، كيف تعامل الفكر الإسلامي والعربي المعاصر مع هذه الوضعية المستجدة؟ وكيف قرأ المفكرون العرب والمسلمون تاريخهم من جهة، وواقع الأمم المجاورة لهم من جهة أخرى.
في محاولة لتلمس الإجابة عن دينك السؤالين، سنقسم البحث إلى مطلبين نناقش في أولهما الفكر النهضوي على أن نتطرق في المطلب الثاني، إلى سؤال الدولة المدنية والدينية، وموقف المفكرين والباحثين العرب والمسلمين من مسالة العلمانية.[28]
– الدين والسياسة والعلمانية في الفكر النهضوي:
أهم ما يميز اللحظة النهضوية كونها أثث في سياق الإمبراطورية العثمانية التي كان لها الفضل، ليس بالمعنى الإيجابي في خلق أجواء سجالية أسهمت في دفع عجلة الفكر إلى الأمام، وإن كانت قد جلبت معها نزوعات ارتدادية ومن هنا ظهرت الجامعات، {ليس بمعنى المؤسسة}، الفكرية، فبين الجامعة الإسلامية، {جريدة المنارة}، والجامعة العربية، {مجلة الجامعة}، دارت فصول متعددة من السجال والتطور.
ضمن هذا الإطار العام تأتي الأسئلة الآتية: كيف نظر الفكر النهضوي للتجديد الديني؟ وكيف تفاعل مع قضايا الوافد الجديد المسمى علمانيا فيما بعد.
لم يكن الكواكبي ليراهن على أن الإصلاح من فوق كفيل وحده لتحقيق النهضة بل كان رهانه الأكبر على ضرورة التربية والتعليم من أجل خلق بدائل للاستبداد ولمواجهة هذا الأخير، كان لابد من القول إن الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية، لأن الأمة التي توارثت الاستبداد قرونا عديدة تعتاد عليه، حتى إنها تنسى الحرية ولا تعرف لها قيمة، فالاستبداد لا يقاوم بحسب الكواكبي، بوسيلة واحدة بل يتحتم قطع دابره بترقي الأمة ونشر الوعي والثقافة وتحميس الشعب وقبل مقاومة الاستبداد، يجب تهيئة البديل وتحديد الغاية المرجوة من مقاومة المستبد والمثمتلة في الحكم الديمقراطي القائم على العدل.[29]
رفاعة الطهطاوي: المصلح:
فهل يكفي السياق لتفهم منزع رفاعة الطهطاوي نحو تسويغ الحكم المطلق؟ ألم يكن من ضمن معاصريه من يرفض التأسيس الديني للاستبداد كما فعل الكواكبي بعد سنوات قليلة؟
في هذا السياق، يبرز اسم جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، وإن كان الجانب الإيجابي في فكر الطهطاوي هو ما سيشكل الجانب السلبي في إصلاحية الأفغاني ومحمد عبده قد تمحورت بشكل كبير، على نقد مقولات للحكم الاستبدادي، فالأول يرفض أن يصار إلى الإبهام بأن البلاد في حاجة لمن يحكمها بالجيوش القوية والقلاع المحصنة، فذلك على الرغم من أهميته، في نظر الأفغاني، لا يصون البلاد ولا يحرسها، ما لم يتناول أعمالها رجال ذوو خبرة، وأولو رأي وحكمة.[30]
يحسب للإصلاحية الأفغاني وعبده أنها كانت حاسمة في رفضها أي ادعاء ديني للحاكم، إذ لا يجوز، من وجهة نظر عبده، أن يخلط المرء بين الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج، {تيوقراطي}، أي سلطان إلهي فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله، وله حق الأثرة بالتشريع، وله في رقاب الناس حق الطاعة لا بالبيعة، كان من أعمال التمدن للحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، فترك للكنيسة حق السيطرة على الاعتقاد والأعمال، فيما هو من معاملة العبد لربه.[31]
ومن هذا المنطلق أكد عبده عدم حصانة الحاكم في حالة زيغه عن الطريق القويم. بما أن الإسلام لا يعترف بسلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر، وهي سلطة خولها الله لأوفى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم، كما خولها لأعلامهم يتناول بهم من أدناهم.[32]
يظهر من خلال النص أعلاه أن الفكر الديني بدأ يراجع موقفه في هذه اللحظة التاريخية، وهو ما نلمسه عند الأفغاني بقوله: “إن الملوك فضلا عما رسخ في نفوسهم من أن رتبتهم المملوكية إنما هي سماوية، ساقتها إليهم يد العناية الإلهية، بسبب عنصرهم وطهارة طينتهم، يعتقدون أن لا قوام للرعية من دون وجودهم، لا مجال إذا لأفضلية الحاكم على المحكوم مهما كانت الخدمات التي يقدمها الأول للأخير، فكل هذا لا يبرر سطوتهم {الملوك}، وسلطتهم وامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم، ويرمون الرعية بالتقصير فيما يجب عليها.[33]
فإذا لم يكن الحاكم أهلا للمسؤولية أو زاغ عن المنهج فإن الأفغاني رأيا حاسما يثمتل في أن يتبقى التاج على رأسه ما بقي محافظا أمينا على صون الدستور فإذا حنت بقسمه، وخان دستور الأمة إما أن يبقى رأسه بلا تاج، أو تاجه بلا رأس.[34]
فكغيرهما من الإصلاحيين في الفترات الانتقالية، إن الأفغاني ورفيقه لم يذهبا بتصوراتهما الإصلاحية، إلى أقصاها بل عاد السياق الذي حكم الطهطاوي لكي يحد من إصلاحيتهما، وهكذا راح الأفغاني ورفيقه يشترطان في عدل ونجاعة الحكم ألا يتأسس إلا على أحكام الشريعة، حيت لا يأتي أي قانون إلا متوافقا معها ومن تجليات ذلك، أن الأفغاني رفض، أي قانون يخالف شرعيتها، {الديانة الإسلامية}، ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ الأحكام.[35]
فهو لا يتصور أن الإنسان يمكن أن يعيش من غير دين، أو تستقيم دنياه إلا على مدار الشريعة،[36]
توجه سايره فيه تلميذه ورفيقه ف {العروة الوثقى}، حيث يشترط محمد عبده، لرفعة الأمة أن تسن القوانين، وتحرص على تنفيذها، وتسهر لتطبيق أعمالها جزئية وكلية على منطوقها الحقيقي ومفهومها، إلا أن المضامين هذه القوانين لا تستخلص من قبل العقل البشري، أو من الطبيعة، بل ينبغي، ألا يخرج القانون عن الناموس الحق. [37]
ولئن كان عبده متوجسان من أي دعوة إلى الاقتداء بالغرب فإن تلميذه رشيد رضا لا يرى مانعا في تعلم صنعة الأوربيين، واستعارة ما يمكن أن يفيد الشرق ففي سياق سرد ما يمكن أن يكون العالم الإسلامي قد كسبه من الحضارة الغربية، يرى رشيد رضا أن أعظم فائدة استفادها أهل الشرق من الأوربيين تتصل في معرفة ما يجب أن تكون عليه الحكومة واصطباغ نفوسهم بها، حتى اندفعوا إلى استبدال الحكم المقيد بالشورى والشريعة بالحكم المطلق الموكول إلى إرادة الأفراد، نقرأ له بتعبيره، “لا تقل، أيها المسلم، إن هذا الحكم، {المقيد بالشورى}، أصل من أصول الدين ونحن قد استفدناه من الكتاب المبين ومن سيرة الخلفاء الراشدين، لا من معشر الأوربيين، والوقوف على حال الغربيين، فإنه لولا اعتبار الناس لما فكرت أنت وأمثالك أن هذا من الإسلام.[38]
فما كان الأفغاني ومحمد عبده حسب رشيد رضا، أن يديرا دعوتهما الإصلاحية على الشورى والدستور لو لم يكونا قد استفادا من الاعتبار مجال أوروبا.[39]
يصعب جرد كل الوجوه المحسوبة على الفكر النهضوي والحال أننا ادخرنا هؤلاء لمناقشتهم في السطور التالية لأنهم في الغالب يمثلون وجها آخر من مرحلة النهضة.
الدولة العلمانية والمدنية والدينية:
الفصل السادس: جدل العلمانية في الفكر العربي الإسلامي المعاصر
على غرار طروحات علي عبد الرازق، حاول جانب من الفكر التأسيسي للفصل بين الدين {الإسلام} والدولة بحجج دينية مستنبطة من النصوص المعتبرة، وفق تأويلات معاصرة، نقرأ للعشماوي، في هذا السياق، ما يأتي:
“إن السياسة لا تكون من الدين أبدا، وإن اعتبار الإسلام دينا سياسيا ليس سوى فهم جاهلي، وترديد لأراء وأقوال أعداء الإسلام، مثل أبي سفيان قبل إسلامه وابن الزبعري والوليد بن عبد الملك، وغيرهم مما كانوا يرون ويقولون، إن النبوة سبيل للسياسة، والرسالة سبب للتملك، والشريعة طريق للتحزب والجهاد سبيل للمغانم وهكذا.[40]
بهذه اللغة الواثقة يكون صاحب النص أعلاه قد نفى أي مجال للالتقاء بين ما هو ديني وما هو سياسي، دون أن يعني ذلك أن من شأن هذا الفصل التأسيس لعلاقة الصراع بين الدين والتدبير الدنيوي، فما تريده العلمانية، بحسب فؤاد زكرياء، إن هو إلا إبعاد الدين عن ميدان التنظيم السياسي للمجتمع، والإبقاء على هذا الميدان بشريا بحثا تتصارع فيه جماعات لا يمكن لواحدة منها أن تزعم أنها الناطق بلسان السماء، فأساس المفاضلة بين المواقف المختلفة يجب أن يكون العقل، والمنطق والمقدرة على الإتيان بالحلول الواقعية الناجحة {…}، فأية دعوة إلى الارتكان على سند سماوي في هذا الصراع إنما هو تضليل يخفي وراءه رغبة دفينة في إلغاء شروط هذا الصراع أصلا.[41]
أما العلمانية، فهي لا تجد لها موطئ قدم في البيئة العربية الإسلامية، لأن شروطها التي توافرت في بيئتها الأصلية، منعدمة في الشرق، فما دامت الكنيسة غير موجودة، وبما أن الإكليروس لا وجود لهم في الإسلام، وبما أن هذا الأخير يدعوا إلى العقل والعلم، فإنه لا مجال لوجود مفهوم اسمه العلمانية، ومن ثم وجب سحبه من دائرة التداول وتعويضه بمصطلحات تنتمي إلى البيئة المشرقية.[42]
إن أبرز من نافح عن هذا التصور هو المرحوم “الجابري” حيث كان شديدا في تأكيد أن مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات، إن الحاجة إلى الاستقلال في إطار هوية قومية واحدة، والحاجة إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق الأقليات والحاجة إلى الممارسة العقلانية السياسية، هي حاجات موضوعية فعلا، إنها مطالب معقولة وضرورية في عالمنا العربي ولكنها تفقد معقوليتها وضرورتها، بل مشروعيتها، عندما يعبر عنها بشعار ملتبس كشعار العلمانية.[43]
فما من مفهوم أكثر التباسا بحسب الجابري من مفهوم العلمانية، فهي مطلب لا تقتضيه الحاجة، وهذا ما جعل نتائج المصير الخاص الذي عرفته العلمانية في المجتمع العربي والإسلامي تختلف كليا عما حدث في الغرب المسيحي، فبدل أن تكون وسيلة لفك الاشتباك بين سلطتين متنازعتين، خلقت خصومة لم تكن موجودة من قبل ودفعت إلى نشوء الدين /الكنيسة في مواجهة الدولة عديمة الشرعية والأخلاق، لقد أنتجت قطيعة اجتماعية وعقدية من عدم، دون أن تنجح مع ذلك في تقديم الحلول المطلوبة على المسائل المطروحة بقوة وإلحاح في التجديد الديني أو تجديد الفكر السياسي.[44]
إن الدول التي تدير أنظمتها حكومات دينية، تكون سماتها الأساسية هي الشمولية والتغول، على المجتمع المدني، فهي دائما تدعي الاستناد إلى مبررات علوية، ولهذا تلجأ في الغالب، إلى النصوص الدينية سواء التي وضعت قبل، أم التي كانت من وضعها هي، أم احتكرت تأويلها، وهذا الطابع الكلياني للدولة الدينية هو ما يدفع للطرح العلماني لرفضه، لا على أساس شكله، ولكن من حيث طبيعة موضوعه، نقرأ لأحد ممثلي هذا الطرح: “إن العلماني الصلب قد ينظر إلى الدولة الدينية نظرة كارل ماركس العبودية،إنه قد يجيد مبررات تاريخية لنشوئها، ومع ذلك يرفضها من حيث المبدأ إنه سيصر على أن الدولة الدينية، بحكم طبيعتها والافتراضات النظرية التي يقوم عليها تبنيها، مرفوضة {…}، وكذلك هو لا يخلط بين القول بوجود علاقة تاريخية بين الدين والدولة، والقول بوجود علاقة مفهومية ضرورية بينهما، فإن وجود عوامل تاريخية، أو اجتماعية، تفسر ظهور الدولة الدينية لا هو يعني وجوبها معياريا ولا هو يعني أن العلاقة بين الروحي والزمني، بين الدين والسياسة هي علاقة تفرضها الطبيعة المنطقية لكل منهما.[45]
ولا ينشأ الاستقرار إلا بفصل السلطتين، والحد من سلطة رجال الدين حتى يتفرغوا لأمور الدين، والعقائد السلفية الشائعة وكذلك، ومراعاة لمصلحة الدين والدولة، لا ينبغي إعطاء أصحاب السلطة حق التمييز بين الأفعال والحكم عليها، فإذا كان هذا الحق لم يعطى حتى للأنبياء دون أن يلحق الضرر بالدين والدولة على السواء فالأولى ألا يعطى لمن هم أقل قدرة منهم.[46]
لأنه إذا كانت الغاية من الدين هي تدبير الشؤون الروحية للمؤمنين ومساعدتهم على ملاقاة الطريق المؤدية إلى الله، فإن الغاية من تأسيس الدولة ليست تحويل الموجودات العاقلة إلى حيوانات أو ألآلات صماء بل المقصود منها هو إتاحة الفرصة لأبدانهم وأذهانهم حتى تقوم بوظائفها كاملة في أمان ثام، حيث يتسنى لهم أن يستخدموا عقولهم استخداما حرا، دون إشهار أسلحة الحقد، أو الغضب، أو الخداع وحيث يتعاملون معا دون ظلم و إجحاف، الحرية إذا هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة وعلى ذلك فإن السلطة السياسية تكون أشد عنفا إذا أنكرت على الفرد حقه في التفكير وفي الدعوة لما يفكر فيه، وعلى العكس تكون معتدلة إذا سلمت له بهذه الحرية.[47]
قائمة المصادر والمراجع
كازانوفا خوسيه، الأديان العامة في العالم الحديث ترجمة قسم اللغات الحية والترجمة في الجامعة البلمند، المنظمة العربية للترجمة، بيروت طبعة 1م.س 2005
أركون محمد، العلمنة والدين الإسلامي والمسيحية والغرب، دار الساقي بيروت ط 3 1996م
عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت،ط 2016/1 م
دي تانسي ستيفن علم السياسة الأسس، ترجمة رشا جمال الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت الطبعة 1 ،2012 م
جعيط هشام، الفتنة، جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر ترجمة خليل أحمد خليل دار الطليعة، بيروت 1991م
كوثراني وجيه، المجتمع والدولة في التاريخ العربي مجتمع أهلي أم مدني؟ في مشروع النهوض العربي أو أزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطني، دار الطليعة، بيروت، 1995م
عبد الرازق علي، الإسلام وأصول الحكم بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام، اتصالات سبو، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006م
الأفندي، عبد الوهاب، الإسلام والدولة الحديثة: نحو رؤية جديدة، دار الحكمة، لندن، {د.ت}
طويل عبد السلام، مركزية الإصلاح السياسي في الفكر النهضوي، مقاربة أولية رواق عربي، ع37 القاهرة 2005 م
الأفغاني جمال الدين، عبده محمد، الآثار الكاملة، ج واحد رسائل في الفلسفة والعرفان والرسائل والمقالات، إعداد سيد هادي خسر وشاهي، الشروق، القاهرة، ط 1، 2002 م
[1] عبده محمد الإسلام بين العلم والمدينة، كتاب الهلال 14 دار الهلال القاهرة 1960 ص 124-126 اقتبسه عبد الله، حسان الفقه السياسي الإسلامي المعاصر، اتجاهاته قضاياه، مشكلاته، مجلة التسامح ع 25، 2009 م [1] الأفغاني جمال الدين، الأمة وسلطة الحاكم المستبد، العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى ، العرب القاهرة، ط 3، 1993 ص 104 نقلا عن طويل عبد السلام، مركزية الإصلاحأومليل، علي الإصلاحية العربية، والدولة الوطنية، دار التنوير، بيروت، ط 1985 1م {م،س}
الأفغاني، {جمال الدين}، و{محمد} عبده، الآثار الكاملة، رسائل في الفلسفة والعرفان والرسائل والمقالات، إعداد سيد هادي خسر وشاهي الشروق، القاهرة، ط 1، 2002م
[1] الجابري الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996 [1] سبينوزا باروخ، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة وتقديم حسن حنفي، مراجعة فؤاد زكرياء {م، س} دار التنوير ط 1، 2005م[1] كازانوفا خوسيه، الأديان العامة في العالم الحديث ترجمة قسم اللغات الحية والترجمة في الجامعة البلمند، المنظمة العربية للترجمة، بيروت طبعة 1م.س 2005ص 79
[2] أركون محمد، العلمنة والدين الإسلامي والمسيحية والغرب، دار الساقي بيروت ط 3 1996م ص 49
[3] أي إن الإسلام ليس مجرد شعائر دينية بل هو تأكيد الوحدة السياسية والاجتماعية لكل المؤمنين ويظهر ذلك من خلال مفردة الأمة التي تعني المجتمع الإسلامي كله.
يقود هذا التحليل إلى استنتاج أن خاصية العنف المشروع لم تتوافر في الكيان السياسي الذي أسسه الرسول وهذه حجة أخرى من الحجج التي تساق للتدليل على غياب الدولة “LETAS” في الممارسة النبوية.
لا يسعنا إلا أن نستخلص من هذا العرض أن مصطلح الدولة في اللغة العربية كما تم تنزيله على أرض الواقع إبان عهد الرسول لم يصطبغ بالمفهوم المتعارف عليه في زمننا الحاضر بمعنى الكيان السياسي والإطار التنظيمي المؤسسي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته الاجتماعية وموضع السيادة فيه. بإقليمه المحدد الثابت والقائم بذاته في المجال الدولي المقابل لمصطلح LETAS في اللغة الفرنسية وما يطابقه في اللغات الأوروبية أي أن المسلمين إبان الفترة الوسطية قد عاشوا في ظلم يمكن تسميته بالأمة المتوحشة برداء الدين وقيم المؤاخاة والتضامن والإيمان وهو التحديد الذي لا يتوافق والمفهوم الحديث للأمة الذي يبعد عنها عناصر: الدين والعرق واللغة. عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع،لبنان،بيروت،ط 2016/1 م ص106
[4] دي تانسي ستيفن علم السياسة الأسس، ترجمة رشا جمال الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت الطبعة 1 ،2012 م ص 151
[5] جعيط هشام، الفتنة، جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر ترجمة خليل أحمد خليل دار الطليعة، بيروت 1991م
[6] كوثراني وجيه، المجتمع والدولة في التاريخ العربي مجتمع أهلي أم مدني؟ في مشروع النهوض العربي أو أزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطني، دار الطليعة، بيروت، 1995م
[7] عبد الرازق علي، الإسلام وأصول الحكم بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام، اتصالات سبو، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006م ص 55
[8] المرجع نفسه ص 62
[9] مرجع سابق، جعيط الفتنة، جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر ص 33
[10] مرجع سابق، غليون،برهان، نقد السياسة:الدين والدولة ص 56
[11] مرجع، سابق، غليون، برهان نقد السياسة الدين والدولة ص 56
[12] غليون، برهان، نقد السياسة الدين والدولة.ص 59
[13] الأفندي، عبد الوهاب، الإسلام والدولة الحديثة: نحو رؤية جديدة، دار الحكمة، لندن، {د.ت} ص 41
[14] نفسه ص 41
[15] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 106/107
[16] مرجع سابق، غليون نقد السياسة، الدين والدولة ص 341
[17] نفسه ص 341
[18] نفسه ص 115
[19] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 112/113
[20] غليون برهان، نقد السياسة: الدين والدولة، ص60
[21] [21] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 114
[22] نفسه ص 124
[23] نفسه ص 125
[24] [24] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 199
[25] نفسه ص 214
[26] نفسه ص 238
[27] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 239
[28] نفسه ص 447
[29] طويل عبد السلام، مركزية الإصلاح السياسي في الفكر النهضوي، مقاربة أولية رواق عربي، ع37 القاهرة 2005 م ص 89
[30] الأفغاني جمال الدين، عبده محمد، الآثار الكاملة، ج واحد رسائل في الفلسفة والعرفان والرسائل والمقالات، إعداد سيد هادي خسر وشاهي، الشروق، القاهرة، ط 1، 2002 م ص 176
[31] عبده محمد الإسلام بين العلم والمدينة، كتاب الهلال 14 دار الهلال القاهرة 1960 ص 124-126 اقتبسه عبد الله، حسان الفقه السياسي الإسلامي المعاصر، اتجاهاته قضاياه، مشكلاته، مجلة التسامح ع 25، 2009 م
[32] عبده محمد، الإسلام، بين العلم والمدينة، الاقتباس نفسه ص 124، 126
[33] الأفغاني جمال الدين، الأمة وسلطة الحاكم المستبد، العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى، العرب القاهرة، ط 3، 1993 ص 104 نقلا عن طويل عبد السلام، مركزية الإصلاح ص 88
[34] طويل عبد السلام، مركزية الإصلاح، {م،س}
[35] أومليل،علي الإصلاحية العربية، والدولة الوطنية، دار التنوير، بيروت، ط 1985 1م {م،س} ص 103
[36] الأفغاني،{جمال الدين}، و{محمد} عبده، الآثار الكاملة، رسائل في الفلسفة والعرفان والرسائل والمقالات، إعداد سيد هادي خسر وشاهي الشروق، القاهرة، ط 1، 2002م ص 134
[37] مرجع سابق، الأفغاني،{جمال الدين}، و{محمد} عبده، الآثار الكاملة، رسائل في الفلسفة والعرفان والرسائل والمقالات 1 2_ ص 303
[38] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 457
[39] نفسه ص457
[40] مرجع سابق، العشماوي: الخلافة الإسلامية، {م،س} ص 82
[41] مرجع سابق، المسيري، العلمانية، {م،س}، ص 700
[42] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 476
[43] الجابري الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996 ص 113
[44] مرجع سابق، غليون،برهان نقد السياسة، الدولة والدين، المركز الثقافي العربي، ط4، 2007م ص 501
[45] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 486
[46] سبينوزا باروخ، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة وتقديم حسن حنفي، مراجعة فؤاد زكرياء {م، س} دار التنوير ط 1، 2005م ص 97
[47] مرجع سابق، عبد الرحيم العلام العلمانية والدولة المدنية تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها ص 488
* طالبة باحثة