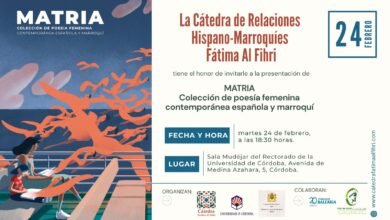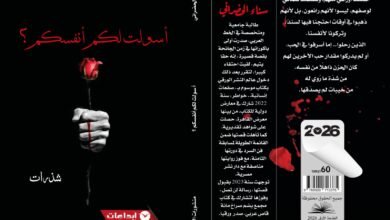كان الفتح الإسلامي قد امتدَّ بسرعة البرق إلى سورية والعراق ومصر، وبلاد فارس وليبيا وتونس، والجزائر والمغرب والسودان، والأندلس وجنوبي فرنسا وجنوبي إيطاليا، وصقلية، وإلى بلاد الترك والأفغان والسند والهند، وغيرها من الأقطار الأُخرى الَّتي فتحها العرب واعتنقتِ الدّين الإسلامي وحدث الانصهار العجيب بين العرب وغير العرب في المدن التي تكونت بعد الفتوح الإسلامية؛ مما أدى إلى تفاعل بين قاطني هذه المدن حضاريًّا وعلميًّا واجتماعيًّا وفنيًّا.
وبينما كانت شعوب الفرنجة والسكسون والجرمان يعيشون في الأكواخ ويعتلي ملوكهم وأشرافهم قمم الصخور في القلاع المظلمة، ومن حولهم رجالهم هم عالة عليهم – كان العرب يشيدون قصورهم القوراء الواسعة العظيمة، أو المنبسطة المستديرة، ويرودون الحمامات كما كان سراة رومة يرودونها من قبل للمساجلة في مسائل العلم والأدب.
وظلت الحضارة الإسلامية مهيمنة على العالم طوال خمسة قرون، وكانت ممثلة للحضارة الإنسانية طوال العصور التي سيطرت فيها، وما زالت آثارها واضحة في تلك الحضارات، إذ إن العناصر الحضارية الإسلامية قد دخلت ضمن التراث الإنساني.
وسرعان ما توطَّدت الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة في البلدان المفتوحة؛ فاحتكَّت بالحضارات والثَّقافات الأخرى، وأسهم الإسلام في العصور الوسطى في ازدهار التيار الإنساني والعقلاني، وأوجد معرفة مشتركة بين الجميع، وأنتج معرفة أسهمت جميع الشعوب والثقافات التي دخلها الإسلام في توليدها وبلورتها وتطبيقها عمليًّا.
ومن تلك الشعوب التي استوعبها الإسلام الفرسُ والإغريق، والهنود، والبربر، والصقالبة، وقد تجاوزت النزعة الإنسانية الإسلامية حدود الأديان والطوائف والقوميات والأعراق لكي تصل إلى الإنسان في كل مكان.
وكان لهذا التلاقح الفكري أثر كبير في ازدهار الثقافة الإسلامية. وتهيَّأ المناخ لحركة علميَّة واسعة بدأت بالاهتِمام بالتَّرجمة، خاصة خلال فترة الازدهار من العصر العباسي، وعلى مدى قرن كامل حوالي (132-323ه/ 750-850م) تُرجمت كتب متنوعة في الرياضيات والفلك والطب والفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية.
فكان خلفاء بني العبَّاس يشترطون على أباطرة الروم بيْعَهم المخطوطات اليونانيَّة في مختلف العلوم لترجمتها إلى العربية، حتى إنَّ المنصور كان يدفع ما يساوي وزن المخطوطات ذهبًا، وكان أهم مركز من مراكز حركة الترجمة هذه هو بيت الحكمة الذي أنشأه الخليفة عبد الله المأمون (170 – 218هـ / 786 – 833م) في بغداد، ووقف عليه الأموال للذين يريدون أن ينقطعوا إلى نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية.
وقد تأقلمت الجماعات المسيحية المختلفة في المشرق، وحتى في الأندلس، مع البيئة الثقافية الجديدة، فاستعربت بسرعة غريبة، وأغنت الثقافة العربية بما نقلته عن تراثها القديم: اليوناني منه والسرياني والقبطي، وحتى اللاتيني.
ثم أقدم أبناؤها على التعمق فيما نقلوه وعلى تطويره؛ فالمسيحيون إذًا ليسوا غرباء عن الثقافة العربية أو دخلاء عليها، بل هم، إذا جاز هذا التعبير، حجر زاويتها، وهمزة الوصل بينها وبين ثقافة العالم المشرقي القديم. فقد أسهموا في نشأتها وتطويرها وانتشارها إسهامًا لا ينكره إلا الجاهل أو المغرض.
إن البعض من هؤلاء المؤلفين العرب المسيحيين معروف لدى العرب والمستشرقين، من مثل: حنين بن إسحق (194-260 ه/810-873 م)، وإسحق بن حنين (215-298 ه/830-910 م). وقسطا بن لوقا البعلبكي: (ت300 ه/912 م). ويحيى بن عدّي المنطقي (ت364 ه/974 م)، وعيسى بن إسحق بن زُرعة: (ت396 ه/1008 م)، ويوحنا بن البطريق (ت203 ه/815 م)، وأبو بشر متي بن يونس (ت328ه/-940 م).
ونختار من ضمن تلك الشخصيات شخصية أسهمت في تأكيد النزعة الإنسانية العالمية للحضارة الإسلامية. وهو ابن ناعمة الحمصي (نحو 220 هـ/ 835م) وهو عبد المسـيح بن عبد الله الحمصي الناعمي سلام الأبرش من النقلة القدماء في أيام العباسيين، عمل بالفلسفة والترجمة في بغداد، وهو من أولئك النصارى اليعاقبة الذين استعان بهم خلفاء آل عباس لنقل النصوص اليونانية إلى السريانية ومنها إلى العربية.
وقد اهتم بالترجمات الفلسفية خاصة المرتبطة بأرسطو، كونه يعد أهم فيلسوف إلى جانب أفلاطون تأثر بهما العرب، ولما له علاقة بالجانب المنطقي، حيث أقبل النقلة على كتبه المنطقية والطبيعية والإلهية والأخلاقية، وكان المنطق قد تم تناوله بإسهاب في العالم الإسلامي، شرحًا وتأليفًا بعد الترجمة، من طرف أعضاء مدرسة بغداد، ومنهم ابن ناعمة.
واشتهر بترجمة كتاب “أثولوجيا”Theologia” أي: “لاهوت” سنة 220 هـ والمنسوب خطأ لأرسطو للخليفة المعتصم (218 – 227 هـ / 833 – 841 م)، وهو في الواقع مختصر للكتب من الرابع إلى السادس من (تاسوعات) أفلوطين (204 – 270م)، وهي الخاصة بالنفس، وقد راجعها الكندي نفسه، ونسبت إلى أرسطو، وقد أثرت الترجمة ونسبتها الخاطئة للفيلسوف اليوناني تأثيرًا كبيرًا في الفلسفة الاسلامية. وقد اعتمد الفارابي على هذا الكتاب للتوفيق بين آراء أفلاطون وأرسطو في كتابه “الجمع بين رأيي الحكيمين”.
والكتاب يصور صعود النفس إلى العالم العقلي بالرياضة البدنية، والتأمل حتى تتمكن هذه النفس من اختراق حجب الغيب وتصل إلى نور الأنوار. ويميل هذا الكتاب إلى الصوفية التي ترى الإله موجودًا في كل شيء (Pantheism) أو حلول الإله في كل شيء.
ولذا كان لهذا الكتاب أثر كبير في تطور التصوف، حيث يقول عبد الرحمن بدوي: “وأهم نص في هذا الباب هو كتاب (أثولوجيا أرسطو طاليس)، وهو -كما نعلم- فصول ومقتطفات، منتزعة من التاسوعات الأفلاطونية، وفيه نظريات الفيض والواحد التي ستلعب دورًا خطيرًا في التصوف الإسلامي، خصوصًا عند السهروردي المقتول وابن عربي، وفيه نظرية (الكلمة) أو “اللوغوس”.
ولا شك في تأثر الصوفية المسلمين ابتداء من القرن الخامس الهجري بما في (أثولوجيا) من آراء. وإنما الخلاف هنا هو في هل وصل تأثيره إلى التصوف الإسلامي مباشرة، أو عن طريق كتب الإسماعيلية، وكلها حافلة بالتأثر به.
وقد نشره المستشرق الألماني فريدريتش ديتريصي (Friedrich Dieterici) (1821 -1903 م) في برلين سنة 1882م، ثم نشره عبد الرحمن بدوي في كتابه “أفلوطين عند العرب” سنة 1995م.
كما ترجم قسمًا من كتاب السماع الطبيعي، وهو صحيح النسبة إلى أرسطو. كما ترجم “الكتاب” لأرسطو، وترجم أيضًا كتاب “سوفسطيقا” (Sufistiqa) “الأغاليط” أو المغالطات إلى السريانية، وترجمه إسحاق بن حنين وابن زرعة من السريانية ويحيى بن عدي إلى العربية.
والجدير بالذكر أن سوفسطس معناها حكمة مموهة وعلم مموه أو مظنون بها أنها حكمة وليست كذلك.
وكان منهجه في الترجمة أن ينظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات الیونانیة وما تدل عليه من المعنى، فیأتي ابن ناعمة بلفظة مفردة من الكلمات العربیة ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى فیثبتها، وينتقل إلى الأخرى كذلك حتى يأتي على جملة ما يراد تعريبه.
وقد اهتدى مع غيره من المترجمين إلى وسيلة تعريب المصطلح الفني لا ترجمته أي نقله كما هو بحروف عربية.
ولذا قالوا “أنالوطيقا” و”ريطوريقا” و”أبوطيقا” و”سوفسطيقا” و “أثولوجيا” إلخ. وقد وردت في كتاب تاسوعات أفلوطين عبارات وفقرات بنصها مطابقة للأصل الأفلوطوني.
وهذا يدل على أنه تحرر وتوسع من القيود، وكان من المرونة ما جعله لا يغلق الباب على نفسه، وجعل اللغة لعربية تساير التطور والتحديث، وهو ما يعرف باسم “المعرب”، ومن المعروف أن اللغة العربية الفصحى المتداولة في العصر العباسي تختلف تمام الاختلاف عن العصور السابقة، وكان للترجمة دور كبير في ذلك التطور. وكل تلك الجهود أثرت وأغنت اللغة العربية وأعطتها أبعادًا علمية وفلسفية وعالمية.
ونؤكد أن التيار الإنساني العربي الإسلامي يشمل إنتاج كل المثقفين أو المفكرين الذين كتبوا وترجموا باللغة العربية، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين، أم يهودًا، وجميعهم أسهموا في ازدهار التيار الإنساني، ساعد على ذلك وجود تعددية عرقية وثقافية في تلك المرحلة في مدن بغداد، والري ودمشق، وقرطبة. أدى ذلك لما يمكن تسميته بالانفتاح والتوسع الثقافي والدمج الإنساني والفكري.
كانت الترجمة دائمًا جسرًا للتواصل بين الثقافات المتعددة والمتنوعة على مر التاريخ، وتعزز التلاقي والتلاقح، وترعى التقارب الثقافي بين الشعوب، وتدحض الصدام، وتدعم الحوار والتبادل الثقافي بين أمم الأرض، وتفتح النوافذ على الثقافات الأخرى للشعوب الأخرى ما دامت معرفة الآخر تقود تدريجيًّا إلى معرفة الذات عن طريق “المقارنة” و”التواصل”، كما كانت تغني اللغات وتجعلها “حية” على الدوام، وتوفر الأرضية للبحث والإبداع.
والترجمة تعد أرقى هذه الطرق، إذ من خلال ترجمة ثقافة الآخر تنساب أفكاره ومعتقداته وتجاربه بسهولة ويسر.
والترجمة تنهض بأبجديات التواصل الثقافي الكوني، بل إن الترجمة تشكل حافزًا للإبداع الحضاري، فمن المؤكد أن للترجمة دورًا فعالًا في حوار الثقافات وتلاقح الأفكار، وفي التعرف على ثقافات وتجارب متنوعة وجديدة، وهي مقوم رئيس في مد جسور التواصل بين الشعوب والمساعدة على إزالة أسباب الصراع بين الثقافات، فبالترجمة تتواصل الثقافات، وهذا الدور لم ينقطع على مر الزمن.
والترجمة بصفة عامة تلعب دورًا مهمًّا في الحوار الثقافي وفي نقل الحضارة والثقافة والفكر، وهي في جوهرها عملية مقاربة ومقابلة بين طرائق وأساليب لغوية مختلفة قد تتشابه حينًا وتختلف أحيانًا أخرى. وهي وسيلة انتقال المعلومة من مكان إلى آخر، أيًّا كانت أداة هذا النقل.
ومن هنا فإن أنماط الترجمة وأنواعها تختلف باختلاف الغاية من الترجمة، وتتراوح من التركيز على فحوى ومضمون النص والنواحي الجمالية والفنية فيه.
ولكن الغاية الأساسية من الترجمة بلا شك هي إيجاد مقابل دلالي طبيعي في اللغة المترجم إليها. وهذا ما يميز الترجمة عن سواها من النشاطات اللغوية الأخرى كالاقتباس.
وقد أسهمت الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الأوروبية، فقد كانت مدينة طُلَيطِلَةُ بعد سقوطها في أيدي المسيحيين سنة 478 هـ/1085م المركز الرئيس لحركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية، وقد أنشأ “ريموند” رئيس أساقفتها مكتبًا للترجمة، وكان المستعربون من أهل الأندلس أكبر المساهمين في حركة الترجمة، ومن أشهرهم “دومونيقوس جوند يسا لفى” و”بطرس الفونسي” و”حنا الأشبيلى” وغيرهم، وقد ترتب على هذه الحركة وجود ثورة علمية وفكرية هائلة في غرب أوروبا؛ ذلك لأن المعارف الجديدة التي نقلت من العربية إلى اللاتينية وضعت أمام الأوربيين طريق الحياة، وبددت ضباب الجهالة الذي حجب عنهم رؤية الحضارة، وأيقظتهم من سباتهم العميق، ونبهتهم من غفلتهم الطويلة؛ فأقبلوا على دراسة الحضارة الإسلامية بشغف بالغ ونهم شديد.
وفي نهاية القرن الحادي عشر الميلادي بدأت أوروبا في الترجمة من العربية إلى اللاتينية، وترجم في هذه المرحلة العديد من الأعمال التي كتبت أصلًا باللغة العربية جنبًا إلى جنب مع الترجمات العربية للأعمال اليونانية القديمة.
وقد تأسست لهذا الغرض لجنة من المترجمين في مدينة طُلَيطِلَةُ (Toledo) الإسبانية في عام 1130 م برئاسة كبير الأساقفة ريمون (Raymond)، وكان لهذه اللجنة الفضل في نقل العلم والمعرفة اللذين توصلت إليهما الحضارة الإسلامية إلى الأمم المسيحية في أوروبا.
كما ترجم كثير من الأعمال سواء من العربية أو اللاتينية أو اليونانية إلى لغات أخرى عديدة، من بينها الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والعبرية والألمانية. وهكذا تخللت العلوم والثقافة العربيتان أوروبا الغربية عن طريق الترجمة.