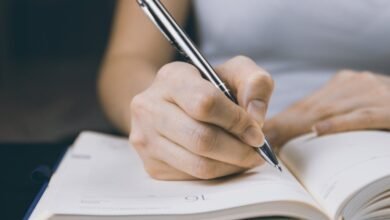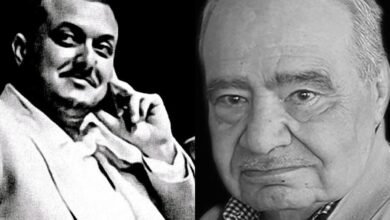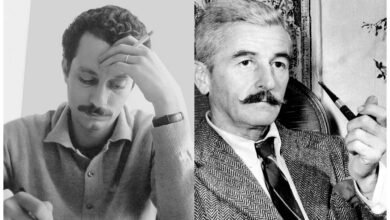لا أغالي ولا أجامل إذا قلت لك أيها القارئ الكريم إنَّ أشد ما جذبني نحو رواية الأستاذ المرحوم / إبراهيم إسحق إبراهيم (1946 – 2021) (حدث في القرية) الصادرة في طبعتها الأولى من وزارة الإعلام والشؤون الإجتماعية بالخرطوم السودان عام 1967م.
الثانية من دار مسارب للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 2022، ليس كما جاء في المقدمة ولا ما جاء في محاولة تعريفية بالكاتب وروايته كما درجت العادَّة فهذه الإشارات التي في صدر الكتاب الرواية كلها فيما وجدته أكثر من عادية إذ شملت الإشارات كلمة “بطريقته الخاصة وبصمته الأسلوبية المتفردة”و “أنبأت هذه الرواية منذ اصدارتها الأولى في العام 1969 عن ميلاد راوية ناضجة ومتفردة فكراً وفنَّاً كما أعلنت أيضاً عن ميلاد روائي عبقري ولد بأسنانه كما يقول المثل” ص 5، ولا غيرها من العبارات التي يمكن أن يراها أي قارئ أنَّها قوية ومعبِّرة ولا هم يحزنون.
إنَّ الشوق والحنين والصوت القادم من أقصى بطاح السودان الغربي ودارفور تحديداً وتسجيل صوت المجتمع البسيط في قالب روائي عميق الصدى بعيد الغور بسيط الفكرة / تمساح يفتك بأهل القرية الوادعة ويسبب الرعب أو هو غول يتهجَّم على السكَّان وهم في جمهرة من أمرهم كي يجدوا له مخرجاً لبقية سياق الرواية / جيد السِّنخ واقعي الحدث مقبول الانطباع وما إلى ذلك مما هو موغل في النفس بالرضا والقبول لهم جدير أن يُلتمس في هذا الباب.
“مقبول الحدث” لا أعني بها موضوع الرواية – التمساح أو الغول الغاشم [ ما مشيتوا الوادي ما قالوا جا في الموية تمساح كتل ناس وحاجات ؟.
من الصباح زمان، كتل وليد وبقر ] ص 86 – 87، بل أعني بها تحديداً نقل الحياة المجتمعية بلا رتوش أو استهلاك لفظي وتكلف إنشائي وإن كان الكاتب غالا في إشباع النص بصفة المكان من أول صفحة لآهر صفحة تقريباً بصورة كثيفة وكثيرة وهو موضع قراءتي هذه، وهي حياة البداوة والريف بكل سلبياته وإيجابياته من أكثر من ناحية منها على سبيل المثال لا الحصر اللغة المستعملة بعامَّة وطريقة الحوار واختلاق الحدث بلا ريب.
اللغة المستعملة بعامَّة هي ديدن روح الرواية ولم يخلط الكاتب ههنا كما في أكثر من عمل روائي بين الفصيح والعامي مثلاً كرواية الأستاذ العبَّاس علي يحي العبَّاس.
“رحيل الفرح ” التي جمع فيها بين اللغة العربية الفصيحة والعامية المحلية السودانية وهو إذ فعل ذاك إنما رام طريقته الخاصَّة في الكتابة والتعبير لكنها لم تتفق لي مثل ما اتفقت لي رواية “حدث في القرية” ذلك لأنَّ الروح والنَّفَس اللتين استعملهما الكاتب موغلة في التلقائية ولم يتكلف معرفة اللغة العربية، ثم مرامه مرام إبراز صوت الهامش إذا صحَّ التعبير وهو غير صحيح حينما نتناول عملاً أدبياً روائياً إذ محله الجانب السياسي كما أرى وهو الصوت الموغل في التراث الشعبي المتعمق الجذر في الحياة اليومية الطيبة علماً بأنَّ الرواية كل أحداثها حدثت في يوم واحد، ولا أقول مثلهم بأنَّ ههنا العبقرية بل أقول ههنا التكنيك الفني الرائع أو قل: فن كتابة الرواية باحترافية طبيعية إذ لم أجد فيها الصنعة كما في غيرها فتأمَّل!.
إنَّ الشوق والحنين اللذين في هذه الرواية من حيث هي أدب عربي قح، لهما ديدن التوصيف الرائع لحياة مجتمعية بسيطة للغاية كل همَّهم العيش بدون مشاكل وبدون حدث يعكِّر صفو طبيعة سير حركة حياتهم وهنا العبقرية بشكل آخر، لكنَّ الصوت العميق القادم من الإرث الفلكلوري الشعبوي بمنطقة الحدث هو جوهر موضوع الرواية لا التمساح ولا الغول ولا هم يحزنون وإن بدا ذلك فهو غير ذلك، قالت السعلاة وهي الغولة أو أنثى الغول لعمرو بن يربوع حينما تكشَّف عنها وجهها عند نزول المطر ورؤية البرق.أمسك بنيك عمرو إني آبق، قد لاح من أرض السعالي آلق.
يهتم النُقَّاد غالباً بعُدَّة محاور يجب توفرها في أي عمل روائي وهذا من حقِّهم بطبيعة الحال وهي: المكان والزمان والحدث والشخوص، وما عدا ذلك كالأسلوب والقيمة الفنية والإضافة الجديدة لحل مشكلة ما يتناولها الراوي فهو من الأهمية بمكان لكن ، أنا أرى في هذا العمل الفني الجيد رسالة قوية هي “أنا هنا إذاً أنا موجود” كتبت الرواية قبل أكثر من خمس وخمسين سنة وقد حقق الكاتب هذه الوجودية بثوب قشيب مهم للغاية وهي في لغة الحوار وأسلوبه ومن ثمَّ استعمال اللغة البسيطة المحلية القروية البدائية نقلاً غير مخل ومحبب في ذات الوقت ، اقرأ معي من ص 174: [ في شجرة أخرى تحدَّث عجوزان: البلا الفي الدنيا دا ما كفاية يا خوي ؟ خلي ساكت
أنت شفتو يا محمد أحمد لما مرقو بقولوا الموية مش الكتلتو، بقولوا بعوم كويس، بقولوا في شغل آخر جو البير عضَّاهو كن دبيب وكن آخر، قالوا لي مأكَّد، الزول زيه ما بموت كن وقع في هويرة ولا بير إلا ينردم عليهو التراب حس الخفرا ديل في الحر دا بعمل ليهو شنو ، بقعدو حارسين كدا نحن نحرسهم كمان؟.
مافي شغل بلادا، يقعدوا المساكين في الحر دا لمن يمشي ولا يجي زول حكيم يقدر يمرقو ببصاره، والإ البلد دا يصبح خربان فوق لروسينا كلنا.
وتكلم الشيخ عبد الرحمن كأنَّه لم يعني أحداً ممن حوله:
قاعدين للفساد وحيدو، ولا بصلو ولا بصومو ولا بزكو وما كتر ليهم إلا الشراب والفساد في نساوينم، ولمن يجيهم مصيبة شوفو النطين وشوفو الحيرة ] ص 174 – 175.
هذه هي الحرفية والاحترافية التي تعكس عملياً الواقع المعاش في دارفور بمنطقة نائية جداً عن صخب المدينة وضوضاء الحضارة وهمهمة الإعلام وما أشبه، وقد أفلح الكاتب في نقل هذه الواقعية في القالب الروائي تعبيراً عن صوت أصيل يتمادى ويتنادى في آذان العالمية والاقليمية وبالذات العاصمة الخرطوم، ليثبت أنَّ هناك حياة غير مرئية للعالم الحضاري المثالي البندري حين يخاطب المثقفين ورجال السياسة وأهل الخرتوم ، يجب أن تٌسمع وأن تُرى بلا شك.
إقرأ معي هداك الله لهذه الفقرة من صفحة 86 – 87: [ تدفق المزارعون القادمون في طرقات القرية في كل ناحية فرد يهرول تجاه الوادي، خرج الناظر إلى الفناء ينفث دخان سجارته فإذا بالناس قادمون يتسابقون، وبدأ يشك شكَّاً كبيراً، لم يستطع كبت نفسه لمجرد أنَّه يخاف على نظام المدرسة منهم، فخرج إلى الطريق ، مرَّت به إحدى النسوة ولم يسألها ورآه أحد الشبَّان:
أهلاً حضرت الناظر الحاصل شنو ؟. ما مشيتوا الوادي، ما قالوا جا في الموية تمساح كتل ناس وحاجات ؟ تمساح ؟ من الصباح زمان، كتل وليد وبقر.
الصور المتحركة في ثبات النص من حيوات العمدة والناظر والطلبة والمدرسين وأحداث القرية وتماوجها بين أصالة المنبت وأصيل المطلع وبين زوجاتهم وتقلب أمزجتهم وطبيعة سير حياتهم بحركة معاشهم ومعادهم، لهي نقل متقن وصادق لطبيعة المنطقة ومدى ثقافاتهم وطموحهم وهمومهم ومشاكلهم وغاية أمانيهم، فلك أن تسمع الصوت الخارج من النص إن كنت تحسه وتسمعه مثلي: [ قاعدين للفساد وحيدو ، ولا بصلو ولا بصومو ولا بزكو وما كتر ليهم إلا الشراب والفساد في نساوينم، ولمن يجيهم مصيبة شوفو النطين وشوفو الحيرة ] ص 174 – 175، ههنا لا ترى التكذيب والإعلام المضلل في حياتهم بشرها وخيرها لكنك بكل تأكيد واجد حس المعايشة والمجادلة والتلقائية والفطرة في تلك الأصوات في لسان حالهم، الصادق الأكيد.
أنا لا أغالي في محاولة البحث عن لغة تعبر عمَّا في نفسي تجاه هذا العمل الفني والرسالة الهادفة للمتلقي غير ما كتبت ومن نعم الله علي إني عشت في الكنابي مع ثقافة أهل دارفور لفترة طويلة من الزمن، فانا أعرف بساطتهم وتركيبتهم المجتمعية السمحة حينما يزرعون أو يحصدون أو يجتمعون / الجنقو مسامير الأرض / في مناسبة صغيرة أو كبيرة فلا يدور الهمس ولا الصوت العالي إلَّا في أمور أكثر من عادية وأكثر من بسيطة ولا يرجع سبب ذلك في تدني مستوى التعليم وأثره عنهم بقدر ما يرجع لخصوبة التركيبة الذهنية والاجتماعية في حياتهم فأشنع لفظ يمكنك سماعه بينهم أو شتيمة أو إساءة هي (يا تلفان) أو (يا هوان) وليس كمثل أهل الخرتوم الذين في ناديهم المنكر بأشنع الألفاظ وأقبح الألقاب التي تشمئز منها النفوس.
أذكر في هذا المقام عندما كنت في مشروع الجزيرة متجولاً بحكم مهنتي في الهندسة المدنية مديراً للمشروعات فأقيم في أي كمبو / مساكن بسيطة من القش والطين وروث البهائم / الرجل الفاضل من أهل دارفور واسمه مِرِسْ، وكان يقوم بالزراعة لعدد من البَلْدَات وكنت أقيم مرات معه فترة النهارية أو أزوره لماماً وكان يزرع البامية والعجُّور والمحاصيل الغذائية المعروفة، فما كان منه حين انقضى عملي إلَّا أن حمَّلني هدية قيِّمة جوَّالاً من البامية الخضراء قطعاً مباشراً من الحوَّاشة أو البَلْدَة ومعها جوَّالاً آخراً من العجُّور الطازجين وذهبت بهما فخوراً للخرتوم وما زلت أذكره بالخير بلا شك.
الروائي الفذ إبراهيم إسحق إبراهيم، يطيب لي أن أقرأه من هذه الزاوية لا غير ولا أبالي لمن قرأها (حدث في القرية) بغير ما رأيت، فذاك الصوت والحس القادمان من أقاصي بلاد غربي السودان أسمعه بقلبي وأتلفت له بروحي أينما حلَّ أو ارتحل حين يكون الشوق والحنين إلى قطعة من بلادي في الأدب العربي بمثل تلكم الصورة المحكية إذ لم أشأ أن أفسد رونقها البديع بمحاولة الفلسفة والتفلسف بالنقد والقراءة كما يحبه النُقّاد وأضرابهم.
فأنا واجد فيها الحياة برونقها وأصالتها وبحبوحتها وأريحيتها وروحها التي تجبرك جبراً على الولاء والوفاء والحب للمكان وللناس ولأهلنا الطيبين في بقاع السودان المكلوم وقاتل الله السياسة فقد أفقدتنا حلاوة التعايش السلمي لحد كبير.