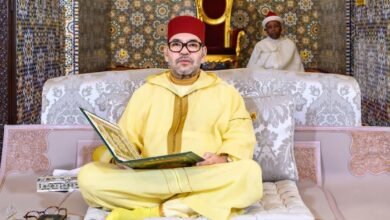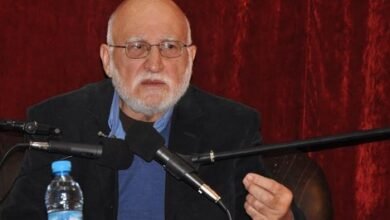منذ كتاب محمد عابد الجابري “أضواء على مشكل التعليم بالمغرب” لم يطرح التعليم كمسألة فكرية، و ذلك رغم المجهود الكبير الذي بذله الأستاذ مصطفى محسن باعتماد آليات سوسيولوجيا التربية.
التفكير في المسألة التعليمية، في عمومه، اتخذ طابعا تقنيا/حِرَفيا على مستويين:
على مستوى تصور الدولة، حيث أصبح التعليم مسألة تقنوقراطية، و خصوصا بعد الإصلاحات المتتالية التي أفرغته من حمولته السوسيو-ثقافية و حولته إلى حقل تجارب، من الأهداف إلى الكفايات…
على مستوى تصور النخبة البحثية، حيث غلبت المقاربة البيداغوج-ديداكتيكية في انسجام تام مع التوجه التقنوقراطي الرسمي، و بدل أن تنشغل الممارسة البحثية بمطارحة الإشكاليات الفكرية و السوسيولوجية تم الاكتفاء بمباحث البيداغوجيا و الديداكتيك.
هذا التوجه التقنوي/الحِرَفي للمسألة التعليمية، رسميا و بحثيا، عزلها في ركن ضيق قصي و فك ارتباطها بالمشروع المجتمعي المغربي، و هذا بعد أن كانت في صلبه بل و موجهة له خلال مرحلة الاستقلال.
فالمبادئ الأربعة لإصلاح التعليم (التعميم؛ التوحيد؛ المغربة؛ التعريب) كانت أكبر من توجيهات بيداغوج-ديداكتيكية، لقد كانت توجيهات سوسيو-ثقافية تموقع المدرسة في صلب المشروع المجتمعي المغربي.
فمن منظور التوحيد، كان التوجه نحو خلق مدرسة وطنية موحدة تتجاوز التصور الاستعماري الذي فككها إلى جزر تخدم أجندته.
و من منظور التعميم، كان التوجه نحو تعميم تمدرس أبناء المغاربة؛ في المدن و القرى؛ باعتباره المدخل الرئيسي نحو بناء مغرب التنمية بعد مغرب الاستقلال. و من منظور المغربة، كان التوجه نحو توظيف رأس المال البشري المغربي كبديل للأجنبي؛ غريبا و شرقيا؛ تحت شعار وطني المغرب للمغاربة.
و من منظور التعريب، كان التوجه نحو توظيف اللغة الأم كآلية لخلق تعليم وطني تمتد جذوره في تاريخ الأمة العربية الإسلامية التي مثّل المغرب فيها؛ عبر التاريخ؛ مركز حضارة الغرب الإسلامي.
هذه المبادئ الأربعة كانت تمثل في حينها مرتكزات المشروع المجتمعي المغربي أكثر مما مثلت تصورا بيداغوج-ديداكتيكيا مختزلا، و هذا يعني أن المدرسة قد كانت في صلب المجتمع و قائدة لمشروع الدولة في التحرر و الاستقلال و التنمية.
أزمة المدرسة المغربية؛ اليوم تتجلى في انحسارها ضمن مجال بيداغوج-ديداكتيكي ضيق قصي بعيد عن اهتمامات المجتمع و قضايا الدولة، و هذا يتعارض مع ماهيتها و وظيفتها.
التجارب الدولية المقارنة تؤكد ذلك، و خصوصا في التجارب الآسيوية الصاعدة حيث كانت المدرسة في صلب المشاريع المجتمعية و قائدة للتصورات الرسمية للدول، باعنبارها المشتل الأول الذي تزرع و تنبت فيه بذور النهضة الثقافية، و تتبلور داخله الاختيارات السياسية و الاقتصادية للدول .