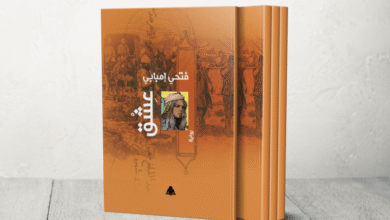عادة ما ينقلك د. سعيد يقطين إلى أبعد مما تتيحه الغواية الأيديولوجية في مجال النظرية الأدبية والتحليل السّردي. يحترم مهنته ويلاحقها بمزيد من الاجتهاد، ليدمغ التجربة المغربية بوفرة من القراءات، بعضها يُبيّؤ كبرى النظريات في السرديات داخل المجال العربي وما يحبل به من تراث حكائي، من خلال الاهتمام بالحكاية الشعبية، وبعضها لعب دورا أساسيا في تطوير السرديات التطبيقية وتوسيع مجالها، حيث أمكن ليقطين – الذي أعتبره جيرار جنيت العرب-أن يوسع من مدى ووظيفة السرديات، لتصبح طرفا في موضوعات كلّ علم.
هناك تراكم كبير يصعب حصره، لكنه يعكس تطور النظرة السردية عند يقطين. وهو يدرك مخاطر الأيديولوجية،ولعلّه كان أكثر احتياطا من تأثير التجارب والميول الأيديولوجية في مهام البحث العلمي.
فالأيديولوجيا في نظر يقطين تتميّز بالثبات، وبأنّ العمل على تغييرها ينتهي بزوالها، بخلاف العلم ، هو متحوّل، وتغييره ينتهي بتطوره.
عادة ما نهتم بالأفكار الغربية المثيرة، لكننا نغفل أفكارا أخرى غربية صامتة. لمن نعود يا ترى حين نعود؟ ليس لدينا نيتشه ولا هيدغر ولا ماركس نعود إليه، بخلاف عودة الغرب إلى هؤلاء، ذلك لأنّنا أصلا اختزلناهم في مقولات سرعان ما تنطفئ فننساهم، هذا هو موقف يقطين، فهو يسعى من دون أن يُفاضل بين المناهج، لكنه يشترط تمثّلها على قدر مما يتيحه تنزيل النظرية والمنهاج علما، يسعى إذن ، كما سيفعل في ” قال الراوي : البنيات الحكائية في السيرة الشعبية”، إلى تعزيز فكرة باختين حول وجود أصل للرواية في الحكاية الشعبية، خلافا للفكرة التي ترى في الرواية ملحمة بورجوازية.
الميراث العلمي للمعلم يقطين كما يحب أن يوصف، يتطلب مواكبة واهتماما أكاديميا عاليا، فلقد أغنى المكتبة العربية برصيد كبير في مجال السرديات. وبعض المفاهيم التي أشار إليها في وقت مبكّر ظهرت مؤخرا في بعض البلدان الغربية – وأمريكا اللاتينية- حول السوسيو-سرديات. لكن ما هو مهمّ هنا هو نظرته للعلم ومهامه، والتزامات الباحث.
إنّنا في نظره، في المغرب، لا زلنا نخجل قليلا، في مجال الكتابة، حيث وبخلاف بعض البلدان، يتهيّب الإنسان المغربي فعل الكتابة قبل أن يكون قد قطع ما يكفي من تحقيق شروطها. هذه الفكرة بالفعل صحيحة، وإن بدأت تتراجع لصالح العدوى الممتدة، حيث هناك من النصوص المهمة المغمورة التي لا تجد طريقا للتعريف بأصحابها، وهناك نصوص تسجل حضورها في عصر التفاهة، وبالتالي نحن في اتجاه تراجع ميزة الكتابة.
في جامعة جان مولان، ليون 3، حيث شغل منصب أستاذ زائر خلال عامين، سيكتشف مفهوم الأستاذ الباحث، هناك ستُسأل عن:
– ما هي الخلفية الفلسفية التي تنطلق منها
– في أي موضوع تشتغل “الآن”
– كم سنة استغرق بحثك
– ما هو البحث الذي ستعمل عليه بعد هذا البحث
هنا يبدو أنّنا أمام مهمّة باحث تخلوا منها جامعاتنا، حيث غايتها في نهاية المطاف تكوين الأطر وليس تكوين علماء باحثين. هذا جانب من هموم عالم سرديات، وفيٌّ للنظرية، منهمك في التطبيق، مترصد لنشأة المفاهيم وأفولها، قيام العلوم وانقلابها، منصت لهسيس النصوص، بصّاص في طبقات البنيات السردية.
هذه بعض من هموم المعلم يقطين، وأما إسهاماته، فهي تتطلب وقفة أخرى أكثر تفصيلا، في مجال تحليل الخطاب الروائي، البنيات الحكائية، السيرة الشعبية، وقد وضع في ذلك أبحاثا، تصلح لمقاربات أوسع، وهو ما ننوي القيام به على مستوى إتمام تحليل الخطاب العلمي والأدبي في أفق تحدّيات الأيديولوجيا العربية المعاصرة.
لقد تربّع الناقد د. سعيد يقطين على عرش السرديات والنظرية الأدبية في المغرب وعموم الوطن العربي، وكنت من المتابعين لإنتاجاته التي احتضنتها مجلات عربية وملاحق ثقافية محلية فضلا عن مؤلفاته النقدية العميقة، منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما، أفادتني كثيرا بقدر ما ألهمتني أكثر.