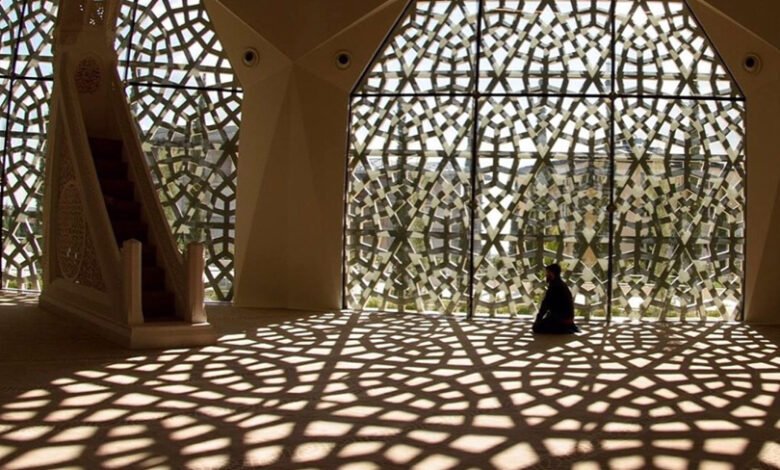
جدل الفهم والتطرّف
يضعنا جدل الفهم والتطرف في صلب العلاقة بين الفكر والواقع، غير أنّ الإشكالية تصبح هنا حقيقية حينما نتجاهل التأثير المتبادل، لا بل كيفية هذا التبادل وحدوده، فننظر إلى التأثير من جهة واحدة وإلى الأزمة في طرف واحد، وعلى هذا الخلل تتأسّس أحكامنا المتضاربة: إمّا إدانة للواقع وشروطه وإمّا إدانة للخطاب، يزداد الأمر سوءا حينما نتحدّث عن الواقع ككتلة صلبة ومسطحة أو حين نتحدّث عن الخطاب كبيان بريئ وليس كنسق دلالي.
شكّلت الظاهرة الدينية كما تصرّ المختبرات السوسيو-دينية على ذلك التعبير – وشطر منه أساسي من حيث امتزاج التدين الجماعي بشروط سوسيو-ثقافية وتاريخية – ظاهرة منفصلة ليس للضرورة التحليلية بل من حيث اعتبار تلاشي الوظيفة، فالظاهرة الاجتماعية باتت مفهوما مائعا منذ التفت دوركهايم إلى معضلة المفهوم في قواعد المنهج وكذا في الانتحار، حيث أدان من خلالها حتى طريقة استعمال السوسيولوجي نفسه لمفهوم الظاهرة، لكن على كل حال فالدين بهذا المعنى عند دوركهايم فقد وظيفته الإجتماعية، وهو شيء يخالف واقع تمأسس وهيكلة الحقل الدّيني، وسيتابع من ينازع دوركهايم الريادة السوسيولوجية والتأسيس، أعني أوجست كونت الذي حكم على اللاّهوت بالتجاوز في قانون الحالات الثلاث، وسيعيده ماكس ويبر كعامل مساهم في الإنتاج ونمطه أيضا.
وتنهض المقاربات السوسيو-دينية على تحكم الشروط الاجتماعية الواقعية في إنتاج الخطاب الدّيني، وللفرنسيين ميل غريزي للتحليل السوسيولوجي للتطرفات الدينية، غير أنّنا نصادف نمطا مهما في الاستشراق الروسي الذي يمنح النصوص أهمية قصوى في المقاربة.
هل سيساعدنا التقليد الفرنسي على فهم الدين والمقدّس كما يفهمه الإنجليز والألمان؟ شلايرماخر نفسه ينعى هذا الاختزال والإستهتار الفرنسي لكل ما هو قدسي على الرغم من اهتمامهم بالغرائبي، وعن هذا الإستهتار الذي شكل علامة بارزة في الفن والآداب الفرنسية تحدّث تولستوي أيضا عن هذه الخفّة في المضمون، ثمّة مشكلة في الثقافة الفرنسية تفرض على المخالف حالة الاستثناء، بعضهم لا يعبّر عن اختلافه عن طريق تحدّي البيئة والمؤانسة مع الغرائبي، لا يحتاج الأمر إلاّ إلى تجاوز هذا التقليد الفرنسي لكي تكون مارقا أو غرائبيا: ديريدا، فوكو، إدغار موران، ريجيس دوبريه…حاولوا أن يخففوا من الاستهتار الذي أرساه التقليد الفرنسي، ونحن ورثنا هذا التقليد، قدرنا أنّنا كنّا أوفياء لهذا التقليد، لأن الإنجليز والألمان لم يمرّوا من هنا.
حاول باحث من خريجي الاستشراق الروسي أن يقدم قراءة في أعمالي، ولا أخفي أنّني لم أكن أنتظر منه شيئا ملفتا مع أنّه أخبرني بأهمية تحليل النّصوص، والحقيقة هي أنّه فاجأني ومنحني فكرة كاملة عن أهمية تحليل النّص في الاستشراق الروسي، جعلني أعيد اكتشاف نصوص أنتجتها دون أن أسيطر على سائر منافذ المعنى، فتحليل النصوص حين يكون بهذه القوة يمكن أن تُظهر ما يخفيه الكاتب ويمكن أن تحرّك النصوص وتلتقط المعنى. باحث كبير في إحدى المراكز الإستشراقية الروسية – ذات المختبر الذي اشتغل فيه فاسيليف – كان يحدّثني ذات يوم بامتعاض عن الاختزالية التي يركن إليها الباحث الفرنسي في رصد وتحليل ظاهرة التّطرّف الديني، يحكي عن لقاء مع بعض الإسلامولوجيين من أمثال أوليفي روا، كيف نفسّر الإرهاب انطلاقا من الوضعية التي يعيش فيها المهاجرون، تفسير التطرف انطلاقا من الأوضاع الإجتماعية.
كانت النصوص خلال السنوات الأخيرة ضحية لمقاربات غير وافية للخطاب بل ضحية للسوسيولوجيا “السائلة”، لقد هيمنت المقاربة الاجتماعية على حساب تحليل النّصوص، وفي ظنّي أنّ الأمر يتطلّب توازنا بل استيعابا لجدلية الواقع والنسق الدلالي الذي ينتجه أو يعكسه أو يتفاعل معه، هذا يفرض الشكل الأكثر حيوية: التأويل الأنثربولوجي للدلالة والرمز والخطاب، أي تأويل أساطير التّطرّفات للقبض على النّسق.
ما هي حدود الواقع وما هي حدود الخطاب، وسنجد أنفسنا هنا أمام حقيقة لطالما تجاهلها الدارسون، وهي أنّ افتعال هذه الثنائية نابع من نظرة تقليدية للواقع وللخطاب معا، والواجب هو أن ندرك بأنّ الخطاب هو جزء من الواقع، ما دام الواقع يساهم في إنتاج الخطاب الذي سيتولّى إعادة إنتاج الواقع نفسه، لندرس الخطاب إذن كواقع وكامتداد له.
يعكس المتطرف امتعاضا من الواقع، ينتج خطابه ويصله بالواقع، فالواقع المأزوم يمرّ من خلال خطاب متطرّف مأزوم والخطاب التطرفي المأزوم يبحث عن واقع لتصريف الاحتقان، يتكامل الواقع مع الخطاب أو بالأحرى يشكلان امتدادا لبعضهما البعض، وفي صلب هذا الجدل العميق وجب أن تنهض مقارباتنا للتّطرّفات.
التّطرف إذن كنسق دلالي أيضا،، لكن بالفعل سنواجه هنا مشكلة أكبر من مجرد البحث في جدل الفهم والتطرف، أعني وجب تحليل شيء آخر يتعلّق بمقاومة الواقع لمنطق المقاربة، أي كيف تقاوم التّطرّفات المقاربات وتحمي نسقها الدّلالي من خلال ما سنتحدّث عنه فيما يلي حول إلتفاف التّطرّفات على المفاهيم وحماية نفسها بأساليب المُغالطة وهو ما يهدد إمكانية العلم وساهم في الفوضى ويقوّض النّقاش العمومي نفسه من خلال ما يمكن التعبير عنه استرسالا مع باومان: الفضاء العمومي السّائل..




