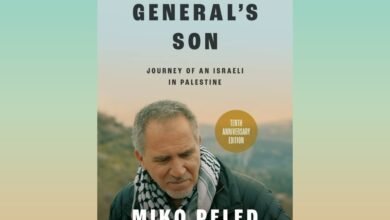مع أنّ هناك محاولات جادّة لإقرار أهمية تعقيد الفكر كتعبير عن التعقيد الذي يعكسه الواقع والأبعاد المتعددة للظاهرات ونشوء كرسي للفكر التعقيدي (Essec business schooL/la Chaire Edgar Morin de la complexité) إلاّ أنّ هناك سوء فهم لا زال يخيّم على طريقة فهم معنى التعقيد.
وقد يكون من المتيسّر لو تناولنا مفهوم التعقيد من خلال منظور “الإستيعابية” التي نقصد بها إحتواء حركة البندول لكل المساحة الترددية بين الأقصيين، فالتعقيد بهذا المعنى لن يكون هو المقابل للبساطة بل هو مستوعب للبساطة ومقاصدها لكنه التعقيد وحده يمكننا من اجتياز اختبار الظاهرات المجزوءة لأنّ الجامعية هنا تتيح لنا إمكانية العبور، كيف نحقق القفزة العبر-مناهجية من الوعي بالظاهرة إلى الوعي بالوجود إن كنا سنبقي على مجال الاشتغال منفصلا، مجزوء، متشظّيا.
إنّ “العبر-مناهجيين”، وأنا منهم – لن يرضوا بهذا التّشظّي للجسد العلمي، بل إنّ لحظة العبور تقتضي جمع شتات أحياز الاشتغال لصالح هذه الأنتربولوجيا التي تسلمنا طوعا للمنعطف الأنطولوجي حيث إنّ مقتضى وحدة المعرفة والوجود يفرض أن يكون أي تشظّي في المعرفة هو تعبير آخر عن تشظّي الوجود، الأمر الذي قد نتحمّله في سياق الأجرأة النظرية لكنه لن يساهم في الفذلكة الضرورية التي تضعنا أمام مسؤوليتنا الأنطولوجية بعد الانتهاء من هذا المخاض السكولاستيكي.
تظهر عملية التعقيد المنهجي للمعرفة بشكل أكثر عند إدغار موران، ليس من حيث هو بدع في هذه الدعوة بل من حيث أمكنه أن ينشئ حولها خطابا جادّا يستحق أن يوصف بميتا-خطاب “عبر-مناهجي” لفكرة التعقيد وتعقيد الفكر، وهو هنا لا يعني أن نعقّد الفكر بالمعنى الذي لا تعكسه عبارة تعقيد الشائعة بل بالمعنى الذي يفيد التركيب والجمع أو بتعبير أدقّ معنى النسيج، أي نسج المعارف والعلوم وهو ما أسميه أيضا بالاستيعابية التي تنتهي بالعبر-سكولاستيكية، الرحيق المختوم لمجمل العلوم والمناهج.
إن فكرة النسيج هي نفسها العبارة التي سيستعملها إدغار موران لتقريب مفهوم الـ (complexus) أو المجمع حيث عبّر عن همّ دائم لإعادة بناء النسيج المشترك، كما عبّر عن رغبته في إيجاد الأدوات المفهومية لربطها، إنها مشكلة تقسيم المعرفة.
تدخل هذه الرؤية في صميم الإستيعابية وهي مضطرة أن تقف موقفا مختلفا من الظواهر خارج منطق التجزيئ، وتأتي هنا أيضا العلاقة بين الكلّ والجزء التي يسوس من خلالها التعقيد موقفه من المعرفة، إنّ الرؤية التي نتشارك فيها هنا هو اعتقادي الدّائم والقائم على صيرورة الأشياء حين تصبح متّحدة في نظام بنيوي، فشخصية الكلّ تمنح بعضا من الخصوصية لا يمكن أن توجد في الأجزاء في حالة إنفصال، ولا شكّ أنّ إغفالنا لهذه الحقيقة هو ما يجعلنا أبعد عن استيعاب ما أسمّيه بمكر البنية في معاكسة مكشوفة لمكر التاريخ الهيغلي.
إن موران لا يقول هنا شيئا مخالفا للعلم ولكنه يحاول إيجاد وسائل للربط، فالنظام يحتوي على أجزاء وعناصر فيزيائية وكيميائية لكنه أيضا يحتوي على خصائص لا تملكها تلك العناصر والأجزاء، بل قد يمنع هذا النظام الخصائص التي تحدد العناصر المكونة للنظام نفسه، فالكل هو أكثر وأقل من مجموع أجزائه، ففكر التعقيد يجعلنا في مواجهة التناقض الذي يتعين القبول به كما يجب مخالفة الأسلوب الكلاسيكي في العمل وذلك بعد إظهار استراتيجياتنا التي من الممكن أن تتغير باستمرار كلما وقفنا على معطيات جديدة.
ولا شكّ أن إدغار موران ليس كما قلنا بدعا في هذا الميل، وحسنا فعل ناتانييل لورونت حين تتبع نماذج التفكير المعقّد عند عدد من المفكرين، ففي اعتقاده – وهذا واضح – أن ادغار ليس الوحيد في مجال التفكير في التعقيد بوضوح، بل يشير إلى أكثر من مثال بالإضافة إلى غاستون باشلار ولوكاس، هذا الأخير الذي يؤكد على إعتبار المجمع عنصرا أساسيا ومنه وجب المرور إلى عناصره المكونة.
وتستند الآنارشية على القناعة نفسها: تعدد المقاربات، الافتراض النقيض حتى مع استقرار العمل بموجب الافتراض القديم، يقف “ضدّ المنهج” هنا صريحا ضدّ الروح التي تتضمنها حالقة الأوكامي، فحسب بول فيرابند يتحقق كل إنتصار علمي بفضل إستعمال أسلحة متنوعة في شكل أدوات وبراهين ومفاهيم وفرضيات، وهذه الأسلحة تتغير بتغير تطور المعرفة.
يجد فكر التعقيد نفسه مضطرا لتقويض البدايات، كما يذكرنا إدغار موران نفسه في المقولة الأثيرة لنيتشه حول أزمة الأسس، وهنا لم يعد بالإمكان الخضوع إلى التصنيف الاختزالي لمفهوم البرهان نفسه، هذا الأخير ليس نتاج عهد أو حقبة ما بل كان البرهان موجودا في كل العصور، فعملية الإستدلال حسب فيرآبند لعبت دورا أساسيا في كل أشكال التبادل الثقافي، ولم تكن من ابتكار العقلانيين الغربيين، وقد يكون لخاصية تعقيد الواقع وتعدد أبعاده إلى التساؤل الذي أثره فيرآبند فيما لو كان ضدّ-الاستقراء لا يقلّ أهمية عن الإستقراء، وهل ثمة سياقات وشروط تجعل من الأولى خيار مهمّا؟