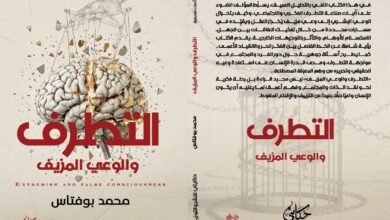كنت في زيارة إلى مدينة جيسن في ألمانيا، فطلبوا مني خطبة الجمعة، ولأنّ موسم خطبة الجمعة هو للشاخرين، والشاردين، والنُّعّاس الغافلين، بدأت الخطبة، كما كانت في أيام كافور الإخشيدي! بعبارات العصر العباسي نفسها.
ثم وقفت قليلاً، وتابعت، فقلت: ما الذي أتى بكم إلى ديار الكفر أيّها المسلمون؟ أليست ألمانيا تعلّم جاهلكم، وتطعم جائعكم، وتؤوي هاربكم؟ هنا دَبّ فيهم الصحو، وتفتّحت العيون على شكل دائرة، مثل عيون السمك، فهي لا ترف!! تابعت؛ فأين الإسلام، أهو هنا في هذه البلاد، أم في بلادكم التي فررتم منها، فلا يشتهي أحد منكم العودة إليها، بعد أن مَنّ الله عليه بالخروج منها إلى بلاد تفيض لبناً، وعسلاً، وعدلاً، وأمناً!! احمرّت الأحداق، واشتدّ النقاش، وبحّت الأصوات، بعد الصلاة، لمدة ثلاث ساعات، وكنت أقول لهم: أخرجوا ما في بطونكم؛ فليس من مخابرات عربية، هنا، تلقي القبض عليكم، وترفعكم على «الفلق»، أو مخبرين سريين يوشون بكم إلى الزبانية والجلاد!.
إن مفاهيم من هذا النوع انقلابية وثورية، وهي تدخلني إلى تغيير مفاهيم كثيرة من هذا النوع، سوف نتناولها مرة بعد أخرى، في محاولة تأسيس فكر إسلامي عقلاني تنويري، مثل مفهوم الردّة الأموي، والعلم الشرعي، والتوحيد السياسي، وحرمة الفن، وإشكالات الحديث، ودونية المرأة، وكفر الفلسفة الغربية، وانقطاعنا عن التاريخ والعصر. ومن هذه المفاهيم التأسيسية مفهوم العلم، فما هو العلم؟
يظنّ بعضهم أنّ العلم هو العلم (الشرعي)، ولا علاقة له بعلوم الفضاء، والفيزياء الذرية، والأنتربولوجيا. ولمواجهة العصر، فإن كتباً مثل عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وفقه الحصكفي، والإسفراييني، والأم للشافعي، وفتاوى ابن تيمية، كافية لاستيعاب صدمة المعاصرة.
وهذا جهل بالعلم، والعلم الشرعي، والتاريخ معاً. أما (سيد قطب) في كتابه (معالم في الطريق) فاعتبر أنه لا توجد حضارة خارج الإسلام، وأنه لا حرج بالانفتاح على العلوم التطبيقية مثل الفيزياء ولكن بدون تفسيراتها الفلسفية.
وهذا يقودنا إلى ثلاثة أخطاء: فلا يوجد شيء مجرد اسمه الإسلام في التاريخ بل هناك ممارسات لبشر حاولوا تمثل الإسلام والإشعاع به فاقتربوا وابتعدوا، وهو خطأ في فهم الحضارة.
فالحضارة كما شرحها المؤرخ الأميركي (ويل ديورانت) في كتابه (دروس من التاريخ) أنها «نظام اجتماعي يقوم بنشر الإبداع الثقافي» ولذا فهي نسيج «متشابك ومعقد وغير ثابت من العلاقات الإنسانية». وهو يفيد وجود حضارة إسلامية وغير إسلامية كما أحصاها (توينبي) فأوصل الرقم إلى 32 حضارة مرت على وجه الأرض.
توالدت من بعضها ومات معظمها، وهو يعترف للمسلمين بحضارة في الوقت الذي ينكر قطب أي حضارة له. والحضارة كما يقول ديورانت «نسيج يتسم بالجهد في صنعه والسهولة في تدميره»، والشاهد على ذلك وضع أميركا الحالي فهي بعد أحداث سبتمبر تعرضت لنكسة حضارية إلى درجة أن ديكتاتوريات العالم الثالث تنصحها بالاستفادة من تجربتها في قمع الشعوب، وأميركا بنيت على الحريات وليس المخابرات.
والخطأ الثالث القاتل الذي وقع فيه قطب هو أنه يريد منا أولاً عدم دراسة العلوم الإنسانية من تاريخ وفلسفة وعلم نفس واجتماع لأنها تخضع في مجموعها إلى روح (جاهلية) بزعمه.
والثاني دراسة العلوم التطبيقية بدون الالتفات إلى تفسيراتها الفلسفية فهو يطالبنا أن ندرس الفيزياء الذرية بدون التأثر بالذيول الفلسفية لمبدأ اللايقين الذي وضعه (فيرنر هايزنبرغ) في ميكانيكا الكم بنهاية الحتمية والموضوعية في العلوم وأن علم الإحصاء يجب أن يفهم على نحو احتمالي، وهي كما نرى أفكار تشكل جذور الانحطاط في العالم الإسلامي. وذهب (عبد الرحمن البدوي) الفيلسوف المصري في آخر كتاب صدر له قبل وفاته وهو يضع خلاصة أفكاره أن العالم العربي نهض من خلال اتصاله بالفكر اليوناني مع حركة الترجمة في العصر العباسي فانطلق العقل.
والذي أكبه على وجهه كان الانعزال عن تطور الفكر العالمي ورسوخ الاتجاه الحنبلي النقلي وقتل الاتجاه العقلي. وحسب المفكر (أحمد أمين) في كتابه (ضحى الإسلام) فإن احدى الكوارث العارمة في التاريخ الإسلامي كانت في تسلط تيار (أهل السنة والجماعة) وقتل حركة (المعتزلة).
وهو يقول أن التيارين يشبهان من وجه حزبين (الأحرار والمحافظين) وأنه كان بالإمكان أن يتعايشا ويعدل أحدهما الآخر، ولو حصل هذا لتدفق التاريخ الإسلامي في مجرى مختلف، ولربما ولدت الثورة الصناعية عندنا قبل ألف سنة. وهو الرأي الذي ذهب إليه صاحب كتاب (العالم فكرة ومادة).ولكنه انحط وكتب سفر الحضارة معكوساً من اليسار إلى اليمين.
أما (أبو حامد الغزالي) فقد ذهب في كتابه (المستصفى في أصول الفقه) إلى تقسيم خاص به سماه (مراتب الوجود) واعتبر أن انتقال الحقيقة الموضوعية الخارجية إلى تصور ذهني هو العلم، ولكنه إدعاء يحتاج إلى دليل ولم يختلف الناس ويتقاتلوا مثل اختلافهم حول تمثيل الحقيقة؟ بيد من هي؟ ومن يملكها؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. واليوم يقول الشيوعيون أن الماركسية حقيقة كونية مثل الشمس والقمر ولكن التطبيق الستاليني كان خلف كسوف شمس الشيوعية.
وذهب (التكريتي) في كتابه (الهندسة النفسية) وهو يشرح النظرية الجديدة حول البرمجة اللغوية العصبية (NLP) الى ان الحقيقة مشوهة ومشوشة للغاية، بدءاً من التقاطها بالحواس مرورا باستيعابها في الدماغ وانتهاء بإفرازها نطقاً باللغة، فليست الحواس تلك المآخذ الموثوقة بها ولو أمسكنا بقضيب يمر فيه تيار ماء بارد لشعرنا بالبرودة والعكس بالحرارة ولكن لو أمررنا تيارين بنفس الوقت من الماء الحار والبارد لصعقنا من الإحساس بالماء الساخن الحارق وهو نوع من خداع الحواس.
واللغة فيها ثغرات مخيفة أثناء التعبير ومحشوة بالمبالغة والتشويه وعدم الدقة. ولكن لا مفر من اعتمادها للتواصل الإنساني، وذهب (محمد عنبر) في كتابه (جدلية الحرف) أن كل الحقيقة مختبئة في تضاعيف الحرف، والكلمة بذاتها تعطيك الحقيقة بمجرد نطقها، مثل قرّ ورقّ فالأول عكس الثاني، ولو اكتشفنا اللغة الأساسية التي نطق بها البشر لوضعنا أيدينا على الحقيقة النهائية.
وهذا جهل بالتاريخ والانثروبولوجيا واللغة معا، فلا الكلمة تحمل الحقيقة، ولا يوجد لغة أصلية موحدة نطق بها البشر. ويعرف علماء الألسنيات اليوم أن الكلمات لا تحمل المعنى بل نحن الذين نشحنها بالمعنى، والمجتمع هو الذي يمنحنا اللغة كما يمنحنا الجينات، وانتبه (ابن خلدون) إلى خديعة الألفاظ فأوصانا بعدم الوقوع في شباكها وأن نطلق الألفاظ وننطلق بالفكر إلى سماء المعاني لنقنص الحقيقة ثم نغلفها بالثوب المناسب من الألفاظ، وعندما أردت تصليح سيارتي لفت نظري استخدام العمال الأتراك كلمات اخترعوها مثل (الصوفة) و(الدودة) و(السِلْف) عن قطع بعينها في الموتور أو (القماشات) في الفرامل وقد تعني شيئا للعامل التركي ولكنها لو ترجمت إلى الألمانية والإيطالية فلا تعني أي شيء.
وذهب العالم (سومرست موم) إلى أن العلم كائن متقلب فهو ينفي اليوم ما أثبته البارحة، كما أنه يثبت اليوم ما نفاه أمس وسيفعل نفس الشيء في المستقبل، ولذا فعباده في حالة ترقب وحذر، وهو كلام يمثل نصف الحقيقة من ثلاث زوايا، فهو (1) ليس كذلك بل ينمو بآلية خاصة به من التراكم والحذف وهكذا ففيزياء نيوتن يمكن أن نستخدمها في إرسال الباثفايندر إلى المريخ ولكن نسبية آينشتاين أعطتنا دقة أفضل فعرفنا حضيض عطارد في الوقت الذي عجزت عنه فيزياء نيوتن. و(2) الثاني أن حقيقة الأشياء تزداد صقلاً ومنها حركة دوران الأرض حول الشمس فنحن عرفنا أنها تدور حول الشمس ولكننا عرفنا ثلاثة أمور إضافية: أن الدوران أهليلجي وأن السرعة تزداد مع الاقتراب من الشمس وتبطؤ بالابتعاد عنها. وثالثا أن الدوران في حالة اهتزاز مثل حركة الرصاصة حينما تخرج من سبطانة المسدس فهي مستقيمة ودورانية. مستقيمة على الخط ودورانية حول امتداده، و(3) ثالثاً أن القوانين غير متقلبة بل تصورنا حولها يزداد مضاء وحدة وصياغة قوانين أكثر دقة وتطبيقا.
أين الحقيقة إذا وأين العلم؟
يمكن بلّورة الموضوع على الشكل التالي:
(1) أولاُ أن (العلم) ليس العلم (الشرعي) وإن كان الآخر يدخل تحت مظلته ولكن ضمن سياقه الموضوعي وإلا تحول إلى قيمة تاريخية يستفيد منها الدارس في رؤية حركة تطور التاريخ، مثل جراح الأوعية الذي يعرف أن أمهات الدم الخطيرة كانت تعالج أيام الزهراوي بالربط بخيطان الحرير، وكانت هي المتوفرة وتعتبر فتح الفتوح. وهي في أيامنا تثير فزع الجراحين وتنتهي ببتر الأطراف أو الموت. ومعنى هذا أن تفسير ابن كثير في يومه كان عملاً رائدا مميزا، ولو بعث (ابن كثير) اليوم لتبرأ مما كتب وبدأ بكتابة تفسير مختلف قد لا يسميه تفسيرا، لأن كل كلمة (علم التفسير) أمر اصطلاحي جاء تحت حزمة من العلوم نمت يومها حسب عبقرية من فتح الطريق إليها تحت أسماء شتى مثل (مصطلح علم الحديث) و(القراءات) و(أسباب النزول) و(أصول الفقه) وما شابه. وهي أمور لم تكن معروفة في جيل الصحابة الأول.
وعندما تولد العبقرية عندنا فسوف نحتفظ بتفسير ابن كثير كقيمة تاريخية نفهم بها طبيعة العصر الذي كان يعيش فيه ابن كثير، ونبدأ في تطوير علوم جديدة بأسماء جديدة، مثل (الفهم البنيوي للقرآن) و(الدراسات التاريخية القرآنية المقارنة) ووضع تفسير للقرآن لا يسمى تفسيرا. فهذه قاعدة مهمة في التأسيس العقلاني للفكر الإسلامي الجديد.
(2) ثانياً يجب أن نستوعب أن العلم حيادي فليس هناك أسطورة (أسلمة المعرفة) لنخرج من تحت القبعات السوداء أرانب بيضاء كما يفعل سحرة السيرك، فليس هناك علم بوذي وآخر بروتستانتي بل هو كيان يتمتع بالحيادية «كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا».
(3) الأمر الثالث أن العلم ينمو في حركة دينامية وأنه يكبر بالحذف والإضافة ولا يعرف التوقف والخوف أو التعب والاستقالة.
(4) والأمر الرابع أن الوجود مكون من خمس حقائق هي (المادة) و(الطاقة) و(الزمان) و(المكان) و(القوانين) وأن سنن الكون لها ست صفات فتمتاز: (بالنوعية) و(الشمولية) و(الثبات) و(التراكب) و(التسخير) و(الاحتمالية) وهكذا فقانون الجاذبية موجود على ظهر الأرض والمريخ.
وقوانين المادة غير قوانين الحياة; فالذرة لا تولد ذرة والقطة يخرج من رحمها قطط. وقانون انطلاق الأشياء هو في زمن الروم قبل ألفي سنة بإطلاق السهم مثلما هو في إطلاق ناسا للصواريخ لاختراق نطاق الجاذبية الأرضية. وتعمل فينا في الوقت الواحد مجموعة مترابطة متراكبة من قوانين الفيزيولوجيا وتيارات العواطف ويمكن قياس حرارة الجسم ولكن لا يوجد (جهاز) نقيس به حدة الغضب، والقانون لا ينظر إلى الهوية العقائدية وبذلك ارتفع الياباني وهبط البنغالي بسبب الاستفادة من سنن الله في الكون أو الاعتماد على الخرافة.
والقانون له طبيعته الخاصة الاحتمالية فمن يولد في ألمانيا يجب ان يكون متعلما غنيا ومن يولد في اليمن قد يقتل السياسي بدعوى أنه علماني أو أن الحوثي يملك الحقيقة النهائية؟ ولكن لا يعني أن كل واحد يولد في ألمانيا سيكون غنيا متعلما بل هي حظوظ دنيوية على الغالب، وكما يقول (مالك بن نبي) أن حظوظ الإنسان في الدنيا مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه.